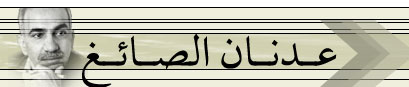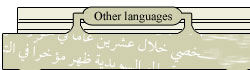|
تأبط منفى وثقل الأيام العائدة
إحالة المتحدث إلى منطقة الموروث
عيسى حسن الياسري شاعر مقيم في كندا
في ديوانه الأخير.. "تأبط منفى" يحيلنا الشاعر "عدنان الصائغ" وبطريقة استكشافية.. لأكثر مناطق الموروثة الإبداعي غوصا في تجربة الإنسان.. وهو يشتبك مع إشكالية أن يوجد أو لا يوجد..
و"تأبط منفى" هو الأسم الاستعاري للشاعر ذاته.. بعد أن تعرض إلى سلسلة من عمليات التشويه التي ابتدأها وهو ما زال صبياً يتجول فوق "جسر الكوفة" ويصغي إلى أغاني الصيادين في النهر المسيّج بغابات النخل والبرتقال.. أو يسرح النظر في قطعان "الدواب" التي تستحم جذلى فيه.. أو تستريح تحت ظلال "جزيرته" الصغيرة.. هذا الحلم الصغير الذي لا يحسد عليه الإنسان.. أصبح كثيراً علينا نحن الأطفال المفتونين بأصغر حلم يقظة.. والمأخوذين بالدهشة أمام حتى مشهد غروبه أو إشراقة شمس أو قمر أو نجمة.
إذن.. فهناك ميلاد جديد.. لزمن جديد.. زمن كالح.. ملوث بالدخان والغبار والأتربة والبشاعة.. وليس هنالك من شيء يخشاه سوى تلك العيون التي تمتلئ ببريق أحلام غامضة.. ورؤى مستقبلية مقلقة، ويبدأ ذلك الزمن بازاحة ذكية لهذه الأحلام.. وإلى أن تبدأ البحث عن أرض جديدة تصلح لأن تكون حاضنة ملائمة لنموها.. والسماح لأجنتها أن تجد الطريق إلى الشمس والهواء.. والدفء.. ولكن هل يمكن لهذا الأمر أن يكون ممكناً.. وهل يتسنى للقدمين اللتين بدأتا ارتحالهما باتجاه.. المنفى.. أن تجد الأرض الصالحة والمبهجة حتى يقفا عليها.. لتتمكنا من صياغة أحلامهما بطريقة جديدة.
ومن خلال العودة إلى "عنوان الديوان" وتفكيك إحالته من خلال البنية اللغوية.. والبنية الزمانية.. نصل إلى شطب كامل ونهائي لكل إجراء هذه المعادلة.. إن عدنان الصائغ هنا لا يترك لنا من اسمه سوى مجموعة من الحروف التي لا يعنينا أمرها بشيء.. إنه الالقاء الظاهر لوجود ثابت ومستقر ومؤكد. ولكن هذا لا يعفي الشاعر.. وهو يتأبط منفاه.. ولا يجد ما يسند جسده وروحه.. وهو ينوء بهذا الحمل الثقيل الذي يتأبطه.. وهو.. المنفى. نقول.. هذا لا يعفي الشاعر أن يبحث عن ملجأ حتى وان كان هذا الملجأ واقعاً خارج شرط الزمان والمكان الذي يفرض حضوره على وعيه.. وحركته وقصيدته.. وهو واقع ذو طرفين.. طرف منه يسحبه نحو طفولته الأولى "الماضي"، والأخر يشده إلى صخرة المنفى.. الحاضر.. وبما أن العالمين لا يمدان له حتى قشة إنقاذ صغيرة.. لذا فلن يتبقى أمامه سوى أن يلقي بأحماله الثقيلة على كتفي زمن آل إلى "العدم" عادة.. ولكنه وكمنجز حياتي إبداعي ظل مصاحباً ومرافقاً لكل الأزمنة ليقدم نجدتها إلى من يطلقون استغاثاتهم باتجاهه.. لذا لم يجد الشاعر أمامه سوى ذلك الشاعر الذي ألصق به لقب "تأبط شرا".
وهذا اللقب يمكن أن يحيل وعينا، ومن خلال البنية اللغوية لهذه الجملة – إلى أن نعطي تفسيرين مغايرين لهذا البناء اللغوي التراثي.. الأول.. يجعلنا نقف أمام شاعر لا يقدم في شعره أو في سلوكه الحياتي اليومي سوى عنصر الشر والأذى.. أما الثاني فيحيل وعينا إلى أن نعطي تفسيراً مغايراً.. وهو الأكثر صواباً.. فنحن لا نقف أمام بناء لغوي مجرد من شرطيه الحياتي والنفسي.. بقدر ما نقف أمام تكوين إنساني يضعه قدره في قبضة تميزه عن الفصيلة التي ينتمي إليها.. والخارج على قوانين الفصيلة.. لابد وأن يتلقى ما لم يحدث لأي من عناصر تلك.. الفصيلة.. إنه اختلف في رؤيته لما يراه الآخرون.. وبما أن رؤياه هي رؤيا فاضلة.. فلا يمكن أن تحمله على أن "يتأبط شروره" ليصيب بها الآخرين.. وهكذا فان الشرور التي تأبطها.. شاعرنا القديم.. هي الشرور التي لا تلحق الأذى إلا به وحده.. وهذه هي أزمة الشاعر منذ أقدم عصوره.. ولا تخلو سيرة واحدة من سير هؤلاء الشعراء من كونها معمدة بالألم والسهر والدموع.
إن استلهام التراث ليس بالأمر الهين.. فالتراث منجز معقد وصعب ولا يمكن أن ينفتح أمام أول يد تطرق على بابه.. أنه كشف إبداعي ورؤيوي مصاغ وفق أبنية فنية تتضافر على تأسيسها رؤى فلسفية ووجدودية قد لا تطرأ على بال أحد من أولئك المنبهرين بالمنجز المتحدث. وعلى الرغم من أن هذه الرؤى.. وفي الجانب الأعم والأشمل منها رؤى فطرية غير خاضعة للدرس العلمي.. إلا أنها نتاج تجربة إنسانية تعلو بقيمتها على كل التجارب المختبرية.
ومن هذا التحليل.. الذي قادنا عمق "العنوان" إلى الاسهاب في تفاصيله ندرك أن الشاعر.. عدنان الصائغ.. يمزج مزجاً إبداعياً وفنياً رائعاً بين "المنفى" وبين "الشر" لأن كلاً منهما يمثل شراً بحد ذاته. فاذا كانت القصيدة التي تأبط شرها الشاعر القديم قد جعلته يتأبط شرور دنياه.. وهكذا نراه حيثما اتجه يقابل أمراً جللاً.. أو مصيبة فادحة.. وكأن قصيدته قد تحولت إلى جمرة يقبض عليها.. ولا فكاك له منها وكذلك هو ينفي الشاعر الذي تحول إلى "شر" بحد ذاته.. إنه منفى أنيق وجميل.. ولا يمكن أن يرى المرء تفاصيله حتى في الأحلام.. ولكنه وأمام وقوفه أمام وعي الشاعر.. ومخيلته المبدعة.. يتحول إلى متاهة كل باب منها يؤدي إلى باب آخر.. وكل نفق يوصل إلى نفق جديد.. وبعد رحلة الشاعر عبر هذه الأبواب التي لا حصر لها.. والأنفاق التي تبدأ ولا تنتهي.. وبعد أن ينزف الكثير من الدم والعرق والدموع.. نراه وقد أوشك أن يخرج إلى إحدى فسحات حلمه.. ولكن صدمته تكون كبيرة ومؤسية.. حين يجد أنه كان.. ورغم هذا السفر "العوليسيي" عبر تلك الأنفاق والأبواب والدهاليز.. لم يتحرك خطوة واحدة.. أو أنه كان يدور حول ذاته فأي شر هو هذا المنفى الذي حكمت عليه الحياة التي أعطيت له.. ولم يطلبها.. أن يتأبطه.. كما تأبط جده الشاعر الأول "الشر" الذي ظل يلاحقه حيثما حل وأينما ارتحل:
"أطرق باباً
افتحه
لا أبصر إلا نفسي باباً
أفتحه
أدخل
لا شيء سوى باب آخر
يا ربي
كم باباً يفصلني عني..؟"
هنا يكون.. "عوليس" هو الأسعد حظاً من شاعرنا.. لأنه ورغم رحلته الأسطورية، والأهوال التي تعرض لها.. استطاع أن يصل.. وحين وصل.. لم يصدم بخيانة بنيلوب بل وجد فيها ذلك الحلم النقي الذي شكله في وعيه.. وظل ينتظره كل هذا الوقت.
في حين أن شاعرنا المبدع "عدنان الصائغ" طوى صفحات أحلامه.. وألقى بها إلى أقرب تلة من تلال جليد القلب.. فأنّى لمن لا يستطيع الوصول إلى نفسه أن ينسج رؤى وأحلاماً في عالم يخجل عالم "عوليس" بكل اسطوريته.. وفنطازيته أن يفتح عينيه في حضرته.
لقد وظف الشاعر "عدنان الصائغ" عناصر تجربته الأولى – توظيفاً يزاوج بين شرطي كل منهما فنيا وابداعياً.. مرتكزاً في ذلك على وعي تحليلي اتخذ أهبته لمواجهة عناصر منفاه الآتي.. من خلال عناصر نفيه الروحي والوجودي وهو يمارس الإقامة فوق أرضه الأولى.. وهكذا اتحدت في تجربته مكونات "نهر الكوفة" وجسرها الذي يربط بين غابات نخيلها.. مع جسور "مالمو" وشجرها الذي قد يمد الشاعر بظله.. ولكن ليس بمقدوره أن يقدم له حبة تمر واحدة شبيهة بتلك التي تنوء بحملها عذوق نخيل الكوفة.. وهو ينتقل من حانة دافئة من حانات مدينة بغداد إلى حانة تقع عند حافة القطب الذي كان يرى صورته مرسومة فوق صفحات.. الأطلسي المدرسي..
وهذا في تقديري هو ما يحتاج إليه شاعر المنفى.. فنحن لا يمكن أن نغفل جمال منافينا ولكننا في الوقت ذاته لا يتسنى لنا أبداً أن نفتح أمامها بوابات القلب على سعتها.. القلب الذي يحتشد بصور عوالمه الأولى المدهشة والتي تتحول فيها كل حجارة. وكل بقعة أرض من "السباخ" وكل مستنقع من مستنقعات المياه الثقيلة التي تحتشد بها شوارع وأزقة "مدينة الثورة" وتترشح جيفها من خلال حجارة بيوتها الآيلة للانهيار وكل قدم حافية لامرأة أو طفل يدب على الأرض يتحول كل هذا إلى كنز مفقود.
"على جسر مالمو
رأيت الفرات يمد يديه
ويأخذني
قلت.. أين؟
ولم أكمل الحلم
حتى رأيت جيوش أمية
من كل صوب تطوقني.."
- قصيدة يوليسيس ص 99-
وبالرغم من أنه يودع كل شيء.. وهو واقع تحت ضغط ثقل منفاه الذي يتأبطه.. فهو الوداع الذي يشعرنا بأنه يزداد التصاقا بكل الأشياء التي يحبها وخلفها وراءه!
"وداعاً لنافذة في بلاد الخراب
وداعاً لسعف تجرده الطائرات من الخضرة الداكنة
وداعاً لتنور أمي.." -يوليسيس ص 99-
نعم أنه الوداع الذي يعد بعودة "عوليس" وإذا لم تكن هذه العودة هي عودة مادية.. فأنها على الأقل ستكون عودة من خلال أجنحة الحلم الذي لا تقف بوجهه المسافات.. ولا يطالبنا ببطاقة سفر.. أو تـأشيرة دخول إلى الأرض التي نحب.
(*) صحيفة "الزمان" – لندن - 9/11/2001
|