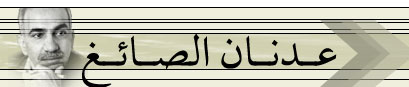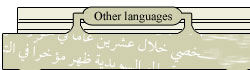|
آليات الانزياح وشعرية الصورة في ديوان " تأبط منفى":
اقتحام المخفي
عبر المنظور الشعري
غالب الشابندر - السويد -
في ديوانه الجديد ـ تأبط منفى ـ يرتكب عدنان الصائغ إثماً لذيذاً بحق الحواس ، يحررها من شغلها اليومي ، يخلصها من سجن الفعل القريب ، بديوانه الجديد يتح صندوق الوعي المُحنّط لِيُغّيبَ في داخله همزة الوصل المتجبرة ، بين ذات مكرورة ـ ولو ظاهراً ـ و موضوع مألوف ... انه يحرج الطبيعة ...يصدمها ... يربكها ... لأنه يبدع عالماً آخر يوازيها ... ينافسها ... وربما يجافيها .
في أعماق الشاعر طاقة مبدعة ، ليس على اكتشاف النظير و المختلف ، بل على ابداع عالم جديد ... ان قدرة الشاعر على التقاط المتشابهات و المختلفات مقدمة لتجاوزها ، فهو لا يقف عند هذه الحدود المحسوبة بالرقم ، هذه العلامات التي تنتهي عند نقطة ، كانت قد ابتدأت منها ، يتخطاها الى عالمه الآخر ، ان الكون كله ، بكل علاقاته المعقدة ، بكل أسراره ، بكل حوادثه السيالة ... هذا الكون العظيم مجرد باعث ...مثير ... انه البداية .
إن أي محاولة شعرية تبدأ من الكون وتنتهي به عبارة عن حركة دائرية ، اجترار كسيح ، يعبر عن ذات مغلولة ، فيما الشعر ملحمة تشتهي التجاوز ، تمارس التخطي الوقح ، تمزق شوق الطبيعة للاستحواذ على الفكر ، ولهذا تخلد القصيدة و لا تخلد النظرية العلمية ، مهما كانت دقيقة ، ومهما تحولت الى نموذج ارشادي ، ومهما كان لها من القدرة على استشراف الغيب .
هذا التصور لا يعني ان هناك قطيعة تامة بين النص الادبي ـ الشعر بالخصوص ـ و الوجود ، وبالتالي ، ان النقد ينبغي ان ينصب على اللغة واللغة وحسب ، ان حذف الكون مراهقة فكرية ، وعمل صبياني .
فمن الإجحاف بالحقيقة أن نحيل الخطاب الادبي الى كتلة لغوية صلدة ، لا توجد في الكون خلاصة أُحادية ، الهيولى الفلسفي مجرد افتراض عقلي .
ان الوجود مشرق ، يدخل كل مسامات الروح الفرحة ، الوجود شعلة تتسع دائرة ضوئها ، باتساع ملكة الحس و الخيال ، الوجود حضور، يتعمق في قاع الفكر ، بقدر ما نفعّل مذخور الذاكرة ، و نُلهب رغبة التشوف الخلاق لمستقبل أفضل ، بل الوجود مرتع مملوء بالدلالة ، حتى مع سورة الحزن المتأصل ، الحزن الذي يترجم الحياة بمنطق اللعنة المفروضة ، حتى مع اليأس ، وقد تحول الى ملاذ الخلاص ، عند السائرين على ألغام النفي الاجتماعي المنافق !
ان البنيوية ذات عين واحدة ، نتاج ازمة وجودية بالصميم ، و ربما تعبر عن هروب جاد من إزدواجية الواقع ، الواقع المقموع من الداخل و المنفلت من الخارج ، الواقع الملغم بالخوف المنظم بدقة و المغلف بحرية موهومة.
ينتمي العمل الشعري الى أُفقين من الأنطولوجيا ، الأفق الأول يستفزه ، يحرك فيه المكمن الثاوي في القاع البعيدة ، يجرح هواجسه المتحفزة ، هذه هي البداية ، لان كل نشأة تنطلق من سابق عليها ، ان الافق الأنطولوجي الأول في عالم المجاهدة الشعرية هو المثير ـ و كم بودي ان استمر في تشريح هذه النقطة و لكن الظروف لا تساعد ـ أما الأفق الثاني فهو المتعالي ، أفق لا ينتهي ، دائم الانفتاح و التوسع و التجدد ، عالم ما وراء المثير ، وهو عالم الشعر ، أو هو الوجود الشعري ، ان استجابة الشاعر للمثير تتجاوز معادلة المثير العادية ، استجابة جوهرها انتقال إلى عالم آخر ، له قوانينه الخاصة ، ومن أبرز ما يتميز به ، انه لا ينغلق ، مفتوح ، ومن هنا أقول : لا توجد قصيدة جادة تحمل مرسوم النهاية ، لأن معنى هذا ، ان الشاعر لم يتجاوز مرحلة الأفق الملامس لحواسه الخارجية ، لم يدخل فضاء حواسه الداخلية ، لا يزال أسير الأفق الأول...
ان انتقال الشاعر بين هذين المستويين من الوجود يحتاج الى تجربة روحية متسامية ، ان الانغماس في العالم المحسوس شرط موضوعي لاستشراف العالم الشعري القابع بعيداً ، من هنا نعرف قيمة التجربة ، فالشعر تجريبي يهذه المقاربة .
الشاعر عدنان الصائغ يجيد هذه النقلة ، يتجاوز البداية بخط متعرج ... متكسر ... متموج ... و النقلة متوترة ، مشدودة الكلمات والافكار والصور و الفواصل و النقاط ، و بهذا يكون قد توفر على سرّين جوهريين من أسرار الشاعرية ، أقصد شاعرية النص ، وهما التجاوز والتوتر.
التجاوز في شعر الصائغ ليس ممارسة لغوية ، وأنما هو رحلة فكرية ، اقتحام للمخفي عبر المنظور:
[ في وطني
يجمعني الخوف ويقسمني :
رجلاً يكتبُ
والآخرَ خلف ستائر نافذتي ،
يرقبني ].
هذه الذات التي يتكلم عليها الصائغ ، هي الذات المتكدسة أو الغاطسة في أكوام الظواهر، التي تملأ مساحة الحواس الخمس ، أن الذات بشكل عام موضوع شاخص ، نقطة في تيار الحياة الجارف ، يمكن أن نشير إليها بالبنان ، لا تظهر عليها علائم الانقسام و الانشطار ، فيما الشاعر يتحدث عن الذات من الداخل ، ان هذه الذات عالم آخر ، فهناك عمليتان متضادتان تعملان داخل هذه الذات ، هناك جمع و قسمة ، هناك تشقيق للذات ، بحيث تخاف من ابداعها المشروع ، تراقب حقها في الكلمة ، تجلد نبضها الحي ، والخوف هو البطل في المشهد كله ، و هذا هو الافق الأنطولوجي ، الذي ينبغي على الشاعر ، ان يجول في رحابه المتموج ، رحابه اللجي ، ولكن اين تكمن البداية ؟!
لا بد من مثير ، و اعتقد أن المثير هو هذا المشهد اليومي في بلاده ، كلمة [قف] التي تلاحقه هنا وهناك ، الشرطي الذي يوزع ابتسامات الوداع الصفراء على ضيفه اليومي المتجدد ، صورة الجنرال التي استهلكت كل ألوان المدينة .
الصائغ شاعر نقلة ، شاعر ترحال ، شاعر يفتش عن المخفي .
[يملوني سطوراً
ويبوبوني فصولاً
ثم يفهرسوني
ويطبعونني كاملاً
ويوزعوني على المكتباتِ
و يشتموني في الجرائدِ
و أنا
لم
افتح
فمي
بعد ]
الشاعر كتلة سلبية خاضعة للطبع المُصَمَّم خارج روحه ، خارج إرادته ، يرشحون قدره قطرةً قطرةً قبل ان يولد ، قبل ان يخلقه الله ،ان عملية تشقيق الإنسان معاينة جوانية لظاهر خادع ، وهذا هو الفارق بين الشاعر العميق و الشاعر الآخر ، ان الشاعر العميق لا ينثني أمام المثير الى الأبد ، يزيح هذا المثير ، كي يرمي بكل ثقله لإنشاء العالم الجديد ، إن الشاعر في هذه الصورة الشعرية ، يتجاوز السؤال المفروض ، يتخطى الأمر الملقى من فوق ، يعبر علامات الاستفهام المرسومة بين عينيه سلفاً ، يستلم كل هذه المقتربات ، يجمعها ، يفاعل بينها ، ثم يتحرك لإبداع عالمه الجديد على أنقاض هذه التراكمات ، وهذا هو المستوى الآخر من الوجود ، انه العالم الشعري .
يتحدث كثير من النقاد عن الشعر بأنه مسيرة شاقة من الجزء الى الكل ، من المرئي الى اللامرئي ، من الملموس الى اللاملموس ،وهذه هي عوالم الشاعر ، و التدقيق في هذا الطرح يشي عن تورط غير مقصود بالفلسفة شئنا أم أبينا ، لأن الطرح يكشف عن عملية تجريد للمثيرات ، تجريد عقلي معرفي ، ومن ثم يتقاطع تماماً مع المثير الأول ـ فيما هناك عودة سنتحدث عنها لاحقاً ـ وقد يتحول الى مفاهيم معرفية قياسية ، ان الخلل في هذه التصورات عن عالم الشاعر يكمن في أكثر من نقطة حساسة ، ذلك ان الشاعر لا يقوم بعملية تجريد للأشياء ، انما ينطلق منها كواقع عياني مجسد ، و لا يلغيها تماماً من مسيرته المضنية ، و انما يرسم طريقاً جديداً للعودة اليها ، ومن ثم إن عالم الشاعر لا ينتظره و انما الشاعر يخلقه ، يبدعه ، ان اللامرئي في تصور هؤلاء النقاد حقيقة سابقة على وجود الشاعر ، و الكل كامن في القدر المشترك بين المفردات الموزعة هنا وهناك ، فيما عالم الشاعر لم يتكون بعد ، ليس غائباً و انما ليس موجوداً ، وهذا من الفوارق الحساسة بين الشعر و الفلسفة بمعناها المدرسي ، ان عوالم الفيلسوف محتجبة تنتظر الاكتشاف ، أما عوالم الشاعر فهي غير موجودة فتنتظر الخلق .
هذا المثير الذي يستفز طاقة الشاعر أو بالأحرى يجرح روحه الملتهبة ليس شيئاً محدداً ، قد يكون ورقة توت متعفنة ، و ربما نهد آسيوي متدفق بحرارة الشوق الى لمسة مراهق مأسور بالجمال ، أو خرقة حيض مرمية على باب مبغى مهجور ، وقد يكون ثورة او منصة إعدام او جبلاُ شاهقاً ، قد ينتمي الى عالم المادة أو عالم الروح ، وعاؤه الواقع الخارجي او قاع الذات الشاعرة ، لأن روح الشاعر ليست مختومة او مرهونة.
أين تكمن ماهية الشعرية ؟ ا
أطرح هذا السؤال رغم أني لا أطيق كلمة [ ماهية ] وأرى فيها عبئاً ثقيلاً على الفكر ، بما فيه الفكر الفلسفي ، ان هذا المصطلح استهلك قسطاً وافراً من حرمة الزمن البشري دونما جدوى ، فأراني مضطراً أن أُغير صيغة السؤال لأقول : أين تكمن شعرية الصورة ؟ وهي في تقديري التعبير المعادل للصورة الشعرية .
لقد كان السائد ، ان النص الشعري يستمد مشروع تسميته من الوزن والإيقاع والقافية والاستعارة والمجاز والتركيب ، كلاً او بعضاً ، ولكن هناك من يرى ، ان الشعرية تكمن في شبكة علاقات نامية متواشجة بين مكونات النص ، بحيث تخلق مناخاً خاصاً ، يتميز بالقدرة على التأثير، الذي من شأنه زلزلة الذات ، و تحريك الساكن ، و خلق حالة وجدانية ساخنة ، و توليد أنماط من الشعور المتأجج داخل الكينونة ،وهذا يقود الى التعامل مع النص الشعري حقيقة تنتمي الى ذاتها و حسب ، انه يؤول الى تاصيل اللغة باعتبارها كائناً مكتفياً بنفسه ، وهناك تصور آخر يتجاوز هذه التخوم و التضاريس ذات البعد اللغوي بالدرجة الأولى ، ويركز على بنيات تجريبية و شعورية ، على الافكار و الرؤى و المشاهد و الصور كمادة انطولوجية ، وبذلك يحرر الشعرية من قيود الصنعة ، و تكاليف التوافق مع لاهوت القاعدة النحوية و اللغوية ، ان هذا التصور يغور في اللحمة الكامنة وراء كل آليات الإنزياح التقليدية ، انه محاولة لإكتشاف ما يخلقه الشاعر ، قفزة عملاقة داخل ذات الشاعر ، وليس مجرد معاينة خارجية ، وفي اعتقادي انه لا يوجد انتاج نظري قاطع في هذه القضية ، وربما يكون للذات دور في تقدير الشعرية الى حد كبير، وقد لا نتقاطع مع الموضوعية الى حد جاف ، إذا قلنا ان الشعرية موضوع تجربة ورؤية شخصية ، بمقدار ما هي موضوع علم مقنن ، الامر الذي يحول دون الشرط الموضوعي ، ولكن هذا لا يمنع من مقاربة أولية هنا وهناك .
ان كل المحاولات المبذولة في هذا الميدان ، لا تنفي ضرورة ما يمكن تسميته بالتوتر ،فكأن هذا العنصر، يشكل نقطة الضبط التي تتجاذب ـ بحدود متفاوتة ـ مع كل عناصر الهويات المقترحة لتصوير منبع الشعرية ، ان آليات الإنزياح المعروفة في الشعر ، تمارس دوراً تخريبياً في نطاق الإدراك العادي ، لأنها تغير من صميم العلاقة بين الأشياء و الظوهر ، تخلق عالماً غير مألوف في معادلة الحس المألوف ، ان الصور الذهنية التقليدية تجد نفسها مطاردة ، تجد موقعها في النص الشعري مرتبكاً ، غريباً ، تفقد شرعيتها ، و هذه هوية متوترة ، تعبر عن كون جديد ... انه الكون الشعري الذي نلح على وجوده . والصور والرؤى المبثوثة في المتن الشعري ، هي في بعض أسبابها ، متولدة من تفاعل هذه الأدوات و الآليات، و حتى إذا كانت من إبداع العقل الصرف ، وهذه الآليات مجرد وسائل توصيل وحوامل ، فانها لا تكون شعرية اذا لم تمزق العادي ، وتشتت المستبد اليومي ، تستدعي حاسة جديدة ، هي عصارة نوافذ النفس الإنسانية على العالم ، ان المتن الشعري في بعده الكوني ورؤاه جوهر جديد في عالم الشعور والإدراك ، يتخطى حدود الالتقاء اليومي بالعالم والناس والذات ، و هذا انجاز يتسم بالتوتر .
شاعرنا يجيد توتير صوره الشعرية ، و من خصائصه الممتازة ،ان حال التوتر في انجازه متأصّل ، فهو يتيح الفرصة للمضي بالعملية الى أقصى ما تطيقه الكلمات :
[أطرق باباً
أفتحه
لا ابصر إلا نفسي باباً
افتحه
ادخل
لا شيء سوى باب آخر
يا ربي
كم باباً يفصلني عني ] .
قطعة من توتر ... توتر حاد ... امضاء للتوتر ذاته كمبدأ سائد ... التوتر هنا ليس حالة مرصودة ... ليس سمة تتبارى اللغة في رسم ملامحها و ظلالها و مستحقاتها ... التوتر جوهر ... و في تصوري ان التوتر يؤدي دوره الخلاق في توليد الشعرية على عدة مسافات منها .
1. المسافة المتوترة بين المثير والاستجابة ، و هذه ا لمسافة تتأسس في لحظة الانبثاق الشعري ، انبثاق القصيدة ، لان الاستجابة تتجاوز مستوى ا لباعث ا لبدائي .
2. المسافة المتوترة بين اللفظ و المعنى ، و تتمثل في آليات الانزياح اللغوية المعروفة من تشبيه و مجاز وكناية واستعارة ... فإن هذه الآليات تحرف الألفاظ عن معانيها المعجمية النصية .
3. المسافة المتوترة بين المفاهيم والأفكار و التصورات والرؤى ، اقصد التضاد داخل بنية الحدث الشعري ، فإن الانسجام ليس انجازاً شعرياً ...
4. المسافة المتوترة بين الشاعر و المستمع ، فإن هناك قراءتين ، قراءة الشاعر التي هي الكتابة أصلاً ، و قراءة الآخر ، المستمع او القارئ ، و في الأخير الناقد .
5. المسافة المتوترة بين الزمن العادي و زمن انبثاق القصيدة ، فالشاعر و هو يتدفق بالمولود الجديد ، يعاني من ضغوطات ماض، يملك سيطرة الروتين المريح ، الذي يحاول جهد امكانه ، احتكار الشاعر و تصفية كل طموحاته باتجاه الابتكار،و الشاعر يقاوم هذه المحاولة القمعية العنيفة ، وكل ذلك يجعله متوتراً ، متشنجاً ، قلقاً ، مما ينعكس على عالمه الجديد .
هناك سلسلة من الإنشطارات النفسية المتصارعة ، تتوالى التصدعات بوتيرة منفعلة و ذات منسوب متكسّر ، صعوداً و هبوطاً داخل الذات بلا نتيجة ، فهناك عاصفة مروعة تعبث في الوجدان و الشعور بل حتى في الجسد ، لقد أحال الكونُ الشاعرَ إلى نفسه لعله يجد فسحة وجودية تمنحه لذة الحضور المشروع ، ولكنه وجد الذات مجموعة مكدسة من الإخفاقات ، وهي حالة لا تطاق ، فكلما يبحث الانسان داخل ذاته يُحال إلى ضباب !
القصيدة الحية تسير في اتجاه المزيد من التصدع ، و هي بذلك ، تقترب من ماهيتها او بالاحرى تقترب من الشعر ، لان الشعر في الملكوت ، والسير إليه معراج صعب ، تنطوي تحت عرشه مصاديق لانهائية من المراتب ، و كل محاولة هي سعي نحو هذا العرش المقدس ، ولكن التماهي مع الشعر مستحيل .
إن المسافة بين الطَرقٍ و الصدود عميقة ، تحفر في الوجدان رسالة النفي ، و تعمق فيه اليأس من كل شيء ، والحضور الشخصي ـ بواسطة الضمير المستتر ـ يُصادِمُ النفي المتكرر ، خاصة وان الميدان هو النفس ، التي تمثل ارقى ممكنات التحقق الفعلي ، و هذا السعي المضني يصطدم بالنتيجة الخاوية ، النتيجة التي لم يكن يتوقعها ، الكون يتوارى امام إحالة ، كان الشاعر فرحاً بها ، و لكن الذي ظهر ، أن الملجأ الجديد عاطل ... معطوب ... فالأزمة شاملة ...
[ العراق الذي يبتعدْ
كلما اتسعتْ في المنافي خطاه
والعراق الذي يتئدْ
كلما انفتحتْ نصف نافذة...
قلت : آهْ
و العراق الذي يرتعدْ
كلما مر ظلٌ
تخيلتُ فوهةً تترصدني ،
أو متاهْ
والعراق الذي نفتقدْ
نصف تاريخه أغانٍ وكحلٌ...
و نصفٌ طغاهْ ] .
هذه الصورة تحمل الكثير من أسرار الشعرية و جمالها و عطائها ، و لكن بودي ان اترسم بعض معالمها على صعيد القافية ، فإن االقافية ليست زخرفة لفظية عابرة في بناء القصيدة ، و لانها خاتمة البيت ، ينبغي ان تتمثل خلاصته الحية ، ومن هنا يمكننا ان نُحدث تغييراً في مقتربات القافية، نتتقل بها من الهوية الصوتية و النغمية ، الى عالم أرحب و أعمق ، أي ان تكون بنية تختزن روح البيت ، النافذة التي نطل من خلالها على بعض أسرار المتن الشعري ، ان تجميد وظيفة القافية في نطاق التزويق الصوتي والموسيقي ، ينحدر بغاية الشعر السامية ، أقصد خلق الجمال و القيم، فينبغي أن لا تُعرَف القافية بحرف أو حرفين ، و انما بكلمة تامة، يتقاطع في داخلها الإيقاع و المعنى على حد سواء . ، لا بد من تعميق فلسفة القافية ، و البداية تغيير بنيتها الذاتية ، فهي ليست حرف الروي او حرفيه ، مهما كان شجياً و منساباً مع الصدى العام ، بل هي كلمة تامة ، تحافظ على موقعها المكاني التقليدي من البيت ، ولكن في التحليل الدقيق تمارس دور التجاذب في المتن الشعري ، تلخص الفورة الشعرية ، القافية لا تأتي زائدة ولا هي تابع من أجل تجويد ما اكتمل ، أو تكراره على نحو الجودة ، ان القافية في مثل هذه الحالات لا تمثل فلسفة بنائية .
هذا ما انجزه الشاعر عدنان الصائغ في هذه المقطوعة الصغيرة الرائعة [ يبتعد ... يتئد ... يرتعد... نفتقد...] ... ا القافية في هذه الصوررة ، تمارس مسؤولية عريضة ، تنعكس على مستوى القصيدة كلها ... القافية/ الكلمة وليست القافية/ الحرف ... القافية التي تملاُ وليست القافية التي تزوق ... وليس من شك ،إ ن القافية بصياغتها البنيوية الممتلئة بالمعنى و الايقاع ، تتحرر من محاولات اغتصاب المكان ، هذه المحاولات التي تجفف منابع الحدث الشعري ، وتكلس طراوته ، و تخمد ناره . ان القافية / الكلمة حاضن أمين لجميع عناصر البيت ، تحميه من الاصطناع ، تزيد من الدلالة ، و تنشط من حركة التوترات داخل الحدث الشعري .
هذه النهايات تتواصل بشكل مباشر و ساخن مع موضوع القصيدة الذي هو العراق ، وهو يختفي من خارطة النظر ، يتوارى شيئاً فشيئاً ، يلفظ انفاس المستقبل ، يوجعه الموت المتدحرج ببطءٍ و قسوة على جسده الندي .
[ قلت : آه .. ]
الشاعر يريد ان يتوحد مع هذا الجسد الممزق ، يريد ان يتشرب آلامه وأحزانه ، ان يكون مثله ، يتماهى مع تاريخه المشطور بين الطرب والطغيان .
[ أنا القيثارة مَنْ يعزفني
أنا الدموع مَن يبكيني
أنا الكلمات مَن ...يرددني
أنا الثورة من يشعلني ] .
العزف والبكاء والترديد والإشتعال قوافي تتكلم قبل ان تترنَّم ...تتعاضد فيما بينها لتزجي شكوى مشروعة ، ولكن من جدوى ، و قمة التوتر في هذا الحضور الغائب ، فأن ضمير المتكلم المتمثل بـ [ أنا ] في عرف اللغة ، يعادل الامتلاء الشخصي ، و هو كناية عن الحضور الواثق من موقعه ودوره ، و لكن لغة الشعر تكسِّر هذا النظام المتزمت ، وتحيله الى ذكرى مرهونة الفاعلية بوقتها وشروطها ، ففي دورة من حرائق التحولات ، ينقلب هذا الحضور الى عطب ، و بالتالي هو حضور مؤجل ، ومن المفارقة المدهشة ، انه ينتظر الفواعل الغائبة ، لتهبه هوية الحضور الحقيقي ، هكذا يَقلبُ الشعر العالم الذي نحن فيه ، يطرح بين أيدينا كوناً جديداً .
هذا الخيط المتوتر بين الحضور و الغياب ، لا يعني انعدام الوعي كلياً، ليس هو غيبوبة ميتافيزيقية مصطنعة . هناك وعي ، وربما وعي حاد ، إلا انه عاجز عن اتخاذ موقف جذري ، فهو وعي حبيس ذاته، والاستغاثة التي يطلقها الشاعر دالة على هذا الوعي العاجز ، أي الذي لا يملك::القدرة على تجاوز مملكته الأولى.
قلت مرة ان الكلمة مخلوق شبقي ، يخزن شهوة نزقة داعرة ، لان هذا المخلوق يعشق التواصل المستمر ، انها تسابق الزمن كي تلتحم بالنظير او ا لمخالف ، لتعبر عن ذاتها المختنقة بغبار القاموس ، تستحم بلهفة الوصال ، تنتقل من موقع الى آخر بحثاً عن حلمها في العطاء ، تحقد على العزلة الكونية ، لعوب هذا المخلوق الى حد اللعنة .
اكتب هذه المقدمة كي أُرسي علاقة مقترحة بين اللفظ والمعنى ، حيث أعتقد ان هذه العلاقة محكومة بالفضاء الذي يمتد بينهما ، هذه الفضاء ُيظهره التاريخ ـ بمفهومه الواسع ـ من العدم الى الوجود ، وهو فضاء موبوء بالعداء ورافل بالولاء لهذا او ذاك أو كليهما ، وبفعل هذه الملابسة الجميلة ، تتبادل الكلمة والمعنى التأثير المستمر ، وكل هذه المقتربات تسمح بإنشاء علاقة جديدة بين اللفظ وا لمعنى ، تتضمن التصور التقليدي الذي يتجسد بالدلالة ، ويتجاوزه الى أفاق أرحب و أخصب ... هذه العلاقة هي الحوار...
ان علاقة الحوار الساخن المتجدد بين الكلمة وا لمعنى حقيقة سارية ، لأن الكلمة معرضة للاغتصاب اليومي ، وسنة اغتصاب الكلمة ، تجد مبرارتها الملحة في الزمن الصاخب ، وفي زمننا لا يثبت شيء ، فان الاحداث تتسارع على شكل قفزات سريعة خاطفة ، كل حدث لا يجد زمنه الخاص ، لأنه سرعان ما يترك مكانه للجديد ، وتؤكد كثير من الدراسات الجادة ، ان الهوية تعاني من خطر الانهيار، بسبب هذه ا لحركة الجامحة ، ومهما يكن من أمر ، تتعرض الكلمة و الحدث الى سلسلة من الصدمات العنيفة في هذا الزمن الملتهب ، وعلى هذا الأساس ، لا يصح الأسلوب المعجمي القاسي في استشراف معنى الكلمة ، ومن الطبيعي أن نتحدث هنا عن الكلمة في سياق النص المتميز ، اي نصوص الكتب المقدسة والملاحم الشهيرة والإنجازات الأدبية المشرقة ...فإن الكلمة في مثل هذه المتون ، لا تنتظر شفقة القاموس ، بل هي متمردة على أوراقه و حروفه و سطوره ، ولكن لا يعني هذا التقاطع التام مع الرسم الأول للكلمة ، انما تُهضم في دائرة مجموعة هائلة من المقتربات والمؤثرات و الفواعل .
تستمد الكلمة دلالتها في الزمن المتفجر من التداعي بقدر ما تستمده من التضاد ، ومن التقابل بقدر الترادف ، من الاحالة على عناصر النص الأُخرى بقدر الإحالة على الوضع الأولي ، ومن ثم لا ننسى هوية الآخر وتجربته ، فهذا الآخر جزء من النص، له قرائنه الخاصة . ومن هنا كانت القراءات المتعددة ، فإن كل قارئ يجسد نصاً ، بل نصوصاً ، ومن هنا ايضاً ، أصبح من معالم الابداع ، القدرة على توليد النصوص الأخرى ، القدرة على تنسيل النص عبر الفهم المتنوع ، ان النص الجيد يطرح على القارئ الواحد أكثر من احتمال ، وأكثر من تصور ، وبهذا الامتياز لا يدخل في ذمة التاريخ .
نعود الى الكلمة في الشعر ، فأن الشاعر الحي يتعامل معها ليست كمجموعة من ا لحروف ذات المعنى المحدد ، بل يقاربها و كأنها كائن مراوغ ، يحب ان يتواصل بكل طاقته مع الآخر، ليفوز بشهوة الحضور والتألق ، كائن يعي حقه من التشبع بلعبة الحياة النزقة والرصينة في آن واحد ، ولذلك ، أعتقد ان هناك حواراً طويلاً بين الشاعر والكلمة ، حوار فيه من المراوغة ، ما يفوق نظيره في اللقاءات الدبلوماسية ، يجري هذا الحوار داخل الشاعر ، في اعماقة البعيدة ، حيث يمارس التأمل دوره في الحكم والفصل ، و يجري هذا الحوار على شكل تجريب صوتي ، مما يفسح ا لمجال للذوق الموسيقي باداء رسالته ، فأن للكلمة بنيتها الدلالية والصوتية معاً ـ وهنك بنيات أخرى ربما اتعرض لها لا حقاَ ـ ، و الايقاع ربيب الالتحام المتلاطم بين عناصر كثيرة ، منها : الصوت والمعنى .
الشاعر المبدع يعتصر الكلمة بعنف وحنان ، كي يستخلص منها روحاً جديدة ، تتوافق مع امكانات العالم المنتظر ، بعنف كي يفجر فيها الممكنات الخفية ، و بحنان كي ينمي هذه الممكنات و يحافظ على اشعاعاتها وطاقتها.
ان الشاعر لا يختار كلمته عفوياُ ولا بتأثير مران تقليدي ، ان تصوير الكلمة الشعرية وكأنها شيء ينزلق بسهولة أو بعفوية ... هذا التصور لا يكشف عن معاناة ، يشي عن ثقافة مريحة ، و غير مدّعية ، ان الكلمة التي يختارها الشاعر ، نابعة من التحام كلي بين الشاعر و موضوعه ، من رؤية ومعاناة ، من تجارب تراكمت ثم انفجرت .
يقول عدنان الصائغ :
[ الحبل الذي مدوهُ حولَ عنِقِه
استطال بالصراخِ
ثم
انقطعَ
مَن سقط قبل الآخر].
كلمة [ مدوه ] أُقنوم شعري ... ملحمة... تقع على مسافة من موضوعها ، هذه المسافة ترتعش بالمواقف و التصورات و التداعيات ، تتحرك على المتن الشعري كالشظية التي فقدت توازنها ، متشنجة ، تتقلب تحت ضغوط قاسية ، تتدافع عليها ابعاد قلقة ، لا تستقر ، لا تهدأ ، كلما رُمِمَت بكارتها ، تعرضها ثانية الى السفاح العاري ، لا تريد ان تستمر بِكراً ... البكارة عيب ... عار... عقم ...
الحبل يمتد ...
صراخ الحبل يمتد ...
و لكن هناك امتداد آخر ... امتداد الرقبة ... هو المطلوب ... من أجله كان الصليب ، وكان الحبل ، وكان الجلاد ، وكانت كل هذه الحفلة الصاخبة ... ولا أثر يدل على ذلك .
اين اختفى هذا الامتداد المروع ؟
لماذا تجاهله النص فيما هو المقصود ؟
الشاعر المبدع يُخفي البديهة في نصه الظاهر، ليثيرها في نصه الباطن ، كي يهيء للآخر متعة البحث عن السر، يدعه هائماً في تداعيات النص، لا يضع بين أيدينا بضاعة جاهزة ، فهذه مهنة الوعاظ ، البديهية في النص الشعري المبدع تتحول الى سؤال معقد ، تصير منبع تساؤل والحاح دائمين، تنثال على شكل اسئلة قاسية و مزعجة ، وإذا دخلت البديهة مسالك السؤال ، وخضعت لمنطق الحوار ، و فقدت حضورها التقليدي ... في مثل هذه الحالات تشتبك الصور و تتقاطع المشاهد وتتداخل الاسئلة .
ان القراءة العميقة جزء من النص ، تُعرّي جسده فتضيء مواطن الفتنة ، تهتك أسراره كي تُخرج صوته المكبوت ، وامتداد الرقبة المخفي في النص، ينتظر عملية هتك جريئة ، ان تعرية النص الشعري فن إباحي ماهر ، يبدأ باللهاث الحار ، تتوالى الأنفاس فتخلق جواً ساخناً ، جو يلتف حول النص ، يلامس برقة و نعومة هذا الجسد اللدن ، يلاصقه على فراش آهة مرتجفة ، ثم يغرس في لحمه الدافيء علامات استفهام بريئة ، و في ضوء الأجابة تتعمق الأسئلة ، تطفح بزيت الشهوة المجنونة ... يتعانقان ... يتضاجعان ...يتداخلان ... يحفر في كل منهم روحه ، فيرتسم المخفي في سماء الظفر الكوني المقدس ، فالبديهية في الشعر ، تختفي تحت ركام هائل من نوايا الاثارة ، التي كان الشاعر قد خزنها في روحه المعذبة.
امتداد الرقبة بديهة كونية على صليب الجلد ، ولكنها سر ا لنص الشعري ، الذي يجب ان تستله القراءة العميقة ، القراءة المشاركة ، قراءة الهتك والتعرية ... القراءة الاباحية الفاحشة .
نستمر في هذه القراءة ...
الشاعر عدنان الصائغ يواصل تفعيل الصورة ، ولا توجد كالاضداد والتناقضات في اداء هذا الدور الرئيسي في الشعر ، شريطة المهارة في الاستعمال ، ان تثوير التناقضات قد يتأتى من المقابلة المباشرة ، و قد يتأتى من الانقلاب المفاجيء ، وبالتالي ، تعتمد العملية على مهارة الشاعر ، وطبيعة القضية المطروحة ، والظروف التي تحيط به .
[ ثم ...]
هذا المقطع يمهد لنقلة كبيرة ، المشهد الشعري في طريقه الى انعطاقة حادة ، والاختيار يتجاوب بفاعلية مع الامضاء السابق ، لان [ ثم ...] تفيد التراخي الزمني ، اي إننا نشم في هذا الرسم رائحة الامتداد ...
و لكن ماهو المتوقع بعد هذا الانذار ...؟
[ انقطع...]
صدمة مضاعفة ، يخلقها تواصل الحدث ...
ثم ماذا بعد ...؟
[ سقط ....]
لننظر في هذه المتوالية الهندسية من مضاعفات الحدث [استطالة ... انقطاع ... سقوط ...] ، ذلك ان الحدث يتسارع نحو نهاية مفجعة ، الامر الذي ينبئ ان المحاولة في رحلة صادقة نحو الشعر ، انها تريد ان تلتحق بملكوته المقدس ، فلابد من تعميق التصدع ، تركيز التشنج .
مقترب آخر أريد ان أُلامسه بسرعة !
الحبل الذي يؤدي دور الجلاد يصرخ ... ولكن الرقبة المحزوزة لا تصرخ...
هل هذا ممكن ؟!
هل يقول الشعر ، ان من حق الجماد ان يحتج ، ومن واجب الحي ان يصمت ؟ أم أن قوانين العقوبات الجديدة تقضي بالخنق الذي يجلد الحياة و يُخمد الصوت ؟ أم ان الرقبة صرخت ، و لكن صراخها ضاع في ضجيج هذا الزمن الرديء ؟ أم ان الضمير البشري يستمع فقط للنداء ، الذي لا يحز في الاعماق ؟ أم ان الشاعر كان غائب الحواس ؟
لا أدري ...
كل كلمة في الحدث الشعري المبدع نقطة مركزية ، تجسد الانانية كاملة ، تحاول ان تكون هي المسؤولة عن صنع الحدث ، تفيض بأقصى عطاء من الممكنات ، تشرق بشمسها على جسد القصيدة كله ، تطاردها لعنة الفتنة والغرور ، ينهش قلبها العداء المر لكل نظير أو مخالف ، وتحاول جهد طاقتها ان تستولي على سر القصيدة دون غيرها من الشقيقات ، وتستأثر بغضب الآخر ورضاه ، وتحتكر فجوره وتقواه ، صحيح انها تتلاصق مع أخواتها ، و تتصاف معهن على وفاق ، ولكنه تلاصقَ الغلبة المبيته ، وتصافَ الرضا المُبطّن بالمفاجأة غير المتوقعة .
كل كلمة في المتن الشعري تنمو مثل شجرة الحب ، تنمو بسرعة ، تتفرع الى تداعيات و فضاءات ، تثير في قاع الوعي الشيء و ضده ، تحفز الذاكرة على استرجاع المنسي و المكبوت و المطمور تحت ركام الزمن الذي لا يرحم .
كل كلمة في المتن الشعري ، تجاهد ان تكون لها الريادة ، في تنظيم سيرة الشعر، وكل من يرى ، ان الكلمة الشعرية بريئة مسكينة ، انما يحكي عن برائته و مسكنته .
الكلمة الشعرية ملحمة سردية ، مما يعني ، انها مزيج جنوني ، من السماء والارض ، من السحر و الواقع ، من الخيبة و الامل ، انها تحتضن سراً من كل شيء ، و الكلمة تأبى على الأسر ، لها قدرة رائعة على التحرر و الانفلات ، و من الغريب ان هذه الحركة ـ إذا تمعنا فيها جيداًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًـ لاكتشفنا انه طائشة في ظاهرها و لكنها ذا ت نظام دقيق في الباطن البعيد ، و هذا من أسرارها الجميلة . ان هذه الفوضى ـ كأي فوضى في العالم ـ مسكونة بعلائق تصونها من فقدان الوهج الوجودي ، و تحميها من ميوعة الاداء والعطاء ، تذب عن كيانها ضد رغبة الوهم في افتراس كل شيء يقترب من حافته ، والكلمة الشعرية تشطح بروحها نحو الهيام ، فتكون مهيأة للضياع والاختلاط ، و ربما يجهزها بأبهى الحلي لسطوة الموت ، و الشاعر المتقد بوهج الكلمة.
و تداعياتها ، هو في الوقت ذاته ، منغمس في شرفها وملتحم بهيبتها ، وكم هو فن دقيق ، ذلك الذي يجمع بين البهاء و الشهوة ، بين تقوى الروح ومرح العين ، بين النكتة النقية والضحكة الفاجرة .
يقول عدنان :
[الأقدام .....
التي تسير في كل اتجاه ..
لا تصل ]
هناك معركة بين الكلمات ، معركة تخفي فواعل تتصارع بعنف ، من أجل الاستحواذ على الموقف النهائي ، أقدام تسير ، ولكن بين الغاية وهذا المسير ، ثغرة أزلية ، تحول دون أي نتيجة .
ولكن ما السبب ؟
اننا لا نستطيع ان نصل الى المستحيل عبر الممكن ، وليس من الحكمة ان نستهلك الحاضر القلق من اجل مستقبل قار ، ولكنه لا ينتمي الى دائرة الطموح المشروع .
ان هذا السير ، ممزق بين تلاقي الاتجاهات في أفق الطموح من جهة، وتشتتها على ساحة الوجود المتنوع من جهة أخرى .
المعركة بين الكلمات داخل النص الشعري قاسية مريرة الأقدام والاتجاهاتُ و الوصولُ ، كل منها يجالد من أجل الفوز بعلامة الانتصار، في العالم المسموع والعالم المرئي ، على صعيد الكلام و الواقع .
هناك روح تسري في هذا التوقيع الشعري ، تكفّل بضبط مسيرة الكلمات ، حال دون جموحها للهروب المستمر الى الامام ، هذه الروح هو الفلسفة التي آمن بها الشاعر ، لا شك ان درجة الاحتمال قائمة في النص ، فهذا من ميزات اللغة الشعرية ، فإن للشاعر سيادة ـ في حدود ما ـ على الكلمة ، يروض من نزوعها الفوضوي الذي لا يعرف الحدود و لا التخوم ، و الفكر أحدى أدوات هذه الموازنة المهمة ، وإلاً تضيع القصيدة ، تتحول الى هباء منثور ، ان لعبة الكلمات ليست فوضوية ، هي لعبة حرة ، ولكن النص فكرة شئنا أم أبينا ، مهما اختلفنا في تفسيره وتأويله ، وهذه الفكرة تساير النص في حركته ، ترافقه في تشكلاته الذهنية و الروحية ، ولكنها حريصة على علاقتها بالنص حسب قاعدة التكافؤ في حق الوجود ، ومهما تغلغل الفراغ في جسد النص ، فأن الفكرة او الأفكار تمتد لتلون كل محاولة لملأ هذا الفجوات ، ان القصيدة جسد ، يستقبل الكثير من المؤثرات ، و يستوعب الكثير من هذه المؤثرات أيضاَ ، ولكن يملك حساسية لا بأس بها من التقاعل مع الوافد الغريب جداً ، و أي اقحام قهري مصطنع لهذا الغريب يغيب الجسم ، و هذا ما فعلته نظريات التفكيك المتطرفة في النص ا لشعري والخطا ب الادبي بشكل عام ، أقامت علاقة غربة كاملة بين النص و الآخر، بين النص و القاريء الواحد في كل لحظة ، فمات القاريء و دفن النص .
يقول الصائغ :
[ بلا أجنحةٍ
يطير الغبار ساخرا
من آلاف الأشياء التي تركها على الأرض
مهما أثاروك أيها الغبار
ستهبط الى القاع
حتماً ...
بأسرع مما علوت ]
الغبار هنا استعاضة كلية جذرية ، عن كل أشكال الزيف ، التي تتألق بفعل الظروف المفروضة، وهي لا بد ان تغلدر ـ يوما ـً مسرح الوجود ، مهما طال الزمن و قست الأقدار ، لأن الأصالة تتمتع بجذور نابتة في أعماق الأشياء ، و الحقيقة ان الشاعر هنا ، لم ينطلق من تشابه سطحي بين الغبار و الزيف ، ان الاستعارة في الشعر استعمال حقيقي وليس مجازياً ، هي تزيين و زخرفة في الكلام العادي ، ولكن على صعيد النص الشعري يختلف الأمر كثيراً، تكشف عن مهارة متفوقة للتعبير عن حقيقة جديدة ، عن كون آخر ، ان استعمال الغبار في موضوع الزيف ، يتجاوز فكرة التشابه ، مهما كان التشابه و اضحاً جلياً ، ومهما كان الاختلاف بينا صارخاً ، لانها ليست نقلاً أو تحويلاً ، بل هي ا ستعمال مباشر ، فليس هناك محذوفاً .
الغبار في المتن هو ذات الزيف و ليس شيئاً زائفاً ، لقد أُنزل الغبار منزلة الزيف في المتن الشعري حقيقة و واقعا ، ان العلاقة بين المعنى الحرفي والمعنى الجديد دخلت مرحلة القطيعة ، بدليل ان كل ا لمقتربات والنتائج والفضاءات ، التي ترتبت على الاستعمال الجديد ، تحولت الى دوائر تحيط به ، تستمد منه صلاحية الموقع ، وتلوذ بشعاعه المتشنج ، كي تثق بنفسها ، وتقاوم كل محاولة لتهميشها ، ان المشبه داخل في جنس المشبه به ، ذاب في بوتقته ، في خلاياه ، في دمه ، في روحه ، تحول بكل هويته لصالح المعنى الجديد ، فقدَ صورته ومادته ، تلاشى صوته ومعناه ، و بالتالي ، ليس هناك مبالغة ، ان فكرة المبالغة في الشعر، استناداً الى الاستعارة مزقت الهوية الشعرية .
ان منطق المشابهة في هذا الفن ـ الاستعارة ـ على صعيد الشعر ، حوّل الشعر من رؤية الى متعة لفظية ، جعل منه مشروعاً حرفياً ، قدّمه زينة وربما فكاهة ومنادمة وعتاب ومسابقة ، وأغرقه في لغة المقارنة الباردة ، التي هي بدورها جرد من الاحصائيات المنصبه على تجليات بديهية للأشياء في كثير من الاحيان ، فيما الشعر يصيغ وجوداً خاصاً به ، يشرق بمقولات تتوازى مع مقولات الوجود المألوف ، وقد تنافسه في قوة الحضور والالتماع ، وإلا ماذا نسمي هذه الحالة ، التي تنعدم فيها الحدود بين المنية والوحش ، بين البحر والعلم ، بين الزيف والغبار ؟
في التحليل الدقيق لهذا الاستعمال ، ليس عندنا زيف ولا غبار ، بل عندنا الزيف الغبار ، أي صورة جديدة ، كون مبتكر ، و قد يعبر عنه بمعنى جديد ، اننا بين يدي خلق لغوي مستحدث ، ولكن لتمثيل انطولوجيا مستحدثة ، الزيف الغبار لا ينتمي الى كل من العالمين ، أي المستعار والمستعار له ، بل هو مفردة وجودية جديدة .
ان الاستعارة الشعرية تحتاج الى حدس روحي من أجل استشرافها واستلهامها والتفاعل معها ، لأن الثغرة بين المعنى الحرفي والمعنى الجديد تنبئ عن نقلة بين عالمين ، الاول معطى مجاناً ، رتيب ، راضِِ بقدره ، مطمئن الى غد مكرور ، و عالم آخر يصدم أُلفة الحس ، و يعبث في مقولات العهد القديم ، لانه مفاجأة صادمة ، تتطلب استعداداً مفتوحاً لسيل من الاحتمالات ، لا يهدأ و لا يرحم .
الاستعارة تحرر الكلمة من ماضيها ، تفض أسرارها المقموعة بجبروت الألفة و العادة و الروتين ، وتنتقل بها من مستوى المعطى الجاهز الى مستوى الكامن ، الذي يتشوق الى إداء دوره المكبوت، ومن هنا قلنا ، ان استلهام الاستعمال الجديد ، يحتاج الى بصيرة ، الى حدس متمرس ، فالاستعارة ليست زينة ، بل هي تحرير الكلمة من سذاجة البعدين ، وتظهير لبعدها الثالث ، بعدها المجهول و هو سرها الخلاق و روحها المبدع .
يقول في شفرة شعرية سريعة :
[هل تتذكرنا المرايا
حين نغيب عنها ].
المرايا تعلن عن نفسها معنى آخر ، هل هي الحبيب ؟ أم هي التجربة البشرية التي نمر بها في كل لحظة ، أم هي مفارقة ذات وقع متميز في حياتنا؟
ان المرايا بالاستعمال الجديد ، مهما كان موقعه من التصور ، تحررت من تراكمات القهر الزمني الرتيب ، برزت ببعدها الثالث ، تمخضت عن مسيرتها التي تشكلت في داخلها ، نزعت قشرها الخارجي ، و عرضت نواتها الأولى ، والتعامل مع هذه المقتربات يحتاج الى أدوات عميقة ، واعتقد ان الحدس هو المرشح لمثل هذا العمل الجبار.
هل يوفر لنا الشعر فرصة الوعي ؟ و ما هو موضوعه ، الذي يجرفنا اليه ، حتى نمارس فيه الوعي ؟
سبق وان قلنا ان العالم الخارجي مجرد باعث بالنسبة للحدث الشعري ، محفز ، باعث ، يستوعبه الشاعر في لحظة معينة تتميز بفرادتها الخاصة ـ ولا مجا ل الآن للتفصيل في هذه النقطة ـ و لذا لا يشكل هذا العالم موضوع الشعر الحقيقي ، رغم العلاقة الوثيقة بينهما ـ سنتعرض لاحقاً لهذه المسألة ـ و قد يوحي هذا الكلام بأن موضوع الشعر ، هو الشعر ذاته ، و هذا ما كنت أتصوره ، باعتبار ان الشعر جوهر لغوي في الأساس ، ولكن الشعر يصنع لي عالماً جديداً ، هو العالم الشعري ، يوازي العالم الفيزيقي ، وربما يزاحمه ، بشكل من الاشكال ، ومن هنا ، فإن موضوع الشعر هو العالم الذي يبدعه ، العالم الذي يؤسسه ، أي أن موضوع الشعر ما يترشح عنه ، فالشعر أولاً ثم موضوعه ، وذلك خلاف العلم الذي ينتمي الى الوجود اليومي ، حيث ينصب على مادة جاهزة ، على قضية تسبق العلم رتبة ، ولكن على صعيد الشعر، تنقلب الآية ، لان الكون الشعري هو نتاج الشعر ، إبنه ، ربيبه ، يخرج من بين خيوطه االساحرة ، الكلمة الشعرية في البداية مشبعة بالواقع ، و لكن السياق ـ بما يرتع به من حمولات و أدوات انزياح وتداعي ـ يهيؤها لاشتقاق عالم جديد ، ذلك هو عالم الشعر ، وبالتالي ، موضوع الشعر متأخر عن الشعر .
هذا العالم الجديد لا يوفر لنا فرصة الوعي بل سكرة الوعي ، هذا ما نشعره من أعماقنا ، نسكر بنخب هذا العالم ، الذي يرتسم في كينونتنا فجأة ، ينحت أبعاده بلغة مبتكرة في صميم جبلتنا ، ومن المفروض ان نسكر لأنه عالمٌ صادم ، يربك اليقين المتكرر ، يغيّر معادلة التفكير ، يبعثر المنطق السائد .
سكرة الوعي عبارة عن وعي مركز ، متشنج ، و ليس غيبوبة سادرة كما يُخيل للبعض ، نشوة ووضوح ... رعدة و اطمئنان ... رعشة و استقرار ... مزيج متلاحم من عقل يشتهي و شهوة تعقل ، و اداة هذه السكرة التقية المؤمنة ، هي الكينونة الانسانية بكليتها ،أي جماع الذات ، مما ترث و مما تكتسب ، خميرة ملتهبة بالأصل و المضاف ، خاصة وان الشعر، حصيلة ذات الشاعر ، و جوهر كينونته ، ونعتقد ان التجربة تدلل على ذلك بوضوح ، فالعارف بالشعر، ينفعل بكل وجوده بالصورة الشعرية ، يعطيها كل كيانه ، يفتح كل مسام روحه ، كي يتيح لنبض الشعر ان يستقر في قاع روحه ، فيما الجاهل بهذا العالم ، او الذي لا يتمتع بذائقة مرهفة ، يتعامل مع الصورة ببرود ، أو بإعجاب و قتي ، سرعان ما يفقد تأثيره ، ويتلاشى سحره .
الشعر خمرة معتقة ، ممزوجة بشهوةَِ نهدٍ طفولي، يغلي بين راحتين مغموستين ، في جمرة الحب الألهى المقدس .
شعر عدنان الصائغ للذين يعشقون الشعر ، للذين ينشدونه بروحهم الملتاعة ، لأنه ينبعث من لحظة انقطاع كلي الى الشعر .
يقول :
[ أراهم ..
يدفعونني و يدخلون
يدفعونني و يخرجون
وأنا اصطفق بأضلاعي
وراءهم
لا أحد يلتفت
ليرى
كم هي مضنية
و صفيقة ،
مهنة الباب ]
ان هذه الصورة ليست للذين يجلسون على الأرائك ، بل هي للذين تشتعل في قلوبهم النار ، كل مشهد صرخة مشبوبة بآهة الأرض ، المحرومة من ماء السماء ، لانها رفضت سيادة الآلهة المزيفة .
إن حامل الضمير الفاعلي ـ هنا ـ مُغيًب وجودياً بقدر حضوره نحوياً ، هناك تضاد ضمني ، اللغة تنعكس في عالم ا لوجود ، لم يجد ضمير الفاعل موقعه في مملكة الوجود ، كما هو في مملكة اللسان ، شخوص يلتمع بصدارة الأسبقية على صعيد اللغة ، ولكنه انكسار ذليل على صعيد الاستواء مع النظير . شخصية تتصدع بين اللغة و الواقع ، و لذا ليس غريباً ، ان يغيب هذا الضمير ـ بكل جبروته النحوي ـ في تداعيات الضمير المقموع [ أراهم ... يدفعونني... يدفعونني...] ، ضمير المفعول يستدرج ضمير الفاعل ، يشدّه إليه قسراً و عنوة ، لان حامل هذا الضمير مهمّش ... مُقتََلع ... مرمي على قارعة الطريق ...مشغول النظرة المضطرة ... تنزلق صورته على أطراف النظر، لتغيب في ظلام ذاكرة لا تُستعاد أبداً ...
التضاد في الصورة الشعرية من القضايا الكبرى في موضوعة الشعر ، بل ذلك جوهر الشعر في قاموس بعض المنظرين ، و التأليف بين هذه المتضادات مهمة الشاعر المبدع ، كي يلهمنا و حدة الكون ، و بذلك يُعزٍي الضمير الإنساني ، و يخفف من شعوره المأساوي بالعالم ، و يجسد الشاعر هذا التضاد ، بملاحم من ألوان الصراع بين هذه المفارقات ، التي تحكم ظاهر الحياة وتأسر باطنها ... شبع / جوع ... ألم / لذة ...إرتفاع / هبوط ... صحة / مرض ... الى ما شاء الله من صور تتفجر في روح الشاعر وضميره ، ولكن هناك تضاد من نوع آخر... أكثر عمقاً وأغور جرحاً ، انه التضاد بين اللغة والواقع ، انه تضاد عمودي ، وليس تضاداً عرضيِاً ، انحدار من علو اللغة الى درك الوجود ، تسلق من قاع اللغة الى قمة الوجود.
[ أراهم ..]
ضمير[ الأنا] الرابض في صلب الجملة يشع بالقوة ، يملك سطوة التوجيه والارشاد ، تتطلع العيون و الآذان الى حضوره الموازي ، الى تجذره في العالم ، الى نفاذه الكوني ، ولكن هذه السطوة تمزقها انياب الواقع المظلم ، تهينها إخفاقات التاريخ ، تحطمها معادلات السلب القاسية ، هذه الاشراقة يلفها ظلام متكبر ، يتجاوزها الآتي و الرائح ، لا تثير رأياً و لا تلفت نظراًُ ... تنتكس ... تتهاوى ... [ يدفعونني ... يدفعونني ...] ... العلاقة بين الضمير المشرق و الواقع معكوسة ، وهنا تكمن بعض أسرار العذاب الوجودي .
هذه المسافة المعكوسة بين اللغة و الواقع تتكرس في الصورة الشعرية في المقطع الثاني ، فهو يقول:
[و أنا أصطفق بأضلاعي
وراءهم
لا أحد يلتفت
ليرى
كم هي مضنية
و صفيقة ،
مهنة الباب ]
الـ[ أنا ] المترعة بالغرور النحوي تعاني من ذل واقعي ، الزمن الرديء صك على ناصيتها رسم العبودية ،أ لغى الى الابد هيبتها اللغوية ، الأسم والمسمى لا يتطابقان ، الأسم ملك بدون صلاحيات تذكر ، مجرد إسم .
إن التضاد بين اللغة و الواقع من مصادر التوتر في القصيدة ، ومن محفزات اشعال الضمير و مبررات التمرد على القيم البالية ، وهي تدعو الى إعادة النظر بكل القيم السائدة .
هذا التضاد خفي ، يسكن الضمير ، و لذا لا يثير أي قاريء ، إلا إذا كان هذا القاريء ممن اكتوى بمحنة التاريخ ، و انا أعتقد ان القراءة الشعرية تحتاج الى تجربة تاريخية قاسية قبل كل شيء ، فإن النص الشعري تجربة تاريخية في البداية ، والعالم الجديد على صلة سرية بهذه التجربة .
هذا التضاد صامت ، يعمل بصمت ثقيل ، يقضم لحم الشاعر بهدوء حاقد ، ولذلك ، قد لا يعبر عن احتجاج بقدر ما يكون دالة على اليأس المطلق .
الشعر يؤلف بين المتضادات ،هذا ما نقرأه ، وذلك كي يعزينا ، و لكن هذا بين المتضادات العرَضية ، التي تتوازى من أجل استدامة الحياة ـ كما يقولون ـ ولكن التضاد بين اللغة والواقع عسير على التأليف ، يتمرد على الجمع ، يبقى شاخصاً متفرداً ، غير قابل للانمحاء ، بل دوره محو الحقيقة وتدمير الزمن:
[ أكتب ويدي على النافذة
تمسح الدموع عن وجنة السماء
أكتب و قلبي في الحقيبة يصغي لصفير القطارات
أكتب وأصابعي مشتتة على مناضد المقاهي ورفوف
المكتبات
أكتب وعنقي مشدود منذ بدء التاريخ
الى حبل مشنقة
أكتب وأنا أحمل ممحاتي دائماً
لأقل طرقة باب
وأضحك على نفسي بمرارة
حين لا أجد أحداً
سوى الريح ]
أكتبُ ... الضمير يطرح نفسه مشروعاً ...هكذا توحي البداية ... وليس كالكتابة مشروع ...ولكن هذا المشروع الانساني الضخم ، يتبدد بسرعة مدهشة ، لأ ن الضمير تناثرَ إلى أجزاء غير قابلة للم مرة أخرى ، تناثرَ بين حافات القبور المهجورة ، وعلى أعتاب المباغي المرهقة بالصرخات المزيفة ، الضمير تمطى مرهقاُ على سلسلة القهر المضني ، فتلاشى رويداً رويداً ، فقتل المشروع الى الابد .
الشاعر عدنان الصائغ غارق في مبدأ تدمير الذات ، من خلال هذا التوتر الحاصل من الصدام المر بين اللغة و الواقع ، واعتقد أن الحزن عقيدة شعرية ، لان الحياة لن تكتمل يوماً ، و الحزن الشعري ليس من الوجود وإنما على الوجود ، ومهما يكن من أمر ، لم يسلم ضمير الشاعر من هذا الانكسار أبداً ، بل هو قدره ، يحضر في اللغة / ينعدم في الوجود ... انه مشهد لا ينتهي ...
الضمير ـ ضمير الفاعل ـ تحيطه بؤرة انكسارات ، تتقاطع في ما لا نهاية من النقاط ، تقترب منه بهدوء ، ثم تلتف بعقدها القاسية حول روحه الشغوفة بالحضور ، تضغط عليه بلا رحمة ، تفتت جوهره الروحي ، فيضطر صاغراً للرضوخ الى منطق النفي الوجودي .
في اللحظة التي يطمئن فيها الشاعر الى نفسه يطرده الكون ، فليس الكون أطرافاً سائبةً ولا جوهراً مترهلاً ، بل الكون جمرة ملتهبة ، كما ان الحياة لم تبلغ المدى الذي اراده لها الله ، فروح الشاعر مجروحة ، لم تندمل ، وإذا اتجهت هذه الروح ، الى التصالح مع اللحظة الحاضرة ، تنطفئ شعلة القلق في ذاته ، فعليه ان يصب الزيت الحار على جروحه ، حتى يصرخ من جديد ، فإن الشاعر هو الضحية دائماً ، بل هذه هي علامة صدقه ، كيف يبتسم و هناك شروخ عدوانية تشتت جوهر الإنسان ؟ كيف يغمض له جفن و هناك عدوان مستمر يشوه جمال الكون؟
[ لا شمعة في يدي ولا حنين
فكيف أرسم قلبي
لا سنبلة أمام فمي فكيف أصف رائحة الشبع
لا عطور في سريري فكيف أستدل على جسد المرأة ]
هذه المعاناة الوجودية ليست هموماً فردية ، ليست حاجات مؤقتة تنتظر الامتلاء السريع ، فالظلام و الجوع و القسوة و الكبت جروح في جسد الكون ، والشاعر يتعامل معها بصفتها إشاكلية كبيرة ، لأنها تحول دون تحقيق الذات ، و هذه الاشكاليات رحلة من السؤال الجوال في ضمير الشاعر ، حيث يبقى بلا جواب ، فالشاعر ليس مصلحاً أو واعظاً ، و انما هو خالق صور ، مبدع عالم ، و في ضوء هذا الخلق الجديد يطرح للبشر رؤية نقدية للواقع ، وبذلك يعود الشاعر الى العالم الذي غادره ، يعود إليه من جديد ، كي يعمل على تشريحه ونقده ، فالقصيدة في الحقيقة عمل نقدي في الدرجة الأولى .
الصورة التي بين أيدينا ـ الآن ـ نسخ شعري للدم ا لكوني المهدور ، نسخ شعري لأنفاس الحياة الملغومة بوجع القدر الجافي ، فالشاعر ـ إذن ـ كائن قلق ... قلق من الكون إذا افتقد حكمته ، وقلق على الكون اذا اكتشف هذه الحكمة ، والقلق الذي يتعدى بـ [ على ] في تصوري أعمق من سابقه ، لأن الخوف على حكمة الوجود يضاعف من مسؤولية الشاعر ، فالحكمة هي الحامل الموضوعي لهذا العالم ، هي العزاء ، هي الملاذ ، ولكن مسؤولية الحفاظ عليها تقع على عاتق الإنسان ، وأعتقد ان الشاعر بهذه الصورة يعترض على النقص المفروض من الخارج ، وليس على حكمة الكون في الأساس .
[ كيف لي
أن أتخلص من مخاوفي
رباه
وعيوني مسمّرة الى بساطيل الشرطة
لا الى السماء
و بطاقتي الشخصية معي
و أنا في سرير النوم
خشية ان يوقظني مخبر في الأحلام ]
ان الشاعر الذي يؤمن بحكمة الكون يقلق ، يقلق على مصير هذه الحكمة ، وهذا القلق مصدر خلق و ابداع ، يعبر عن ايمان مركب ، في داخله يتشابك اليقين و الخوف ، ليس في إطار الصراع الذي يؤدي الى الحذف ، وانما الى التكامل ، وكلما إزداد الشاعر إيماناً بحكمة الكون ، تصاعد قلقه على مصير هذه الحكمة من عبث العابثين ، أنه كتلة من قلق :
[ هذه الأرض
لم تعد تصلح لشيء
هذه الأرض
كلما طفحت فيها مجاري الدم و النفط
طفح فيها الانتهازيون
أرضنا التي نتقيؤها في الحانات
ونتركها كاللذات الخاسرة
على أسرة القحاب
أرضنا التي ينتزعونها منا
كالجلود و الاعترافات
في غرف التحقيق
و يلصقونها على أكفنا ، لتصفق
أمام نوافذ الحكام
أية بلادٍ هذه
ومع ذلك
ما ان نرحل عنها بضع خطوات
حتى نتكسر من الحنين
على أول رصيف منفى يصادفنا
و نهرع الى صناديق البريد
نحضنها و نبكي ]
هناك حكمة عظيمة تتعرض لنهش مسعور ، حكمة الأرض وحكمة الوطن وحكمة الوجود بشكل عام ، والشاعر قلق على هذه الحكمة الرائعة من الضياع .
ان الشاعر في خضم هذه الاشكالية المعقدة بين أمرين ، إما أن ينطق أو يسكت ، صحيح انه سيحترق في الحال إذا نطق ، ولكنه سيضيء في المستقبل ، ... ان نظرية التأجيل هي المعادل الموضوعي للموت ، إن الذي يأتي فيما بعد ، لينطق بما هو زمانه لم يفعل إنجازاً عظيماً ، إن الإنجاز الحقيقي هو الذي من شأنه الصدمة في الحاضر ، لتكون مألوفة في المستقبل ... هذا الشاعر ضد العفن الاجتماعي ، ضد نظرية الوقت الضائع ، ضد التسكع ، ضد الثروة المزيفة ، ضد الهوامش ، ضد الزخرفة ، فمن الطبيعي ان يتعرض للقمع والرفض.
باللغة تتحرر ذات الانسان من سجنها ، من غياهب الصمت المبهم ، الذي يقض مضاجع هذا المخلوق العظيم ، اللغة تفجر الذات الإنسانية ، فينطلق حاملها خارجاً ، يتسع نشاطه ، و يتعمق ادراكه ، وتتنوع علاقاته ، وإذا خرج الإنسان من الصمت الى العلن ، ينفتح على مشاريع طموحة ، ومن هذه المشاريع التوق الى عالم أوسع ، انه يحاول ان يتجاوز المنظور ، وكل محاولاته التي يبذلها لارتياد السماء ، انما تعبر عن نزوع نحو الأعلى ، ومن الواضح ان الانسان ، لا يقتنع بالوقوف على ما ينتهي إليه من عوالم ، انه يرغب بالمزيد ، و كثيراً ما يدفعه هذا النزوع الى خلق عوالمه الخاصة به ، وسلاحه الفكر و اللغة ... في تصوري أن أدوات الانزياح الشعري ، ليست بقايا اعتقادات اسطورية ، ولا هي محاولة احتواء انساني وجداني للأشياء ، و لا هي رغبة الإنسان الإحيائية ، بل هي تعبر عن نزوع الانسان الى إرتياد عالم أوسع ، عالم اكثر تجاوباً مع طموحه و خياله ، ان المجاز و الاستعارة و الكناية وغيرها من أدوات الازاحة اللغوية ، انما هي طموحات خيالية خلاقة ، والتدقيق في هذه الأدوات يكشف عن تحرير للغة من سجونها الرتيبة ، من قيودها التقليدية ، بما في ذلك التفكير المنطقي الجاف ، فنحن في الاستعارة نمارس عملية إزاحة كونية ، من أجل موجود جديد ، أو عالم جديد لا يخضع للمنطق الاعتيادي ، وكانت هفوة كبيرة ، ان نعتبر الاستعارة خروجاً بالشيء من عنوان الوجود إلى عنوان العدم ، لان الاستعارة ليست مبالغة خارج حدود المعقول ، حتى نصل الى هذا الاستنتاج ، بل هي تسمية جديدة لمعنى جديد ، عنوان لكائن مبتكر ، وفي التشبيه نمارس مغامرة تتجاوز المجهود الأرسطي الذي يستثمر نقاط الالتقاء من أجل التعريف ، حيث يخضع للكليات المنطقية المعروفة ، ان التشبيه في الشعر يتجاوز هذه السجون ، يكسر هذه القيود ، بتعبير أدق ، ان التشبيه الشعري لا يعتني يهذه الموجٍهات المنطقية ، لأنه يتواصل مع سكرة الوعي وليس مع العقل ، ولذا يجمع بين مفردات لا تنتمي الى كلّي منطقي ، و إلاّ أي جنس هو الذي يضم البدر والوجه ؟ أو يصدق على الخلق الكريم و العطر ؟ أو يترافق تحت ظله العلم و الحياة ؟ أو يستضيف في رحابه العريض الجهل و الموت ؟ و هكذا مع كل كلي منطقي ، جيء به لتصنيف حركة الفكر ، وترتيبه وفق تسلسل تراتبي متداخل الدوائر ومتعانق النهايات !
ان التشبيه الشعري يعتمد على منطق الصهر الوجودي ، بل الانصهار بين مختلفات ، بين متباعدات ، ليصنع مفردة وجودية جديدة ، لا تخضع لقواعد العالم المتكرر ، و المجاز ثورة على استبداد العالم باللغة ، تمرد على هذه المفردات التي تصادفنا في كل لحظة ، تحرير للذات ليس من الصمت المبهم و حسب ، بل إضافة الى ذلك ، تحريرها من العالم المستبد ، العالم الذي تكور بكل جبروته على ذات الإنسان ، و جثم بكل طبقاته الكثيفة على ضميره وحسه و عقله و كينونته ، ففي المجاز رحلة وجدانية شاقة ، تتمخض عن اضافة مبدعة ، في المجاز اشباع لرغبة الإنسان بالخلق و الابداع و الابتكار ، و هو دليل على ان هذا المخلوق العجيب ، مصاب بمرض التطلع لما بعد ، ومن هنا ، لا نعتقد ان المجاز هو استخدام لغير ما وضع له أساساً ، هذا في ا للغة العادية ، أما في لغة الشعر ، فالأمر يختلف ، انه استعمال في موضعه و معناه و حقيقته ، انها لغة الشعر ، ونحن عندما نقرأ الشعر لا نلتفت الى غيره من الإحالات ، انما ننغمس في ناره ، نسمع صوته ، و نلامس حروفه ، نعيش الشعر ، وعليه نحن في عالم جديد ، له لغته الخاصة ، فلماذا لا نعتبر مجازه حقيقة ؟ !
الشاعر عدنان الصائغ ماهر في تجسيد أدوات الإزاحة اللغوية ، انه يحرص جداً على توتير المعنى ، و الهجرة بالكلمة الى مسافات بعيدة ، مما يهيء لنا حظ الارتحال المضني .
يقول :
[ يسقط الثلج
على قلبي
في شوارع رأس السنة
وأنا وحدي
محاط بكل الذين غابوا ]
هذا التوقيع الشعري السريع إزاحة لغوية كاملة ، نظام متواصل من التحولات ، الغيا ب حضور والحضور غياب ، في سياق من تبادل المهمات ! و يلتقي الزمان بالمكان كي يتحولا الى شاهد حي على مأساة الغربة ، والذكريات تفرض وجودها ، لتصرخ بحقها من التشخص الخارجي ، لأن الأساس في ا لوجود هو التشخص و ليس المحاكاة ، وحدة صارخة محفوفة بشبح يلح على حيّزه الحي من الواقع...
الصورة الشعرية ـ إذن ـ استعارة كاملة ... عبور مستمر ... مجاز لا يرتد ولا ينثني ... تخليق عوالم ...ثمة وجود لا يحمل النكهة التي نألفها في حياتنا اليومية ... ثمة حزن غريب على قلوبنا ... ثمة لغة تسدل حجاباً بين ابصارنا وهذا العالم المستبد ... ثمة صوت يتردد في اعماق الكينونة ... انها لغة الشعر ... تصنع وجودها الخاص بها ... الذي سوف يتحول الى شاهد تاريخي دائم .
في توقيع شعري بعنوان: الاسكافي
[جالساً
على الرصيف
أمام صندوقه
يرنو
لأيامه التي
ينتعلها الناس ]
هذا التوقيع الشعري هادئ في ظاهره ...تطوف على محياه تلاوين الحزن البريء ... ثقيل الخطى ... يزحف ببطءٍ ... و لكنه يحمل في معناه القصي شحنة غاضبة ... يتضمن محاكمة جادة للتاريخ ... يطوي لهب النفس ، التي تدرك حقها من شبق الأيام ، ولكن ضمير المجتمع القاسي طمر هذا الشبق في ذمة المستحيل ... و لا يفوتني ان أقول ، ان من علائم الشاعرية المبدعة ، التزاوج بين اللغة الهادئة و المعنى المشحون بالغضب ، ظاهر فاتر وباطن هائج ، انه أشبه بمنطق الهدوء الذي يسبق العاصفة ، أنه المنطق الذي يشنج المشاعر ، ويحيل الترقب الحذر الى وقع مستبد بكل الحواس ، و قد يستضيف الفكر الى مائدة الجحيم الأبدي ... و ديوان عدنان الصائغ الأخير يمتاز بالهدوء اللفظي القابض على جمرة من نار .
الإسكافي ... الرصيف ... الصندوق ... الناس ... النظر ... السير ... كلها حقائق موجودة ... أشياء و ظواهر ملقاة هنا و هناك ... تظهيرها لا يحتاج الى اللغة ...ولكن دمج كل هذه المثيرات في مركب جديد ، من شأنه أن يؤسس عالماً آخر ، له مغزاه الذي يتعدى المفردات ، و يعلو على الوصف اليومي المألوف ... هذه المهمة تحتاج الى لغة جديدة ... لغة من نوع آخر ... تنتقل بالاسكافي من إنسان يتعامل مع الحذاء ، الى متأمل يطوف على بحر أيامه ، يسألها و تسأله عن مغزى هذا العمر النكد ...لقد تنازل الزمن من عليائه في هذا التوقيع الشعري ، الزمن في الحس العادي يسوق الحياة ، قدر سابق ، يلوّن المصير بريشته و كلماته ، فيما التوقيع الشعري يحول الزمن الى كائن مستلب [ ... لأيامه التي ينتعلها الناس ... ] .
الشعر لغة في جوهره ... هذه حقيقة من الصعب انكارها ، ولكن اللغة ليست إلهاً ، و لا هي جوهر مفارق ، ولا مثل افلاطونية ، فلو لم يكن هناك واقع لم تكن هناك لغة ، ولم يكن هناك فكر أو فن ، ان ذاتية النص الميتافيزيقية حقيقة مشتقة ، من الدلالة و الموسيقى ومجموع العلائق السائدة في داخله ، ولكن كل ميتافيزياء تملك جذوراً خارج مملكتها المجردة ، واعتقد ان التعامل مع النص الشعري ، كمشهد لغوي صرف ، ناتج من استغراق باطني كلي في ظاهر اللغة ، في ألفاظها وحسب ، أو في بحر الدلالة فقط ، و هناك شبه تعامي مقصود أو مصطنع عن المدلول ،
ان أصحاب هذه الرؤية يتحاملون على الواقع بكل أنحائه ، يتغافلون التجربة الانسانية الكبرى ، بما فيها تجربة الشاعر.
أن النص الشعري ينطلق من الواقع كمحفز ... مثير ... باعث ... ثم يعود الى الواقع بهوية جديدة ... هوية ناقدة ... هوية فاحصة ... هوية ضوئية ... رؤية تطل على الواقع كي تزيل حجب الإضافات الجدبة ... و تجلي روح الأشياء ... فالعلاقة بين النص والواقع جدلية حية ...النص حاضر في عمق الواقع و الواقع حاضر في عمق النص ... كلاهما يحتضن الآخر ... يغذيه... يشحنه ... على ان هذا الحضور ليس محاكاة ، بل هو حضور غني ... يسفر عن أغناء متبادل ... ونحن نحتكم في هذه القضية الى الوجدان ... فنحن نرى ، ان الشاعر يتأمل هذا لوجود ، ينقب في طبقاته ، يرصد تقلبات الحياة ، يسجل في ذاكرته الساخنة جديد الزمن و ما يبلى ، يحلل ما يقع وما يغيب ، و نتاجه الشعري لا ينفصل عن سياحته المضنية هذه ، و شعره يلهم و يبني و يغير و يهدم ، ولذا كانت الصورة الشعرية خارجاً وداخلاً ، ليس نسقاً منعكفاً على نفسه ... منغلقاً على جمله ... لذا لا نستبعد القول ، من أن الشاعر الذي يحتك بأشياء الحياة اليومية ، أكثر إبداعاً من غيره ... تتكاثر في نصه الصور ...وتحتشد في صوره المحفزات ... وتتولد من محفزاته الأمنيات والأهداف ...
الشاعر عدنان يلاحق جزئيات الحياة اليومية ...
يقول :
[ على رصيف شارع الحمراء
يعبر رجل الدين بمسبحته الطويلة
يعبر الصعلوك بأحلامه الحافية
يعبر السياسي مفخخاً برأس المال
يعبر المثقف ضائعاً
بين سوهو وحي السلم
الكل يمر مسرعاً ولا يلتفت
للمتسول الأعمى
وحده المطر ينقّط على راحته الممدودة
باتجاه الله ]
هذه قضية يومية ... مفرداتها الأولية ملقاة على الطريق ... جاء الشاعر ، ودمجها في مركب كوني جديد ، انتقل بها من الانتشار العفوي إلى البناء المحكم ، الذي ا رتفعت به ، نحو أفق آخر من التكوين ، وهو أفق لا ينتمي الى المتداول المشترك ، فليس غريباً إذا كان المتعاملون مع هذا العالم نادرين.
الكلمة بالنسبة للشاعر فردوسه الذي يحميه ويحامي عنه ، يلجأ إليها و يدافع عنها ، العلاقة بين الشاعر والكلمة ليست علاقة بين ذات وموضوع، بل علاقة مصيرية .
يقول عدنان الصائغ :
[الرقيب الذي في الكتاب
ظل يلتهم الكلمات
السطورَ
الحروفَ
الفوارزَ
حتى تكرش من كثرة الصفحات
وغاب
إلهي .....
ما الذي سوف أفعله
ببياض كهذا
البياض حجاب ]
انها ثورة مزدوجة ، ثورة الشاعر و الكلمة ، في آن واحد ، لان العلاقة بين الأثنين مصيرية، علاقة عشق أزلي ، فهما يعيشان معاً و يموتان معاً ، ومن هنا كان محتكرو الكلمة اكثر ما يخيفه في هذه الحياة ، فهؤلاء يقمعون ... يثيرون tي داخله الخوف ... يجعلونه يمشي و هو يتحسس كلمة [ ... قف ...] ... تلاحقه و تطوقه و تسبقه ، فيصاب بالهلع ، وربما يقوده ذلك الى التهلكة من دون ان يشعر . أن احتكار الكلمة ، وخاصة الكامة الدينية ، يقود إلى اختصار الحياة بكل ما ترفل به من معان عميقة و آفاق عريضة ، وفي تصوري ان الشاعر المبدع هو الضحية الأولى في مجتمع يسيطر على مقاليده محتكرو الكلمة ، لان هؤلاء يقتلون الشاعر من الداخل ، و إذا كان بامكانه ان يصرخ في وجه الجاهل العادي ، أو المغرر به ، أو معبود السلعة ، فإنه محروم من هذه [ النعمة ] تماماً ، إذا سيطر قتلة الكلمة على المجتمع و الحياة والموت ، فإن هؤلاء يقمعون الحرية حتى على مستوى التأمل ، مما يجعل الشاعر محاصراً ... مقموعاً ... مختنقاً ... و قد يدخله هذا في عالم الهذيان ، فإن الكلمة تضغط عليه ، و القمع يمنعه ، فتتقاطع الخطوط و تتصالب الضغوط ، فينتج انسان معتوه ، و المسؤولية تقع على عاتق محتكري الكلمة. يقول الله تعالى [ وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغ مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون ]
أستجارك : أستأمنك من ا لقتل.
مأمنه : ديار قومه .
هذه الأية الشريفة تقطع الطريق على محتكر الكلمة ، مهما كانت منزلته وقيمته الاجتماعية و الفكرية و الدينية ، و اعتقد ان بلوغ المأمن هنا ينطوي على حرية الكلمة ، واعلاء من شأن المغدور و المظلوم ، مهما كان دينه وجنسه ، لان القضية لا تتعلق بموضوعة الهوية بقدر ما تتعلق بقانون عميق ، تتوقف عليه سلامة الوجود و تطهيره ، ذلك هو الصراع الفكري [ أما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ...] ...فالكلمة لها موقعها الجوهري من ساحة الحياة ، بل قد تكون هي منطق الحياة ونبضة الوجود ... و لهذا يدافع الشاعر عن الكلمة .
كلمة الشاعر تجتاز مراحل ولائدية مضنية ، تنتقل من عالم الى آخر ، ومن خلال هذا العروج الشاق ، تكتسي كلمة الشاعر و تتعرى ، تتخلص من اضطهاد التقرير ، و تتحرر من سجن التاريخ المنسوخ ، وتكتسي شفافية الأفق غير المنظور لذوي المشهد البصري الحسير ، ممن استوى في تجربته ظاهر الأشياء و باطنها ، تمضغه سكك الطريق اليومي ، لتلفظه على حافتها البعيدة ، خوفاً من اقتحام عشاق المغامرة الوجودية الكبرى .
كلمة الشاعر تتمرد على العرف اليومي ، فتصبح رمزاً ، فتموز ليس شهراُ معدود الأيام ، بل هو العطاء و ا لثورة والخصب والنماء ، هو الأمل المنتظر، و الوعد الذي يقلب دورة القدر الراكد ، ، ولكن الشاعر المبدع ، قادر على تنشيط الرمز ، يمنحه شعلة الوجد الكوني ، على مستوى يتجاوز الفضاء الدلالي ، حيث يتحول الى رؤيا ...
الرؤيا أعمق من الرمز...
الرمز ينقذ الكلمة من العيانية ... من المباشرة ... من التماهي الصلد ... الرؤيا تحول الكلمة الى فلسفة ... فالرؤيا ارتقاء روحي للرمز ... الرمز أُفق والرؤية عمق ...
يقول:
[ أنت تمضي أيها المستقيم
دون ان تلتفت
لجمال التعرجات على الورق
انت تملك الوصول
وأنا أملك السعة ]
هذه الكلمات هندسية ، تنتمي الى عالم الحس المنغلق ، تذكّر بالمسطرة والفرجال ، ولكن هوس الشاعر بالحياة الصاخبة منحها شبق التخطي ، أطلقها من قيودها الكابحة ، ثم غاص في قلبها ، ليشعل فيه ألق التجربة الطافحة بكل رغبات الحياة ...فكانت الرؤية الرمز مخلوق نزق ، يتغلغل بين مفردات الوجود ، ليجمع شتاتها ويوحد أطيافها ، ولكن الرؤية اشراقة تنقدح من تصاهر الضمير والكون ، اشراقة تخطف البصر لتضيفه الى رصيد البصيرة ، وتجرف البصيرة لتصهرها في ملكوت الشهود ...
المستقيم ... أقصر خط بين نقطتين ... هكذا يقولون في علم الهندسة ... ولكن في المرحلة الأولى من معراج التحول الشعري رمز للبعد الواحد ... للروتين ... للصلابة العمياء ... اما في الرؤية... أي في قمة التحول الشعري ، يتحول المستقيم الى إحالة تجسد المأساة والاختناق ... يتحول الى موضوعة تمثل الرعب ... بل هو الرعب مباشرة !
|