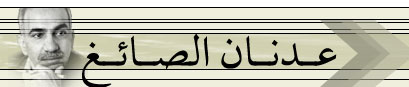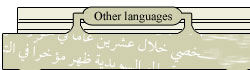|
خصائص الشعر الثمانيني العراقي
محمد مظلوم - دمشق -
ينفرد الوسط الثقافي العراقي ـ الشعري تحديداً ـ بتقاليد وخصائص وأخلاقيات لا يكاد يشبهه فيها أي وسط ثقافي عربي آخر، من بين تلك الخصائص تبرز مسألة الأجيال الشعرية كإحدي أهم صور العلاقة بين قصيدة وقصيدة، بين شعر وشعر، وبين رؤيا وأخري، لذلك فقد استولدت عن مصطلح الأجيال مصطلحات اشتقاقية دخلت راهن النقد الأدبي في العراق.
ولم يكن مصطلح الأجيال وارداً أو متجذراً في الشعر العراقي ونقده، فلم يكن الشعراء ينسبون إلي عقد معين، بل ما كان معروفاً هو إلحاق الشعراء بتيارات ومدارس شعرية ـ التقليدية أو الرومانسية أو سواهما ـ لا إلي جيل عقدي، بل أن شاعرين مثل الجواهري والحبوبي قد ينسبان إلي تيار شعري واحد هو الكلاسيكية الجديدة رغم أنهما لا ينتميان إلي جيل شعري واحد أو إلي عقد زمني معين.
فمن أين جاءت هذه التسمية: (جيل) للشعر العراقي؟
ومن هو ـ بين الأجيال ـ مرتكبها الأول؟
قبل أن نلاحق مفردة جيل وما تذهب إليه من معان لغوية أو اصطلاحية من المهم أن نشير إلي ارتباط مصطلح جيل بالشعر من دون سواه من الأجناس الأدبية الأخري من جهة، وارتباطه من جهة أخري بالعقد أو التقسيم الشعري تعبيراً عن البعد الزمني للمصطلح.
ومع أن النقاش لم يحسم ـ وأظنه لن يحسم ـ في ما يتعلق بالاتفاق حول المصطلح، إلا أن الواقع يشير إلي أنه قد جري تثبيت المصطلح في الغالب من الكتابات النقدية الحديثة التي تشتغل علي الشعر العراقي الجديد.
لغوياً: جاء في لسان العرب تحت مادة جول الجيل: كل صنف من الناس، الترك جيل والصين جيل والروم جيل، وقيل: كل قوم يختصون بلغة جيل .
وزمنياً: حدد ابن خلدون الجيل بأربعين سنة جاء في المقدمة الجيل هو عمر شخص واحد من عمر الوسط فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلي غايته .
إذن كيف تهيأ لهذه المفردة أن تخرج من كونها تمييزاً لصنف من الناس، إلي تخصيص مجموعة من الصنف (الشعراء) وتقسيمهم إلي أجيال؟ ولماذا اختزل الزمن الدلالي للمفردة من أربعين سنة ـ كما عند ابن خلدون ـ إلي عشر سنوات ـ كما هو حادث في الشعر؟
كانت فترة الستينيات في العراق أرضاً أولي لإنبات هذا المصطلح (في العراق جيل شعري، وفي مصر جيل قصصي).
وهي فترة نشاط سياسي في العراق امتد في حمي التعدد الآيديولوجي الذي ولد صراعاً مريراً انعكس علي مجمل التاريخ السياسي للعراق لاحقاً، فحلت عقلية الإلغاء والتهميش والمحو، بدل عقلية الحوار وحرية الاختلاف، سادت الإبدالات وانسحبت المقترحات، لذلك كان الجيل صورة أخري من صور الكتلوية في مجتمع لا مكان فيه للفرد بفرديته، ولا ينظر إليه خارج كونه ملحقاً بأصل (الجماعة) ولا إطار له خارج هذه الجماعة وبمختلف تسمياتها.
ولعل مجلة الكلمة (أصدرها حميد المطبعي وتولي تحريرها موسي كريدي) هي أول مجلة ارتبطت بمرحلة الستينيات كمشروع ونشرت نتاج شعراء هذه المرحلة، وأطلقت عليهم اسم: جيل الستينيات. أيضاً شهدت الستينيات صورة أخري في صور الكتلوية الشعرية اتسمت في ما اصطلح عليه جماعة كركوك فاضل العزاوي، مؤيد الراوي، سركون بولص، صلاح فائق، أنور الغساني، الأب يوسف سعيد، وجان دمو) كذلك مشروع مجلة (شعر 69) رغم قصر فترة صدورها. إذ يلاحظ ـ بدءاً من اسمها ـ ارتباطها بالمرحلة الزمنية من جهة وتأكيدها علي أسماء الشعراء الستينيين من جهة ثانية، وكذلك تصديها ومساءلتها للرؤية التقليدية للشعر.
وكان (البيان الشعري) الذي كتبه فاضل العزاوي ووقعه معه الشعراء سامي مهدي، خالد علي مصطفي وفوزي كريم، أوضح صورة لانشطار القبيلة الستينية حيث تجلي في الاختلاف حول ما تضمنه البيان الشعري وكان هذا تمهيداً لانشطارات تالية ستصبح فيما بعد سمة أخري من سمات النشاط والإنتاج الشعري في العراق.
لم يقف مصطلح الجيل الشعري عند حدود التصنيف التاريخي لجماعة ما، بل تعداه إلي تصنيف نوعي داخل الجماعة نفسها، وهو ما أوجد جدلاً علي أكثر من اتجاه بين السابق واللاحق، بين الحالي والتالي من جانب وبين اتجاه وآخر في الراهن نفسه، بين معلنه وكامنه، وكذلك بين امتدادات وانعطافات، تقاطعات وتوازيات داخل الجيل الواحد.
هنا لابد من الإشارة إلي أن الجدل القائم بين الأجيال أخذ منحي إبدالياً لا اقتراحياً، متأثراً بجدل الأيديولوجيا، بمعني أن كل جيل يأتي ليعلن عن نفسه بديلاً لما سبقه. ولا تشرق شمس أبديته إلا في غروب وانمحاق شمس السابقين، كان الستينيون أول من ارتكب هذا الخيار القاسي الذي سترتد قسوته عليهم مع الأبدية السبعينية!
مع السبعينيات، أخذ الصراع الأيديولوجي يتعمق أكثر، داخل الوسط الثقافي، منطلقاً من مقولات الاختلاف الستينية، متجدداً في كل ما يرسخ الخلاف، خالقاً ـ في الوقت ذاته ـ خيارات معزولة عن بعضها، وعازلة عن سواها، مجذراً ثنائية الصراع الستيني بما يؤصل هذا الصراع ويجعل منه علامة أخري في تاريخ القسوة.
كانت الجماعات أو التكتلات، داخل الجيل الواحد، (في الستينيات والسبعينيات) تمثيلاً لنزوع أيديولوجي ونفسي أكثر من كونها كناية عن اختلاف في الرؤيا الإبداعية أو في الافتراضات النصية.
من هنا بدأ التياران السياسيان الرئيسيان في العراق القوميون والماركسيون يجذران النظرة الكتلوية للإبداع وصار لكل منهما شعراؤه الذين يتبناهم، ويروج لقصائدهم ويبشر بهم كتيار!
ومثلما انشطر الستينيون شيعاً وقبائل، وتفرقوا في مواقع شتي، انشطر ـ تناسلاً عنهم ـ شعراء السبعينيات الذين كان أول ظهور جماعي لهم في العدد الثالث من مجلة الكلمة ـ أيار 1973 وتحت تسمية (ما بعد شعراء الستينيات) وفي العدد الخامس ـ أيلول (سبتمبر) 1973 تنشر الكلمة ذاتها (دعوة لكتابة القصيدة اليومية، تحويل الحلم الفردي إلي حلم جماعي)، وقد وقع الدعوة ثلاثة شعراء سبعينيين هم: غزاي درع الطائي، خزعل الماجدي، وعبد الحسين صنكور.. كانت الدعوة بياناً مبتسراً، سريعاً وقصيراً يكشف عن تسرع في الإعلان، أكثر مما يكشف عن وعي حقيقي للاختلاف، ولو قورن هذا البيان بالبيان الشعري لجيل الستينيات لبدا الأول مضحكاً حقاً، فقد جاء مخالفاً لا مختلفاً! وكأنه مكتوب بردة فعل علي مقولة (الكون المهجور) ومقولة (الحلم الفردي) اللتين ركز عليهما الستينيون في تعريف رؤيتهم الشعرية للعالم، فوضع السبعينيون في بيانهم مقولتي (اليومي) و(الحلم الجماعي) بإزاء مقولتي الستينيين.
وإذا كان الصراع (الداخلي) بين الستينيين ذا طابع أيديولوجي فإن صورة هذا الصراع قد خفتت نوعاً ما بين الستينيين والسبعينيين، بفعل الفراغ السياسي الذي انتهت إليه الحياة السياسية في العراق تحت سلطة الحزب الأوحد، وبذا حسم الصراع الأيديولوجي بالعنف والقسوة، وكان لذلك انعكاس علي الثقافة في الداخل، لتتغير آليات الصراع بين من بقي، في الداخل، من شعراء ستينيين وسبعينيين، وتنصب مفرداته ـ الصراع ـ حول استئثار الستينيين بالسلطة الثقافية، واستحواذهم علي المراكز والمناصب الثقافية في المؤسسات، وتفردهم ببطاقات الطائرات وحقائب السفر والمهرجانات والفنادق الضخمة!
ولا بد من الإشارة هنا إلي أن السلطة كانت تراقب هذا الصراع وتغذيه ـ أحياناً ـ لأنه يضمن لها شكلاً من أشكال النظرة الفئوية تعوض بها غياب المشروع السياسي الآخر من جهة، وما يمكن أن يوفره هذا الصراع من مساحات لتطهير وامتصاص الفورة والرفض لما كان يجري آنذاك.
زمنياً ولد أغلب شعراء السبعينيات في الخمسينيات، بينما ولد أغلب شعراء الثمانينيات في النصف الأول من الستينيات، وعملياً كان فارق العشر سنوات في العمر، بين جيل وعقبه، يستدعي صيغاً شعرية جديدة تبعد بمسافة أبعد مما توفره السنوات العشر. وإبداعياً، يمكن القول إن الستينيين، والسبعينيين كذلك، ولدت تجاربهم في ظل صراع سياسي لم يعشه الثمانينيون الذين ولدوا جنوداً! إذ أن بداية تجربتهم الشعرية ترافقت تماماً مع تجربة دخولهم الحرب.
لم يعلن الثمانينيون أنفسهم جيلاً في البداية، ولعلهم يمتازون عن الجيلين السابقين بأنهم لم يصدروا أي بيان شعري، كما لم يكثروا الادعاء عن منجزات ومشاريع شعرية، لكنهم كانوا كثيري الكتابة والمغامرة حياة وشعراً، كثيري التحاور والقراءة، قليلي النشر والتنظير.
ومع ذلك، فقد ظهر كثير منهم في صيغ الملف الشعري الفردي، أو الجماعي من خلال مجلة الطليعة الأدبية التي قدمت معظم، إن لم نقل جميع، شعراء الثمانينيات وترافقت مع تلك الملفات، أحياناً، شهادات فردية لبعضهم تمثل فهمهم لإشكالات الحداثة، التراث، القصيدة، اللغة الشعرية، وسواها. هذه الشهادات تعبر ـ علي كل حال ـ عن رؤيا خاصة لما هو قائم من أسئلة في الحوار الثقافي.
كانت التيارات داخل شعر الثمانينيات ظاهرة أخري للتعدد والتنوع، فقد كانت هذه التيارات، وتكتلاتها وجماعاتها، تشهد صراعاً وتنافساً في ما بينها، أكثر مما شهدته الصراعات بين الأجيال.
وفيما كانت الصراعات في تيارات الأجيال السابقة تنطلق من أرضية سياسية بالأساس، فإن تيارات شعراء الثمانينيات اختلفت وتقاطعت في محيط الشعر، والثقافة، والرؤيا إلي العالم، والإنسان والأشياء.
ولهذا نجد عدداً من الشعراء، غير الموهوبين من هذا الجيل، قد استفاد من آليات الصراع السياسي السابق ليرتبط بمركزية المؤسسات الثقافية عن طريق تقليد النموذج المؤسساتي المروج له ـ الخمسيني والستيني ـ فيما انشغل القسم الآخر (الموهوبون) في تصعيد المغامرة إلي أقصاها، والانعطاف بعيداً عن الموروث الشعري المؤسساتي، والسائد في التراكم الكمي للشعر، محققاً بذلك قطيعة علي مستويين مع السابق.. المستوي الأول: شعري يكمن في تمثل تجربة السابق وهضمها دون الامتثال أمامها أو إعادة تمثيلها، وذلك بتجاوز أخلاقياتها ومنجزاتها (مع نقدها ومساءلتها). والمستوي الثاني: تحقيق نوع من الاحتجاج علي الخطاب الثقافي المتماهي في السلطة والذي يمثله عدد من شعراء السابق.
وبعد أن ترسخت بعض أسماء الثمانينيات في الوسط الثقافي، أصدرت مجلة الطليعة الأدبية كتاباً شعرياً أقرب ما يكون إلي أنطولوجيا الشعر الجديد في العراق وتحت عنوان لافت (الموجة الجديدة ـ نماذج من الشعر العراقي) 1975 ـ 1986 وقد ضم الكتاب قصائد لـ 51 شاعراً ظهروا خلال تلك الفترة وينتمون إلي عقدي السبعينيات والثمانينيات تحديداً.
ويلاحظ في عنوان الكتاب الذي أعده شاعران سبعينيان (زاهر الجيزاني وسلام كاظم) ومن المقدمة التي كتبها الأول أن إشكالية الأجيال وصلت إلي اتجاهات جديدة جعلت المشهد الشعري حاداً وغير محتمل لحساسيات إضافية تنجم عن تصنيف شعراء الكتاب إلي جيل معين، خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من شعراء الكتاب من الثمانينيين الذين لم يعلنوا أنفسهم بولاء أحد، ولهذا كانت تسمية (الموجة الجديدة) ـ وهي حصيلة آراء عدة ـ تعبيراً عن وجود توجه شعري جديد.. يحمل معه العديد من ممكنات الزوال أيضاً!
وبالفعل لم يسفر اندفاع الموجة الجديدة بشعرائها الـ (51) إلا عن دفق شعري محدود مثلته نماذج شعرية محددة (السبعينيات والثمانينيات) كان واضحاً أنها تملك مؤهلات لدفع الشعر العراقي نحو فضاءات أخري.
لم تكن الثمانينيات فترة عادية في تاريخ العراق الحديث، كانت عقداً محتدماً ومحتداً في آن واحد، وكان شهوده وأبطاله يفترقون إلي الموت أو إلي الجنون أو إلي الشعر. وسيجد الدارس للأدب العربي ـ لاحقاً ـ أن هذا العقد كان بداية لإعادة المساءلة الحقيقية حول ما بقي بحكم الثوابت في الثقافة العراقية خاصة والعربية بصورة عامة. وتتجسد أشكال المساءلة في ما نتج من أدب شعر وقصة تحت وطأة وقائع أخري لم تكن مألوفة في التاريخ الشخصي الحديث للأديب العراقي. غير أن هذه الفترة لا يمكن تجييرها لصالح جيل معين دون سواه، فمن بقي من شعراء داخل العراق من جيلي الستينيات والسبعينيات ـ بعد انشطار الجيلين إلي داخل/ خارج ـ دخلوا النفق الثمانيني الذي ولد فيه جيل شعري لم يكن في ولادته أو سيرته وحتي نضجه يشبه أي جيل شعري عراقي آخر.
لقد رأينا كيف كان للستينيين أكثر من منبر ثقافي، أعلنوا من خلاله أنفسهم، ونشروا نتاجاتهم، وكانت لهم صراعاتهم المعلنة والواضحة، وايديولوجياتهم وأحزابهم التي تبشر بهم وكذلك كيف كان للسبعينيين آباؤهم وأعداؤهم، من الستينيين. كانت علاقة السابق باللاحق، إذن، علاقة إلغاء وإقصاء، لا حوار وجدل، وعلاقة السابق بتفرعاته علامة تطفل.
لم يكن التأمل وارداً لدي أي من الطرفين وهو يقرأ الآخر، ما كان وارداً هو الصراع الأوديبي متغذياً، هذه المرة من عقد الأيديولوجيا!
وعندما وجد الشاعر الثمانيني نفسه ـ إزاء مصيره وهو يقف علي جبهات القتال ضد إيران ـ مدفوعاً لا مختاراً ـ انهارت أمام عينيه كل الأسئلة وبقي السؤال الوحيد والأهم سؤال الوجود: الموت، لهذا فلم تكن أزمته مع خارج معلن فحسب، بل كانت أساساً، مع ظلام غامض يكاد ينط من أعماقه لحظة وقوفه علي الساتر الترابي عندما تشتد المعارك أيام الهجوم، لهذا فما عاد نصه أنين الأنا المأزومة بفعل انوجادها في محيط ضاغط فحسب، بل صار جزءاً من المواجهة الأزلية لهذه الأنا لمصيرتها وحقيقتها.
يكاد الجيل الثمانيني الوحيد الذي لم ترافق ولادته ضجة أو إعلان، كما حدث مع الجيلين السابقين، فكأنه كان ابن سوء، غير مرغوب فيه، ولذلك سيجد الكثير من شعراء هذا الجيل في عقده يوسف رمزاً شعرياً ينضاف إلي حشد كبير من الرموز الشخصية والجمعية شكلت ديباجة واضحة في شعر الثمانينيات (ذلك أنها منبثقة من الشعر وهمومه ومتجهة إليه في الوقت نفسه).
كما تمتاز الثمانينيات عن الستينيات والسبعينيات في أنها لم تشهد نشاطاً سياسياً آخر! بمعني غياب الصراع الأيديولوجي بسبب الهجرة السياسية وإفراغ الساحة (للون الواحد) وما أعقبها من حملات سنة 1978 ضد الشيوعيين مما ولد غروب الوعي السياسي لدي الجيل الذي كان يتشكل آنذاك.
الميزة الأخري لعقد الثمانينيات استبدال نمط الصراع بين المثقف والسلطة، فبعد أن كان صراعاً بين مؤسستين من جهة، وبين الأفراد مع المؤسسة التي ينتمون إليها، وهو في كل الأحوال صراع له تقاليده!
ذلك أن المثقف ـ والشاعر تحديداً مندرج في هذا الصراع ـ بين المؤسسة والمؤسسة الأخري ـ تحت لافتة مؤسسته، شاء ذلك أم أبي بفعل طبيعة الصراع التي تقتضي نوعاً من الخانات الخاصة، أكثر من ذلك، كانت المقاهي، والبارات، وسواها من الأماكن، تؤدلج أصحابها وتكتسب هي هوية سياسية حسب طبيعة توجهات روادها. بعد هذه التقاليد من الصراعات السابقة! وجد الشاعر الثمانيني نفسه منفرداً وأعزل إزاء مؤسسة حسمت الصراع واختزلت الاشتقاقات بصياغة واحدة ووحيدة، لا تدع فرصة لمساءلتها، فإما التماهي فيها حد الانمحاء أو الابتعاد عنها حد التلاشي، أو مواجهتها حد الانمحاق!
ومثلما وجد نفسه وحيداً إزاء مصيره في جبهات القتال، فإن وحدة الشعر في الثمانينيات ـ أعزل هذه المرة! ـ استمر في مواجهة المؤسسة التي تمتلك أقنية ترويج الثقافة وتوجيهها في حدود معينة، أو قطع الروافد المبتكرة للتواصل التي يجهد في إيجادها عدد من الشعراء ممن اختاروا الخروج من دائرة النشر المؤسساتية في البلاد نحو دوريات عربية لم يكن مرغوباً فيها داخل العراق.
غير أن هذا لا يعني أن شعراء الثمانينيات لم يحققوا وجوداً في الدوريات والصفحات الثقافية في العراق، بل أوجدوا اختراقات واضحة أمكن خلالها العبور بنصوصهم، إلي جانب قصائد لشعراء مكرسين في المؤسسة الثقافية، مستفيدين بذلك من خلال ما يمكن أن نسميه نوعاً من التواطؤ مع نصوصهم من قبل بعض المحررين في المجلات الثقافية ـ الطليعة الأدبية خاصة وكمال سبتي وزاهر الجيزاني تحديداً ـ مما سوغ تمرير احتجاجات كامنة في كثير من النصوص التي سيستغرب القاريء لها بعناية من كيفية مرورها ـ بما تحمله من ألغام! ـ وسط محبسات رقابية متيقظة دائماً. بل إن عدداً من شعراء الثمانينيات أشرفوا بأنفسهم في إحدي اللحظات النادرة ــ علي تحرير عدد خاص بالشعر العراقي في الثمانينيات (عدد أسفار المزدوج 12/11/ في عام 1989).
ورغم أن كلمتي رئيس التحرير (عدنان الصائغ) ومدير التحرير (جواد الحطاب) لم تشر أو توحي لا من بعيد أو من قريب ولا بأي شكل من الأشكال إلي فكرة أن هذا العدد هو أول أنطولوجيا للشعر العراقي في الثمانينيات كما لم تؤكد كلمة رئيس التحرير علي قصيدة النثر التي احتلت أكثر من نصف قصائد العدد فيما لم تنشر المجلة في أعدادها السابقة قصائد نثر. ومن هذا فإن عدد أسفار 11 ـ 12 كان بصفحاته الـ (272) مخصصاً للشعر الثمانيني حيث اشترك فيه 35 شاعراً وأربعة نقاد ناقشوا تجارب عدد منهم، إضافة إلي شهادات لثمانية شعراء من الثمانينيات، جاورتها آراء وحوارات لثلاثة شعراء سبعينيين. وسيحتاج هذا العدد إلي وقفة خاصة لأهميته لناحية كونه أول أنطولوجيا موسعة. وتكاد تكون شاملة ـ للشعر الثمانيني من جهة ولما يفرزه من قناعات ستوفر مناسبة جيدة لرصد وتمييز المختلف، عن السائد في ما نشر من نصوص أو آراء.
كانت مغامرة أسفار وما ترافق معها من أمسيات دورية في منتدي الأدباء الشباب عن قصيدة النثر وتحت عنوان شامل (حوارية المختلف/ النص الجديد والتلقي) هي أهم نشاط جماعي لجيل الثمانينيات قبل أن تتدخل السلطة مرة جديدة، في تغذية صراعات ومعارك عصفت بتجربة قصيرة لمجموعة من الشباب داخل منتدي الأدباء الشباب ومجلة أسفار. إلي ذلك كانت آخر تجربة مهمة قبل أن ينعقد ملتقي الشعر الثمانيني الذي بقي مؤجلاً عدة سنوات ولم يعقد إلا بعد انشطار الجيل الثمانيني إلي داخل وخارج، إذ لم يشترك في هذا الملتقي عدد من أبرز الأصوات الشعرية في الثمانينيات لخروجهم من العراق قبل وقت قصير من انعقاد ملتقي الشعر الثمانيني الذي أقيم في أواسط أيلول (سبتمبر) 1992.
خلال فترة الثمانينيات برزت ثلاثة اتجاهات شعرية يمكن بها تلخيص توجهات القصيدة الجديدة في العراق من الناحية الفنية والتقنية:
الاتجاه الأول: ما يمكن أن نصفه بتمثيل التطور الطبيعي في سياق تحولات الشعر العراقي، منطلقاً من جيل الرواد واحتمالات قصيدتهم ـ السياب خصوصاً ـ مستفيداً من التجارب المغامرة لدي الأجيال الشعرية اللاحقة ما بعد الرواد والستينيات والسبعينيات.
وأبرز ممثلي هذا التيار عبد الحميد الصائح ومحمد تركي النصار وخالد جابر يوسف وأحمد عبد الحسين وصلاح حسن وكاظم الفياض وكاتب هذه السطور.. وتميز شعراء هذا التيار بإطلاع جيد، وتواصل مع التراث العربي مقروناً بانفتاح علي الثقافة العالمية، ويظهر ذلك في نصوصهم حيث التداخل النصي والتمثل المعرفي والرؤيا الشاملة المستخلصة من تفصيلات الحياة وتجربة الحواس اليومية والشخصية، ومن الملاحظ هنا إن هذا التيار امتلك بقدر كبير مواصفات إحداث انعطافة في الشعر العراقي لناحية توفر شرطي عمق الثقافة التراثية وقابلية الانفتاح علي الآخر، بالتزامن مع شرط أخر مهم جداً وهو الشرط التاريخي الوقائعي المختلف.. أعني تفاعلات الحرب العراقية الإيرانية وهو شرط متوافر لجميع الأجيال الشعرية العراقية التي كتبت خلال تلك الفترة.
التيار الثاني: هو تيار قصيدة النثر بأنموذجها الوافد من الثقافة الفرنسية معدلاً بتجارب عربية في بلاد الشام خاصة لدي محمد الماغوط وأنسي الحاج، ومن أبرز من مثلوا هذا التيار في جيل الثمانينيات، نصيف الناصري وباسم المرعبي وناصر مؤنس والمرحوم رياض إبراهيم وحكمت الحاج وسعد جاسم وزعيم النصار وعلي عبد الأمير، ومن الملاحظ لدي شعراء هذا التيار ندرة التجارب الإيقاعية لديهم، بل إن بعضهم لم يكتب بها مطلقاً، لعدم معرفته بالعروض أحياناً ولرفضه الشكل الإيقاعي جملة وتفصيلاً أحياناً أخري. وهو تيار كان له حضوره خلال الثمانينيات قبل أن تشهد تجارب بعض شعرائه تبدلات لاحقة خاصة بعد خروجهم من العراق.
تتسم أشعار هذا التيار، بانشغال فائض بالمفردة وتأنيقها، وخلق كيمياء لغوية من خلال تصادم المفردات، مما يجعل الصورة في قصائدهم غائية، ومنشودة اكثر من كونها صفة عضوية داخل النص وتجربة الشاعر فيه.
الاتجاه الثالث: ما يمكن أن نعده منحازاً إلي التجارب المحافظة في الشعر العراقي: ومن أسمائه عدنان الصائغ وعبد الرزاق الربيعي وعلي الشلاه وفضل خلف جبر وأمل الجبوري ودنيا ميخائيل، وبالرغم من إن بين هؤلاء من كتب القصيدة خارج الإيقاع (دنيا ميخائيل وأمل الجبوري) إلا أن طبيعة قصائدهم ظلت أسيرة تقنيات متوارثة، وملتزمة بنمطية في الصورة الشعرية وطبيعة اللغة ومستواها، والبناء العام داخل النص، ولأكون منصفاً تماماً فإن تجارب هذا التيار ظلت محافظة حتي في مواقفها تجاه ما كان يجري في العراق من أحداث سياسية. عكس شعراء التيارين السابقين.
هذا التصنيف لا يمكن أن نعده نموذجاً نهائياً لتحديد الشعر العراقي في مرحلة الثمانينيات لكنه بالتأكيد توصيف يعطي الانطباع الأوضح لما كان عليه الشعر العراقي آنذاك، وإن طرأت تبدلات علي طبيعة هذا المشهد لاحقاً، وضاقت المسافات والحدود بين هذه التيارات التي شهدت هي الأخري نزوحاً نحو أرض أخري.
عبد الحميد الصائح وقصيدة الرؤيا في الكابوس
منذ مجموعته الشعرية الأولي (المكوث هناك) الصادرة في بغداد في العام 1986، وهي من بين عدد محدود من المجموعات التي صدرت في تلك الفترة لشعراء هذا الجيل، بدا أن عبد الحميد الصائح ينتمي بقوة إلي سلالة الشعر العراقي متمثلاً تجاربه وحاملاً معه ارثاً ثقيلاً بأمراضه ومشكلاته وبقدرته علي التجدد أيضاً من هنا سيكون واحداً من توجهات الشاعر في مواصلة مسيرته هي تنقيح نصه كي يرث ويرثي في الوقت نفسه، أقول يرث بالنظر إلي إلزام قصيدته والتزامها حتي هذا الديوان بأصول القصيدة بناء وموضوعاً وعناصر متشكلة داخلها.
وشأن هذه المجموعة شأن بواكير الشعراء فقد جعلت من الموضوعات الصغيرة هماً كبيراً.. خلق فيها من مغادرته لمدينته الأولي الناصرية معادلاً موضوعياً لخروج سيكون لاحقاً خروجاً من البلاد كلها، كأنها مأخوذ بالخروج الأول من الرحم : المنفي الأول للإنسان، لكأنها كانت النبوءة أو لنقل المعرفة بمصير الإنسان في تحويله للمنفي البسيط إلي مفهوم مركب، تتعقد صيرورته كلما تقدم الشاعر نحو ذاته محللاً ومتسائلاً ومكتشفاً، وبهذا المعني لا يمكن النظر إلي هذه المجموعة من ناحية موضوعاتها إلا بوصفها تمثلا أولياً لرؤيا ستنضج لاحقاً حين يعززها الشاعر بتجربة ثرة ووقائع شبه أسطورية رغم واقعيتها الواضحة أعني بذلك التجربة المركبة من الحرب والمنفي.
كانت احتمالات قصيدة السياب إذن هي البوصلة التي وضعها الصائح أمامه من بين عدد من مجايليه، ولذلك ستبدو قصيدته اللاحقة ملتبسة لأنها لا تنتمي إلي الشكل القلق في الشعر العراقي في الثمانينيات ـ التجريبي لا علي مثال ـ ومن هنا أهمية تجربته برأيي لأنها تتواصل وتتقاطع في الوقت نفسه مع تاريخ القصيدة العراقية الحديثة، لن نصدف مثلاً هذا الاحتفال اللغوي المجاني باللغة التي قد تقول كل شيء وربما لا شيء في الوقت نفسه، بل تقول قصيدته شيئاً محدداً يعيه ويريده، علي بساطته وعلي اقتصاده في الجملة صورة وتركيباً وحتي إيقاعاً.
سنري ذلك واضحاً في تصديره للطبعة الثانية من المجموعة الصادرة في العام 1998:
أنا ابن السلالات عارية كالسراب
وريث المراثي وريث العواء
وريث الغياب.
وهو تلخيص نادر لمفهوم شعري تتركز المجموعة برمتها علي التذكير به وربما الاحتجاج عليه في الآن ذاته.
وبعد أن يكتمل الوفاء للأصل تأتي سريعاً مرحلة الهدم، هدم الوعورة التي تعيق الانعتاق من ظلال هذه الأصول، وهنا يكتب الصائح مسلسله عن ـ الركض ـ يريد أن يركض خارج وطأة هذه الظلال وأصحابها الذين ما عادوا قادرين علي صحبته وهو يلهث في وقائع تشتعل من حوله تحت ظلال الطائرات ونارها أيضاً! وفي زحمة أجساد لبشر فارين من ظلال موتهم هكذا سيبدو هذا الركض خياراً سوريالياً في دائرة مغلقة بعناية حياتياً وفنياً. لن يقطر المعني إذن بل يجعله يتدفق تماماً كركضه للمِّ شتات المشهد الآيل للزوال.
القصيدة الطويلة إذن كانت جزءاً من هذا الخيار، وبهذا لا يصح كما قلت في أكثر من مناسبة وصف ما كتبه الصائح ومجايلوه من شعر، بأنه قصيدة نثر، لا وجود للقصيدة في شعر الصائح إنه شعر فحسب، وتسميته قصيدة تأتي من باب المجاز ليس غير، ربما غادرها مع (المكوث هناك) ليأتي النشيد.. والصائح منشد واضح ليس بحجم القصائد الطويلة التي كتبها بل لوعيه لخصائص الإنشاد، ففي شعره حضور واضح للنداء والتوجه إلي خطاب الآخر حتي وإن كان غائباً، وكذلك التكرار القائم علي الجملة البؤرية كما سيتضح من تطبيقات لنماذج من شعره.
ويكتمل الإنشاد بالبناء الدرامي، فتحضر عناصر عدة داخل النص من قبيل المشهدية السوداء، والكابوس الضخم الذي يهيمن علي روح الشاعر، حتي يشكل فزعاً معهوداً لديه، يمرره إلي القارئ من دون أن يتطهر منه.
وقائع مؤجلة هي التمثيل الأدق لهذه المرحلة المكتظة بكل ما يجعل الشعر تعبيراً عن الفزع الإنساني إزاء المصير.
وهي من ناحية أخري تعود إلي معالجة الموضوع المرتبط بهذا الفزع، وهو موضوع النفي ـ لا بالمعني المكاني بل بالمعني الوجودي.
ولا بد هنا من الإشارة إلي أن من المشكلات التي يعاني منها الشعر العراقي المكتوب في المنفي ميله إلي استعادة صورة الماضي واستدعائه بأحداثه، في أغنيات حنين تتسم بشكلها المعلن، أكثر من الحضور الفني في القصيدة، ولعل ذلك متأت بسبب من طبيعة النفي العراقي المتسم بالقسوة والمرارة.. غير أن ذلك لا يلغي وجود حالات قليلة. تحت إلي حد ما من هذا الفخ.
وقع مؤجلة تنتمي إلي هذه الحالات، رغم أنها مكتوبة بجميع قصائدها داخل العراق، وهنا يبرز لنا المفهوم الآخر للمنفي.
ففي أولي قصائد الديوان (المكوث هنا) ـ ولا بد أن تذكر (المكوث هناك) ـ يبدأ الشاعر هكذا:
بكت، أبكتني في منفاي،
وابتعدتُّ،
كأني ـ خلفها أجري ـ
جنوباً حافي القدمين
علماً أن هذه القصيدة مكتوبة في بغداد عام 1987..
وسوي ذلك، يبرز تداخل آخر في المجموعة، تداخل بين القصيدة، أو النص، بين الغناء، والتأمل، وهذا يضيف سمة أخري من سمات الاشتراك بين المنفي/ الغناء والداخل/ التأمل.. كأنما ثمة مسافة برزخية ينبغي علي الشاعر استثمارها لكتابة نصه الجديد فيها..
أيضاً، ثمة قسوة ودموية تقترب من إيحاءات سريالية في طبيعة تكوين الصورة لدي الشاعر، في النصوص خاصة:
ملامح من مدن تدب في الدم، أنصاف
نساء، قري محطمة، فؤوس من هواء،
جبال من الشم ورقاب لا تنتهي إلي
شيء، واصبع يجيب، عجيب! فلم تترك
هذا؟
وفي النصوص التي ضمتها كلام متصل، متتابع لا يقف كثيراً، مع أن الشاعر يحاول إيقافه أحياناً.
وكأنه يمثل طوفاناً كلامياً داخل الشاعر!
وهو ما أدي إلي انحيازه الواضح للكلام علي حساب الكتابة كأنه يريد، بذلك، أن يقول: ان الشعر قول أكثر منه كتابة:
لأن الأب سيحتل دوره في التشريح إذا
ما أخطأت العلامات تكسرها، ونمت
اللحي في غير مواضعها يبدو الكلام
مجزءاً والحرف يسيل ألسناً وأفواهاً علي
المسافة بلا نقاط أو أسنان أو مغارات
نيام إلي الأبد.
ويمثل انحياز الكلام، انحيازاً أكبر للتجسيد، ولأن المعبر عنه غير قابل للتشخصن السريع بسبب الوسائل التعبيرية/ الرمز، فهو يدعو إلي انهياره من أجل استبداله بآخر أكثر قدرة علي التشخيص:
اهرب بالنص بعيداً، آخر الخلف،
سقطت العملة، واحتفل الخبز بالحرية.
ومن أجل هذا، وبعد أن يتيقن أن الكلام يقول ويقول ولا يصل، يتدخل عبر اختلاط بين إصدار الأمر والتساؤل:
قف أيها الكلام، إنهم يرثونك مثلنا
مفتتناً في السياق القديم
أو:
لماذا لا تنشأ العبارة في الحرف؟
وكلما دفع الشاعر بالكلام إلي أقصاه، ازدادت محنته، فهو لا يصل إلي التعبير، إلا عبر المعبر عنه ذاته أي الموت!
أنا، أيها النعم، أشرق بوضوح، أي سأموت
وهذه الجملة ترد في نهاية نصه خرائط النعم ومثلها نهاية النص الآخر (خزينة التفاح):
أما آخر نص في الديوان (المبعثرة) فهو ينتهي هكذا:
اشهدي معي إذن، إنني لم أقل شيئاً.
وبه يفتتح الشاعر النهاية علي كلام كثير محتمل، كلام يقاوم به بلاغة السكوت المتمثلة بالموت.
مع مجموعتي (نحت الدم) الصادرة عام 1994 عن دار الكنوز الأدبية ـ بيروت و(عذر الغائب) الصادرة عام 1997 عن دار ثقافات ـ كندا.. تمثل مرحلة أخري في تجربة الصائح، فبعد مرحلة الوفاء للأصول والتقاليد الشعرية في (المكوث هناك) ومحاولة الإنعتاق منها في وقائع مؤجلة بتوجه كبير نحو التجريب في مستوي اللغة وطبيعة البناء الدرامي وغرابة الصورة الشعرية وفرادتها، يستقر الشكل الشعري لدي الصائح ليتجسد في منحي ينوس بين المرحلتين مستفيداً منهما، ومطوراً أيضاً وهذه المرحلة تمثل برأيي مرحلة النضج الشعري في تجربته.
أهم ملامح هذا المنحي، هو التوجه نحو الشخصي لتظهيره علي غير سابق أو مثال، والنظر إلي فصول الكارثة التي عاشها، بعيني صقر، ليشكل مشهداً متماسكاً عن لا معقولية الوقائع، مشهداً يجمع بين هذا الشخصي حد الخصوصية وهذه الكارثية حد الفجائعية الشاملة التي أروثتها انتباهاً مهماً لتجربته الشخصية والنظر إلي الطفولة وهي تمثل حالة النجاة ربما الوحيدة من الكارثة، فالندوب النفسية التي لحق بروحه، لا يمكن علاجها إلا ببرء الماضي النظيف، بتراب الأرض الأولي في الطفولة وغبار المعارك لا يمكن التخلص منه إلا بمياه النهر الأول، نهر التطلع لحياة لم تكن في مخيلته كما آلت إليه. هنا أيضاً تظهر تجربة المرأة بوصفها خلاصاً من هذا العبء الكبير ـ لاحظ قصائد قديم خاص، وأمي، وثلاثية الملكة وهناك ـ في مجموعة تحت الدم ـ وقصائد هامشها، وعذر الغائب وسبب للوقت من مجموعة عذر الغائب.. صار الشكل الشعري مضموناً وصار المضمون جزءاً من سيرة اعترافية تتدخل غالباً في إعادة تشكيل الحدث الواقعي بما يمكن أن نسميه لوثة ميتافيزيقية وهنا واحدة من خصائص تجربة الصائح في محاولة إمساكه بحياته داخل نصه.
كما يتخذ من القصائد الموجهة إلي أشخاص، أو المتضمنة الأشخاص عنصراً وموضوعاً داخل القصيدة، قناعاً آخر للتعبير عن تجربته الشخصية الشعورية إزاء تاريخ مشترك من الألم.
هنا يضع الشاعر بوصلته الشعرية، لينتهج مساره، علي وفق دمج الشخصي بالجماعي لتشكيل ذاكرة متداخلة، تمثل شهادة حية علي مشهد لا يكاد يستقر ليجري الإخبار عنه والحكم عليه أو حتي وصفه.
سيتخذ السؤال صفة أخري، فحين يستعين الشاعر في مواضع كثيرة ومتعددة من القصائد بالإستفهام اللغوي، فهو لا يطلب إجابة بل يجعل أية إجابة ملتبسة وممتنعة تماماً، وكأنه يريد بذلك أن ينشئ التباساً لدي القارئ نفسه:
هل الأب نزف، أم يقذف، أم يدمع
وهو يشير إلي غيري الذي خرج علي هيئة أنا؟ عذر الغائب.
قصيدة (أعني ما أري) تمثل كما أعتقد نموذجاً ملائماً لرصد ما وصلت إليه تجربة الصائح بعد خمس مجموعات شعرية فهي لا تعتمد المقطعية ولا الترقيم ولا العنوانات الفرعية، إنها (نص) ينتمي إلي الشعر أكثر من انتمائه إلي (القصيدة) وحين نحاول إحالته إلي قصيدة النثر فإننا نجانب الصواب، ونظلم النص بوضعه في هذه التسمية. فهو شعر يتدفق، ويستغرق في تعقب مجري مظلم في وصفية يشتّ فيها الشاعر عن مركزية القصيدة ويسعي بإرادته إلي تدمير البؤرة وكسر البوصلة واقتياده نصه إلي مجاهيل الكتابة.
هذا النص واظب الصائح علي كتابته وربما بقي الوحيد من بين شعراء جيله من يكتبه ويجرب فيه.
يقوم النص ـ أساساً ـ علي محورية ضمير المتكلم (الرائي) العارف. إنه المتكلم المتوجه بكلامه وخطابه إلي آخرين، وقد تبدو هذه التقنية مؤصلة ومعهودة إلي درجة اعتيادها في كثير من شعر الحداثة. لكن هذا الاعتياد يصح علي النصوص والقصائد التي تقوم عليه تماماً.
أما في نص الصائح ـ الطويل نسبياً ـ فلا تستمر هذه التقنية ولا تستغرق النص إلي آخره، بل يهجرها كغيرها داخل النص الذي سرعان ما يستند علي بؤرة أخري ـ إضافة إلي ضمير المتكلم ـ هي (الجملة المحورية) التي يبدأ منها النص: هل أجبتني أيها الركض وكلما وصل النص إلي النقطة الحرجة التي تكاد تنهيه عاد إلي البداية، إلي تلك الجملة المحورية منظماً صفوفه ومفتتحاً مسارات أخري، وتلك برأيي من مشكلات أكثر النصوص الطويلة، ليس لدي الصائح فحسب، بل لدي أغلب الشعراء أو بالأحري هي مشكلة النص الطويل عموماً.
ميزة أخري لنص الصائح انه يشتغل علي اللغة حتي ينشغل بها. بل يمكن رده إلي مرجعيات رموزية ولغوية لدي الشاعر نفسه، فعندما يبدأ النص هكذا:
هل أجبتني أيها الركض؟
.. .. ..
فإنك تصطدم بتجريد (الركض) هنا فهو غير متجذر في شيء ولا يفضي إلي دلالة مخصصة في الحياة كما يبدو للوهلة الأولي لكنه يمتد إلي دلالة مكتوبة وموثقة لدي الشاعر نفسه في نصوص سابقة ولهذا جاء الاستفهام الإنكاري في أول جملة بصيغة الماضي، غير أن قارئاً ما سيقول: ولماذا علي قراءة ما كتبه الشاعر لأصل إلي (الركض)؟ وهنا موضوع آخر يتعلق بالقصيدة وبالمسيرة الشعرية عموماً.
في المناورة الثانية داخل النص ـ إن صحت التسمية ـ يبدأ الصائح من الفراغ المنقط ويوصل جملته بمحورها:
.. .. ..
فهل أجبتني أيها الركض؟
وأنا أتلمس الظلال تحت النوافذ، وأضع الحناء وأشعل أصابعي لا.. لأني أجمع أنين الليل ورشح المنازل
وأقلّب تنفسي علي الجمر
ألهث ما بين تصلب الغناء، وتساقط النجوم علي بحيرة الكسل.
أتفصد كالدم، وأضع كفي علي بقاياي
لاحظ (كثرة) الأفعال في مقطع من ثمانية أسطر، بل ورود فعل (الأنا) ثماني مرات في هذا المقطع والفعل يمثل في تجربة الصائح تعبيراً أليغورياً عن انحسار الفعل الفيزياوي، لكأنه هنا يجمع بين هاملت وماكبث، بهذا التعويض عن التأمل الذي يسبق الفعل المباشر، فجملة الصائح تنداح وتتناسل ذلك أن فعل الكتابة لديه يعادل فعل الدم: النزف، لذلك فجملته (تنفصد) كالدم ولا ينفع معه أن (يضع كفه علي بقاياه).
ومع أن عنوان (النص) قائم علي ثنائية الشيء وتسميته/ المرئي والمحسوس، فإن حضور اللغة وامتداداتها وقسوتها خلطت الرؤيا بالكابوس، كابوس الصائح القديم/ الجديد:
لاهثون.. يفتحون حرائق، يغلقون حرائق، ويرشون
المجري بالسم، لتتدفق الأحداث كالدم،
أنهاراً تغلي
وعربات عاطلة وركاباً محنطين أتركهم كالطعنات .
كثرة الدم في رؤيا الصائح أحالتها ـ الرؤيا ـ إلي كابوس وقيدت (الرؤية) بصورة الفاجعة واختلط (الشاهد بالمشهد) حتي تحولت ـ الرؤية إلي رموز (تعني) عالماً لا مرئياً لا يجسده سوي الانتباه إلي حياة الأشياء بوصفها لغة أخري (مجاورة) وحية تعيش حولنا وفينا ولا نستطيع ـ غالباً ـ تسميتها.
هنا لا بد من الإشارة إن وجود هذا الكابوس في شعر الصائح خاصة في مجموعتيه (وقائع مؤجلة) و(نحت الدم) يمثل تجسيداً خاصاً لشعر الحرب، ولكي لا يبدو هذا الكلام عاماً، أنبه إلي أن ما جري الترويج له في العراق علي أنه شعر حرب، لم يكن كذلك بالمعني الذي نفهمه عن فعل الحرب، فقد جري الترويج للنماذج التي تستخدم ميدان المعارك مشهداً لفرش مفردات البطولة بينما البطل غائب باستمرار، وقد ظن شعراء مثل هذه النماذج إن استبدال مفردات الحرب القديمة (السيف بالبندقية والفرس بالطائرة أو الدبابة) سيمنح قصائدهم حداثة ما كما ظن أحمد شوقي ومجايلوه رحمهم الله! فلم ينتبهوا إلي أن ساحة الحرب ليس في الميدان ولإن بدأت تتحول بالتدريج إلي أقصي تخوم النفسية البشرية وأخطر الإنهيارات هي التي تشهدها تلك التخوم لا المباني التي تقصفها المدافع والطائرات، ومن هذا الباب نقول إن ما يمكن أن نسميه (الرؤية في الكابوس) التي كانت من سمات قصائد الصائح واحدة من ملامح عدة يمكن من خلالها قراءة الشعر العراقي المكتوب تحت دمار الحروب، قراءة غير تقليدية تقلق المفهوم التقليدي عن شعر الحرب..
غير أن هذا الكابوس الماثل بوضوح في عموم القصائد، ينسحب في قصائد الصائح الأخيرة التي كتبها في التسعينيات، عندما يذهب الشاعر إلي مدينته وذكرياته وطفولته لتشع الوقائع متنزهة بحرية داخل نصه، باحتفال حياتي ينحسر عنه ضجيج اللغة وسوادها القاتم، وهو ما يظهر بوضوح في قصائد مجموعته الشعرية الجديدة ولد ولم يعد، منها علي سبيل المثال قصائد (الهروب من المدرسة) و(فقط) و(ناس من الناصرية).
تجربة عبد الحميد الصائح بتطور مسارها إرهاصاً وتشكلاً وترسخاً تمثل إلي حد بعيد نموذج لمجمل تجربة جيل الثمانينيات الشعري في العراق، جيل الحرب الذي فر إلي المنفي ليعيد السؤال القديم الجديد لجدهم كلكامش عن الصداقة والموت والخلود إلي الواجهة من جديد. (عن "الزمان" اللندنية)
(*) نشر في موقع "ايلاف" الثلاثاء 21 مايو 2002
|