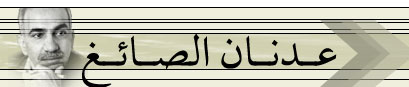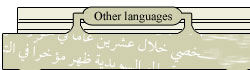د. ضياء خضير
تنتظم القصائد والمقطوعات الواحدة والستون التي يضمّها (بستان عائشة) في سلسلة المجموعات الشعرية العشر التي أعقبت ديوان البياتي (سفر الفقر والثورة). وهو الديوان الذي مثّل مرحلة جديدة من مراحل التطور الشعري لدى البياتي. ولئن كانت حِدّة المضمون السياسي والأيديولوجي قد ارتفعت في كثير من قصائد (سفر الفقر والثورة) وتمازجت مع رؤى ميتافيزيقيّة ووجودية أكثر قوّة في مجموعات أخرى، فإن (بستان عائشة) ظلّ يمثل نموذجاً فريداً للشعرية التي لا تنفك تعمّق المزايا الأساسية لتجربة الشاعر الذي دأب منذ بداياته التجديدية الأولى في (أباريق مهشّمة) على محاولة إزاحة النقاب عن وجه الحقائق البشرية الغامضة التي لم يتوصل العقل إلى قول كلمته الأخيرة فيها. وذلك عن طريق الشعور التعادلي الذي يمزج بين حقائق الحياة الواقعية وتفاصيل الحياة اليومية والمشاعر الميتافيزيقية التي تسكن في قلب الوجود الإنساني وتضيف إلى المشكلات الاجتماعية والتاريخية المرافقة للوضع البشري مصاعب وأبعاداً أخرى تجعل رؤية شعرية شاملة من نوع تلك التي يمتلكها عبد الوهاب البياتي هي المؤهلة لملامسة تلك المشكلات ووضعها في الإطار الذي يظهر وحشيتها وجماليتها الصاعقة في آن معاً. ولذلك كان التغيير في المضمون والرؤية مترافقاً عند البياتي مع التطور والتجديد في الشكل الشعري، حتى إذا بدا هذا التغيير غير مباشر أو غير واضح المعالم لأنه لا يقطع مع الأشكال الشعرية السابقة على نحو صريح وواضح. والبياتي يؤمن منذ بداياته الشعرية الأولى أن محاولات الاهتمام بالأشكال الشعرية دون سواها محاولات باطلة ومحكومة بالفشل إذا ما اقتصرت على أن تظل محض محاولات. ذلك لأن الأشكال الشعرية وما يرافقها من لغة جديدة وعناصر إيقاعية وسردية ودرامية ورمزية تمتلئ بها القصيدة الجديدة لا تمثل هدفاً نهائياً من أهداف هذه القصيدة، فهي تولد من خلال التجربة نفسها، ولذلك كانت الثورة على الأوزان والعروض والقوافي هدفاً ثابتاً ونتيجة من نتائج المضمون الجديد، كما كان البياتي نفسه يقول (1).
وهي، كذلك، ليست صورة بسيطة من صور التأثر بمنجز الشعرية الأوروبية كما ظهرت في حركات واتجاهات محدّدة أو لدى شعراء معيّنين، وقد ظهر لأستاذنا الدكتور إحسان عباس وهو يدرس علاقة قصائد البياتي في (أباريق مهشّمة) بالشعراء التصويريين وبأليوت أن هذه العلاقة لم تكن قائمة على التأثر بقدر ما هي علاقة لقاء. إذ أننا نفتقد الأدلة التاريخية، والمدوّنات النصيّة الكافية لتأكيد مثل هذه العلاقة بوصفها من أسباب التغيير الذي أصاب الذائقة الشعرية الجديدة، كما أوضح ذلك الدكتور شكري عيّاد أيضاً(2).
وهو أمر كانت خصائص اللغة الشعرية القائمة على التركيز ورسم الصورة وانتقاء عناصر واقعية معيّنة وتوظيفها لإغناء اللغة وتكثيف التجربة وربطها بعناصر تراثية وأسطورية واستخدام أساليب التضمين لأصوات وإشارات تعود لمرجعيات مختلفة قد أسهمت في تكوينه وإيجاد مزايا الحداثة الشعرية المفارقة فيه(3).
ومع ذلك، فإننا نلاحظ أن أغلب المقاربات النقدية التي تصدّت لـ (بستان عائشة) قد كانت تميل إلى معالجة المضامين الفكرية والأسطورية والرمزية التي ينطوي عليها هذا الديوان أكثر من معالجتها للعناصر الشكلية التي لا تستقيم شعرية النصوص بدونها. وكان الأستاذ الدكتور إحسان عباس قد أشار إلى أن الأزمة التي يعاني منها الناقد فيما يتعلق بالشعر الحديث تتمثل في أن هذا الناقد يحاول أن يحلل ويفسّر فيما نجد أن كثيراً من هذا الشعر يستعصي على التحليل والتفسير. وإذ تكون مهمة الشاعر الأولى هي إخراج اللفظة من الحيّز العقلي حتى تصبح قادرة على أن تعبّر عن فعالية الروح وحاجتها، فإن هذا الموقف يحد من دور الناقد التحليلي ويقصر مهمّته أحياناً على مجرد الإشارة إلى خروج هذا الشعر عن مألوف القول، أو أنه يبتعد عن مهمته الحقيقية فيصوغ نقده في شكل شعري ويتحدّث بلغة شبه خاصّة خارجة عن حدود الفهم، مما يضاعف المصاعب الخاصّة بتلقي النص الشعري الحديث، فإذا رأينا أن الشاعر العربي الحديث لا يحتفل كثيراً بالمبنى الشعري الملائم وتطويره، وإنما هو وكما يضيف الدكتور إحسان عباس -أسير لحظة انفعالية تتخلّق فيها القصيدة على ما هجس في نفسه من شكل مألوف، تبيّن لنا مقدار الصعوبة التي تواجه ناقد هذا الشعر. فقد كثر إنتاج هذا الشعر من دون أن يحمل سمات معيّنة في البناء، بل إنك تجد أحياناً ديواناً كاملاً قد سار على وتيرة واحدة(4).
والواقع أن ملاحظة الدكتور إحسان عباس الأخيرة تنطبق على دواوين البياتي الأخيرة ومنها (بستان عائشة) مثلما تنطبق على دواوين شعرية حديثة أخرى. ليس لأن البياتي لم يعد يُعنى بخلق المبنى الشعري الملائم لروح قصيدته ومساوقة اختلاجاتها وهواجسها الداخلية، وإنما لأن هذه المضامين قد استقرّت وتشابهت عنده إلى الحد الذي صارت قوالبها أو الأشكال المخصصة لاستيعابها متشابهة أيضاً.
إن ذلك هو الذي يميز في رأينا تجارب البياتي في مجموعات شعرية سبقت (بستان عائشة) مثل (سيرة ذاتية لسارق النار) و (قمر شيراز) و(مملكة السنبلة) حيث تحوّل القناع والرمز، ومجموعة أخرى من الخصائص الأسلوبية إلى تقنيات تكاد تكون ثابتة في ملامحها الحوارية والسردية وإشارتها التراثية والأسطورية وتركيز لغتها وميلها المفاجئ إلى التخلص من القناع والأسفار عن وجه الشاعر، ونسبة الخطاب إلى ضمير المتكلم وتحويل الزمن الماضي إلى زمن حاضر والحاضر إلى ماضٍ على نحو يؤلف فيه الزمنان شواهد وعلامات على تجربة أو تجارب إنسانية متّصلة تتداخل فيها الوقائع وتتشابه الرؤى وتتماهى الشخصيات مهما تكن أزمانها وأمكنتها. فيبدو الشاعر كما لو كان ساحراً قادراً على اختراق الزمن وتمزيق القشرة التي تفصله عن روحه الكامنة وراء الكلمات والأشكال، فهو الحلاج والمتنبي والمعرّي ومحيي الدين بن عربي وعمر الخيام والسهر وردي وجلال الدين الرومي وناظم حكمت وغيرهم وغيرهم، ممن عاشوا المحنة وجعلوا من تجاربهم مرآة يرى فيها الشاعر نفسه وصورة عصره، فهو يتكلم بألسنتهم مثلما كانوا يتكلمون بلسانه.
واسم (عائشة) الموجود في عنوان هذا الديوان والكثير من قصائده وقصائد دواوين سابقة ولاحقة هو رمز خلقه البياتي بنفسه سواء اعتمد فيه على جذر واقعي بعيد يتمثل في فتاة بهذا الاسم أحبّها في طفولته، أم استعاره من اسم حبيبة للخيام، أم كان رمزاً جامعاً لنساء عشن في أزمنة وأمكنة واقعية وأسطورية مختلفة،(5) والبياتي يقول عن (عائشة) التي بدأت تصبح ضيفاً دائماً في أشعاره منذ ديوانه (الموت في الحياة) إنه "إذا كانت عائشة قد ماتت في (الموت في الحياة) فلا يعني هذا أنها قد ماتت إلى الأبد، وإنما يعني أن ولادة جديدة تنتظرها في زمان ما ومكان ما من هذا العالم"(6).
أما (البستان) المضاف إلى (عائشة) هذه، فيرمز حسب بعض النقاد إلى التجسيد المكاني لدلمون، وللمدينة الفاضلة التي يسود فيها الحب والحرية وينتفي فيها القمع والخوف والموت(7). أما البياتي نفسه فيقول لنا بهذا الصدد: "إن بستان عائشة هو جمهورية الشعر كما كانت لأفلاطون جمهوريته. ولعلّ البرق الذي يندلع في غياهب السماء منذ آلاف السنين لكي يرينا الخارطة التي كان ينبغي على البشر أن يتتبعوا مسار أنهارها هي بستان عائشة"(8).
والغريب أن الشاعر لا يكتفي بتأكيد وجود هذا البستان الخيالي الموجود في السماء وإنما يحدد موقعه الجغرافي على الأرض "بين مدائن صالح وحلب وأعلى الفرات حتى الخابور" وهو يفسّر ذلك بالقول بأن هذا المكان "هو موطن العرب الأول الذي تمّ به الاختصار الروحي للعرب قبل ظهور الرسالة المحمدية، ومن هذا المثلث الروحي انبعثت كل الأديان السماوية"(9).
وهو يجد أن من حق الشاعر أن يقيم جمهورية للشعر في هذا المثلث المسحور، بحيث تبدو وظيفة القصيدة بالنسبة إلى الشاعر مثل وظيفة الأسطورة بالنسبة إلى المجتمع أو المجتمعات البدائية التي تؤمن بها. فالشعور الطاغي بالوحدة والحنين إلى الجسد الذي انتزعنا منه هو حنين إلى المكان وتبعاً لبعض المفاهيم المتداولة بين الشعوب البدائية، نجد أن مكاناً من هذا النوع هو مركز العالم أو سرّة الكون. وهو يتماثل أحياناً مع صورة الفردوس ويتوحد مع المكان الأسطوري أو الحقيقي الذي مثله هنا (بستان عائشة). والشاعر المحكوم عليه بالنفي والبعد عن وطنه يشعر بالحاجة إلى البحث في الصحارى والأدغال والمتاهات والأقبية الواقعية والخيالية عن مكان آخر بعد أن كفّ الزمن عنده عن أن يكون زمناً انتقالياً وتعاقبياً، هو تدفق دائم لحاضر ثابت تلتقي عنده الأزمنة كلها. وهو كما ذكرنا الزمن الذي يجذب إليه الأسطورة أو الأساطير القديمة ويخرجها من زمنها ليبثّ فيها نفساً وروحاً كانا لها في الماضي وفقدتهما في واقع المجتمعات الصناعية الحديثة.
إن غموض العالم وقرف الشاعر من بعض المظاهر الزائفة الموجودة فيه هو ما يدفعه نحو التماس التصوف والروحانية والحب بمعناه المستحيل وطلب الخلاص في الأسطورة وفي عالم ما ورائي آخر تحتشد القصيدة لطرق أبوابه مستعينة بالقديسين والشهداء والأولياء الصالحين الذين سبقوا الشاعر على
هذا الطريق.
وحينما نقرأ هذه الكلمات التي وضعها (بودلير) في إحدى قصائده النثرية:
"إن نشوة الفن أكثر قدرة من أية نشوة أخرى على حجب أهوال الهاوية، وأن العبقرية قادرة على تمثيل المهزلة على حافة القبر بصوت يمنعها من رؤية القبر، وهي الضائعة في فردوس، نافيةً فكرة القبر والتدمير معاً"(10).
أقول حينما نقرأ مثل هذه الكلمات لبودلير ونقارنها بما فعل شاعرنا البياتي في دواوينه المختلفة يمكننا أن نقف على هذا السر الذي يبدو أن أعماق الشعراء والفنانين الكبار جميعاً تنطوي على جانب منه.
وحين نخصص الحديث عن بستان عائشة، فإن بإمكاننا أن نرى أن نشوة الحب الذي ترمز لـه هذه المرأة الواقعية والأسطورية، المادية والمجردة، الحقيقية والمتخيلة، تمثل داخل محراب عبد الوهاب البياتي الرافعة التي لا تكتفي بإبعاد الشاعر عن حافة القبر وتنقذه من هاوية المجهول والأسرار الكونية المهيأة لابتلاعه، ومن الفراديس الاصطناعية التي أغرق الشاعر اللعين نفسه في مباذلها، وإنما هي تستطيع عن طريق الفعل والكلمة السحرية أن تطهر روحه وتذيب الثلج المتراكم على أطرافه.
ووجود (عائشة) في الديوان ليس وجوداً متعيّناً بالاسم أو الرسم فقط وإنما هو وجود محايد يستبطن كلمات النص ويسكن القصيدة ويؤالف بين عناصرها الداخلية أيضاً حتى إذا لم يذكر الاسم ولم ترد الإشارة إليه بصورة صريحة. إذ يكفي أن يكون هناك ذكر لامرأة في النص لكي تتم الإحالة إلى رمز (عائشة) وما يتبع ذلك من إشارات ورموز مهيمنة وأفكار مثل (الموت في الحياة) و (الحياة بعد الموت) وما إلى ذلك من رؤى وأفكار تجسدها هذه المرأة، كما في هذه القصيدة المسماة (وردة الثلج) من قصائد (بستان عائشة)، التي سنرى أنها تنطوي على تناقضات تكاد أن تكون ملازمة لقصائد البياتي في هذا الديوان، خصوصاً فيما يتصل بالعلاقة بين مطالع هذه القصيدة وخواتيمها.
وردة الثلج
وردةُ الثلج، هنا، ترقد
هل أحببتُها يوماً؟
لماذا لا تجيب؟
بكت العرَّافةُ العمياء
لما قرعت شاهدة القبر
فلم ينهض من القبر سوى هذا الصليب
ورماد الورق الأسود والأحمر
يطّاير في ريح المغيب
عندما يكتشف الشاعر في منفاه
سرَّ الآلهة
نيزكاً يسقط في البحر
عواء الرغبة المشتعلة
قارةً غامضة تظهر، ليلاً،
في بياض الورقة
غابةٌ، قافيةٌ محترفة
نجمةٌ مؤتلقة
عندما يصبح هذا النص مفتوحاً
وهذا القرع في شاهدة القبر
حضوراً في الوجود
تنهض الوردة من تابوتها
حاملةً نار جنون العشق
نار الملكوت(11).
إن (وردة الثلج) تتضمن في ذاتها منذ البدء هذه المفارقة التي تنتظم قلب القصيدة كلها، فهي وردة ولكنها في الثلج حيث البرودة التي تجعل من غير الممكن وجود حياة لوردة مثلها. ولذلك فلا غرابة أن نجدها(ترقد) ولا تقف وسط بياض هذا الثلج الذي يشير إلى براءتها وطهرها. وهو ما يجعل وجود القبر الذي تقرع العرّافة العمياء على شاهدته أمراً طبيعياً. فقد ماتت هذه الوردة من زمان مثلما مات حب الشاعر القديم لعائشة التي لا بدّ أن تكون هذه الوردة رمزاً من رموزها. والصليب الذي ينهض مع رماد الورق الأسود والأحمر فوق ثلج هذا القبر هو الشاهد على ذلك. غير أن هذه الأشياء والعلامات التي يراها الشاعر مشيرةً إلى وجود هذا الحب هي من الخفاء والدقة بحيث يصعب على الشاعر أحياناً تصديق وجودها، وهو ما يبرر وجود الأسئلة الاستنكارية الواردة في الأسطر الثاني والثالث والتاسع من القصيدة. فهذه الأسئلة لها من الشرعية ما يجعل كل تفاصيل قصة الحب التي تنطوي عليها القصيدة، محاطةً بالشك. وبعد الاستفهام الثالث والأخير (أي حب هو هذا؟) تدخل القصيدة في دورة أخرى أو طيّة جديدة ينعطف فيها الخطاب الشعري ويتخلى عن محاولة التقرير والتساؤل الباعث على الشك نحو التفسير واستئناف القول في الوقائع الكونية الغريبة التي يضيع فيها الحب في الواقع والذاكرة ولا يبقى منه غير عواء هذه الرغبة المشتعلة مثل نيزك ساقط في البحر أو قافية محترفة في القصيدة. غير أن الدورة الثالثة أو المقطع الأخير الذي يبدأ مثل المقطع الثاني بالظرف (عندما) سيقوم بفعل الموازنة والمصالحة التي يتمكن الشاعر عن طريقها من فهم ما حدث ويحدث في هذه (القارة الغامضة). إذ إن هذا الوجود المفتوح لكل الاحتمالات، مثل النص، هو الذي ينطوي في أحشائه على بذرة الموت وجرثومته مثلما ينطوي على بذرة الحياة ومظاهرها المختلفة. ولذلك فهو لا يعمل فقط على فناء الحب والموت في الحياة، وإنما هو يفتح الطريق نحو الحياة بعد الموت، بحيث يتحول هذا القرع في شاهدة القبر إلى حضور في الوجود. وهو ما يمهد لنهوض وردة الشاعر من تابوتها حاملةً نار جنون ذلك العشق الشخصي القديم نفسه، وربما شيئاً آخر هو (نار الملكوت) التي يصبح ذلك العشق معها جزءاً من حالة بعث وجودية كبرى وليست حالةً معزولة أو خاصة بالشاعر وحبيبته. وهو ما يفسّر لنا أيضاً ما يقوله البياتي عن (عائشة) التي تموت ولا تموت، لأن ولادة جديدة تنتظرها في مكانٍ ما وزمانٍ ما.
ولئن كانت الحركات الثلاث التي تتألف منها هذه القصيدة تبدو كما لو كانت منفصلة عن بعضها بحيث يمكن أن تُقرأ كما لو كانت مستقلة عن بعضها، فإنها تظل مع ذلك متصلة وتؤلف القوام الموحّد للقصيدة، إذ تمهد الحركتان الأولى والثانية للحركة الثالثة التي تجمع وتؤالف بينهما كما لو كانا مقدمةً ونقيضاً قبل أن تأتي الخاتمة لتصالح بينهما. وعودة كلمات مثل (الوردة) وعبارات مثل (القرع على شاهدة القبر) يشبه أن يكون نوعاً من ردّ العجز على الصدر في القصيدة العمودية. وهو ما يشير إلى أن القصيدة في مجملها يمكن أن تُقرأ مثل بيتٍ أو جملة شعرية واحدة. فهي رغم تركيبها وتعقّد الرؤية فيها ذاتُ نفسٍ واحد متضامن في نموّه. وإشارة الشاعر في الحركة الثالثة إلى النص المفتوح تتصل بشمول الدلالة واتساعها وليس فقط بالبنية والمظهر النصي للقصيدة. إذ يمكن من خلال هذه الدلالة المفتوحة أن نستحضر كثيراً من تصّورات البياتي الوجودية وحبه لتلك المرأة غير المسماة في القصيدة وغير المجسّدة في غير هذه الوردة التي ترقد في الثلج ولكنها ليست بعيدة عن صورة (عائشة) التي يقول الشاعر "إنها اختفت ولا أعرف أين هي الآن، ولكنني لن أنسى حرارة يدها وبريق عينيها الذي أراه يتلألأ في ظلمات الليل كلّما أصابني مسٌّ شعري أو وجع. لقد فجّرت الينبوع واختفت إلى الأبد، وكلّما حدّقتُ في حقل رماد أرى تلك المرأة وهي متّشحة بالسواد، ولكنها كانت تختفي لكي "تتعين" في نساء أخريات. لقد توالد فيها أو توالدت آلاف العصور والوجوه، فهي الربّة والأم والمحبوبة الأزلية وعشتار التي تحوّلت أيضاً إلى نجم بفضل معجزة الحب"(12).
هذا ما يقوله الشاعر، ولكننا نلحظ مع ذلك أن نغمة الأمل التي تولدت عند البياتي غالباً في نهاية المتن الشعري لا تفلح دائماً في إزاحة الشعور بالإخفاق والإحساس اليائس الذي يرافق الأداء العام للقصيدة. والنار التي يتكرر ورود لفظها مرتين في المقطع الأخير من هذه القصيدة تظل غير قادرة على إذابة الثلج الذي يحيط بهذه الوردة في رقدتها المستوحدة عند مطلع القصيدة، ولا تخفّف من هيمنة الألفاظ والتعبيرات التي توحي بالحزن والتشاؤم مثل (العرّافة العمياء) و (شاهدة القبر) و (الصليب) و(رماد الورق الأسود) و(ريح المغيب) و(المنفى) و(القافية المحترقة).. الخ. ونحن نشعر، كذلك، أن بعض الخواتيم التي يلجأ البياتي إلى وضعها في بعض قصائده ويستبدل فيها الخيالي بالواقعي والغائب بالحاضر والميتافيزيقي بالمادي تشكل محاولة للتسامي والتحرر من خطيئة المحسوس وشرك الأشكال المادية وصولاً إلى ما هو روحاني. ولذلك فإن الاتجاه العام للقصيدة هو اتجاه صاعد من الأسفل إلى الأعلى، من الأرض إلى السماء، ومن المادي إلى المجرّد. وإن كانت الأسطورة التي كثيراً ما يلجأ إليها الشاعر تبدو، على العكس من ذلك، عودة إلى الوراء وبحثاً عن زمن ضائع وغير موجود في الحاضر. ولكننا نتذكر أن البياتي لا يكتفي بتحويل هذه الأسطورة وإدخال التغيير فيها، وإنما هو يلجأ إلى خلقها كما فعل في أسطورة عائشة هذه. وقد ذكر الناقد العراقي (فاضل ثامر) أن "مما له دلالة أن علاقة الأنثى عائشة بالذكر الخيام تظل علاقة رومانسية أفلاطونية عذرية لا تمتلك تجسيداتها الحسية أو الجنسية الصريحة". ويستنتج (فاضل ثامر) من ذلك غياب أية تجربة عاطفية محسوسة في معظم متن البياتي الشعري، وما يتبع ذلك من غياب التجربة العاطفية العميقة بجذورها الحسية في تجربة البياتي الشعرية والحياتية(13).
إن هذا يبدو صحيحاً حتى إذا كانت القصيدة ذات طابع حسّي عنيف مثل هذه القصيدة من قصائد الديوان المكتوبة تحت عنوان (رجل وامرأة):
((رجل وامرأة
يسقط الثلج على مدخنة البيت،
وفي بهو المرايا
امرأة منتظرة
رجل في دمها يحرث مأخوذاً
حقول الجسد المزدهرة
رجل يولد من أضلاعها
يسكن فيها
يختفي في الذاكرة
نابضاً في قطرات دمها المفترسة
صاعداً كالشجرة
في خلاياها وفي أوصالها المرتجفة
رجل عانقها
فاشتعلت في دمها نارُ الفصول الأربعة))(14).
ففي هذه القصيدة ذات البناء السردي الواضح نجد أن الطرف الغائب في طرفي علاقة الحب الحسيّة هذه هو الرجل وليس المرأة. ولكن غياب الرجل يتحول عند هذه المرأة إلى حضور عنيف في كل أجزاء جسدها وروحها. وحالة الحب التي تعيشها المرأة في القصيدة قريبة في صورتها من الصورة الواقعية الأرضية. فهي تدخل حالة شبقية عنيفة وتعاني من الانتظار والوحدة. ويمكن أن نرى، على المستوى السايكولوجي، في صورة الرغبة المشتعلة عند هذه المرأة تعويضاً لحالة العجز التي يعاني منها الشاعر من هذه الناحية، ولذلك فلا غرابة في أن تواجه هذه الرغبة بالحرمان والقمع هي الأخرى. ووجود المرايا في بهو البيت يحمل في ذاته إمكانية للتأويل. إذ إن وظيفة هذه المرايا لا تتحدد في عكس صورة هذه المرأة المستوحدة، في هذا البهو، وإنما هي تظهر صورة رجلها الغائب على نحوٍ يتحول فيه الغياب إلى حضور متعدد الأوجه، كما ذكرنا.
ونحن نواجه، في النص مرةً أخرى، هذا التقابل والتضاد بين صورة الثلج الذي يسقط على مدخنة البيت في سطر القصيدة الأول، والنار التي تظل مشتعلة في دم المرأة عند السطر الأخير. وهو ما يحيل إلى رؤية التناقض الموجود بين الخارج الذي تملؤه البرودة والوحشة، والداخل المرتبط بالدفء والحرارة. وبين السطرين الأول والأخير يحضر الرجل الساكن في جسد هذه المرأة وذاكرتها على نحو فيه من العنف والقوّة ما يجعل غيابه غير محتمل وغير معقول. ولكننا نشعر أن حرارة الداخل مهدّدة بالفتور، والانطفاء ما دامت تتساوى في النتيجة برودة الخارج، وما دامت تنطوي مثله على الفراغ والوحدة. فاحتدام العاطفة وحرارة الشوق للقاء تظل عاطلة ولا معنى لها طالما كان الثلج يواصل السقوط على مدخنة البيت التي تمثّل مركز الحرارة ورمز الجنس في آنٍ معاً.
القصيدة، كما نرى، ترسم حالة وتكشف عن عاطفة أنثوية غير اعتيادية تتكئ شعريتها على ألفاظ ووقائع حسيّة وانزياحات مجازية، ولكنها لا تترافق مع انخطافات روحية وتهويمات ما ورائية مجرّدة. الرجل والمرأة فيها نكرتان لا تفلح الأفعال والصفات المعرّفة بهما في كشف الغموض الذي يغلف حياتهما ولا في كشف الالتباس الموجود في طبيعة العلاقة القائمة بينهما. والسارد الذي يتّحمل عبء رواية حكايتهما موضوعي لا يتدخل في الظاهر فيما هو خارج عن وصف حال هذه المرأة وعنف انشدادها إلى رجلها الغائب، ولا يتحول إلى موقف التعليق على ما يجري أو يضع نفسه إلى جانب الشخص الذي يتحدث عنه. فضمير الغائب العائد على المرأة أو الرجل هو الوحيد الموجود في أفعال القصيدة. كما أن الفعل المضارع المهيمن في القصيدة يمثل الزمن الطبيعي الذي يتدفق داخل المرأة حتى إذا كان يستند إلى فعل أو أفعال حدثت في الماضي ولكنها تُسحب إلى الحاضر عن طريق الذكرى والتصور واستخدام تقنية تيار الوعي الذي يجعل المرأة في حاضر الماضي كما لو كان حاضراً في الحاضر فالرجل (يحرث في دمها) و (يسكن فيها) و (يولد من أضلاعها) و (يختفي في ذاكرتها). ويجيء اسما الفاعل (نابضاً في دمها) و (صاعداً كالشجرة) ليؤكدا على ثبات التأثير المأساوي للرجل على هذه المرأة. أما الفعلان الماضيان الوحيدان الموجودان في السطرين الأخيرين من سطور القصيدة، فهما -ولاسيما الأول منها- اللذان يفجران كل أفعالها الحاضرة. والفعل (عانق) الذي يحدث مرةً واحدة في الماضي قد تسبب في سلسلة الأفعال المضارعة التي تنهض بنيةُ القصيدة عليها من الناحية اللسانية.
بقي أن نذكر أن قصيدة البياتي هذه تُشبه من بعض الوجوه قصيدة السياب "أغنية في شهر آب". إذ إن حالة الانتظار والوحشة التي تعاني منهما المرأة في تلك القصيدة تقترب كثيراً من حالة الانتظار القاتل عند امرأة البياتي في هذه القصيدة، وإن كنا نشعر أن الشهوة الجنسية أقوى عند امرأة البياتي هذه منها عند امرأة السياب، حتى إذا كانا كلاهما يكشفان عن خواء روحي وفراغ عاطفي يتصل بما يعاني منه الشاعران نفسهما وليس فقط بالمرأتين الموجودتين داخل قصيدتهما.
والمهم في قراءتنا لهذه القصائد هو رؤيتنا للتناقض والتضاد بين خاتمة القصيدة ومنتهاها. وهو تناقض لا يقتصر أحياناً على القصيدة الواحدة وإنما يتعداه إلى قصائد مختلفة تتفق أحياناً في موضوعها ولكن خاتمة الواحدة منها تختلف عن الثانية وتكون على الضد منها. ويمكن أن نتخذ من خاتمتي قصيدتي البياتي في خليل حاوي نموذجاً لذلك.
"فأين يمضي شاعرٌ
نجا من الموت
لكي يموت"؟(15)
فهذا المقطع الذي يختم البياتي به قصيدته (الحصار) المهداة إلى "خليل حاوي" في ذكراه يختلف في نغمته اليائسة عن المقطع الآخر الذي ختم الشاعر به قصيدته الأخرى المكتوبة عن خليل حاوي تحت عنوان (مرثية إلى خليل حاوي). وهي القصيدة التي يُفتتح بها ديوان (بستان عائشة):
"حين انتحر الشاعر
بدأت رحلته الكبرى واشتعلت في البحر رؤاه
وحين اخترقت صيحتُه ملكوت المنفى
طفق الشعب القادم من صحراء الحب
يحطّم آلهة الطين
ويبني مملكة الله"(16)
إذ إن الأمل والتفاؤل خامرا خيال البياتي بهذه المناسبة وجعلاه يتحدث عن جدوى قتل خليل حاوي لنفسه عام 1983 وهو عام كتابة هذه القصيدة، قد تحوّل عام 1988 (وهو عام كتابة القصيدة التالية) إلى يأسٍ شامل وحصار تبدو فيه كل المنافي والسجون محجوزة شأنها في ذلك شأن أقبية التعذيب والجنون ومطاعم المدينة وقصائد التفعيلة. أي أن نبوءة الشاعر التي تقول بأن "الشعب القادم من صحراء الحب" سوف يثأر لخليل حاوي الشاعر الشهيد ويحطم آلهة الطين ويبني مملكة الله، كما ورد في القصيدة، لم تتحقق، وبقي الخطر يواجه الشاعر في موته لأنه سيموت ثانية إذا نجا من الموت. وهو أمرٌ ينسحب بطبيعة الحال على الشاعر الآخر، أعني البياتي الذي يموت في الحياة ويبحث عن البعث في الموت والحياة ولكنه لا يجد لكلماته الصدى الذي كان لها في سالف العصر والأوان. فقد تغيرت الحال غير الحال ولم يعد الأمل والتفاؤل بالثورة التي يستطيع الشاعر من خلالها الثأر لصنوف الظلم وامتهان الكرامة الإنسانية قائماً. لقد كان أملاً زائفاً لا سنداً تاريخياً له وأن انتحار الشاعر سواء تحقق على هذا النحو الواقعي التراجيدي الذي شهدناه عند شاعر مثل خليل حاوي، أم ظل مجازياً وواقعاً على صعيد الإمكان وليس الفعل أي على النمط الذي يسميه البياتي (الموت في الحياة) سيظل هو القدر الذي يواجه الشاعر ويحيط كل آماله بنية إخفاق لا شك فيها ولا برء منها. وهو أمرٌ يرتبط عند البياتي بزمن عربي يتراجع إلى الوراء ولا يتقدم إلى الأمام ولا تصلح فيه الهزائم والانكسارات لأن تكون محفزات كافية لتجاوز المحنة وما تخلفه في وعي الإنسان الفرد وذاكرته وجسده من آثار وجروح غير قابلة للاندمال. لقد حوصرت الثورة وتمّ اغتيالها وأصبح من الصعب على (عائشة) التي تمثل روح العالم المتجدد من خلال الموت والكائن اللامتناهي أن تعيش دائماً وتموت ولا تموت.
الهوامش:
(1) جهاد فاضل. قضايا الشعر العربي الحديث، حوارات، بيروت 1984، ص211.
(2) د.شكري محمد عيّاد، في محراب المعرفة، دراسات مهداة إلى إحسان عباس، تحرير إبراهيم السعّافين، بيروت 1999، ص205.
(3) نفسه، ص205 وما بعدهما.
(4) نفسه، ص205 وما بعدهما.
(5) انظر بهذا الصدد فاضل ثامر، الرمز الأسطوري والقناع في الشعر العربي الحديث ضمن كتاب (المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر) الحلقة النقدية لمهرجان جرش الثالث عشر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص82.
(6) عبد الوهاب البياتي، ما يبقى بعد الطوفان، إعداد عدنان الصائغ ومحمد تركي النصار، نادي الكتاب العربي 1996، ص104، وما بعدها.
(7) عبد الوهاب البياتي، ما يبقى بعد الطوفان، إعداد عدنان الصائغ ومحمد تركي النصار، نادي الكتاب العربي 1996، ص104، وما بعدها.
(8) عبد الوهاب البياتي، ما يبقى بعد الطوفان، إعداد عدنان الصائغ ومحمد تركي النصار، نادي الكتاب العربي 1996، ص104، وما بعدها.
(9) عبد الوهاب البياتي، ما يبقى بعد الطوفان، إعداد عدنان الصائغ ومحمد تركي النصار، نادي الكتاب العربي 1996، ص104، وما بعدها.
(10) بودلير، أزهار الشر، ترجمة خليل خوري، بغداد 1998، ص33.
(11) عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، المؤسسة العربية 1995، ج2/بستان عائشة.
(12) عبد الوهاب البياتي، ما يبقى بعد الطوفان، مرجع سابق، ص105.
(13) انظر، فاضل ثامر، مرجع سابق، ص92.
(14) عبد الوهاب البياتي، بستان عائشة، الجزء الثاني من الأعمال الشعرية.
(15) عبد الوهاب البياتي، بستان عائشة، الجزء الثاني من الأعمال الشعرية.
(16) عبد الوهاب البياتي، بستان عائشة، الجزء الثاني من الأعمال الشعرية.
(*) شعر الواقع وشعر الكلمات دراسات في الشعر العراقي الحديث من "منشورات اتحاد الكتّاب العرب دمشق – " 2000