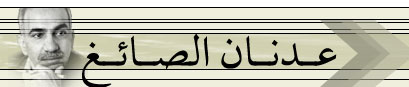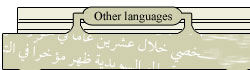|
قراءة في مسرحية التنور:
مستويات متعددة في عرض افتراضي
فَإِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّور
المؤمنون أية 27
يجب خلخلة الحواس. بعد هذا تستطيع أن ترى ما لا يرى
رامبو
د. حسن السوداني - السويد -
في أمسية ثقافية عربية سويدية, استضاف مسرح بيت الأحلام Drömmarnas hus في مدينة مالمو السويدية فرقة السلام المسرحية في عرضها الجديد( التنور) المأخوذ من قصائد الشاعر العراقي عدنان الصائغ وتمثيل وإخراج المسرحي حسن هادي. والتنور مفردة ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورتي "هود" و"المؤمنون" وقد اختلف في تفسيرها على عدة أقوال, فمنهم من فسرها على أنها وجه الأرض والعرب تسمي وجه الأرض تنوراً, ومنهم من يقول بأنها تنور الخبز وكان لحواء وصار لنوح ومنه ظهرت علامة الطوفان, وهي طلوع الفجر ومسجد الكوفة كما فسرها الأمام علي(ع) وفسرها ابن عباس بأنها "التمثيل لحضور العذاب; كَقَولهم:حميَ الوطيس إذا اشتدت الحرب والوطيس التنور". وأياً كانت هذه التفسيرات فقد ظل التنور مفردة يستعملها العراقيون دون سواهم من العرب حملت الكثير من الدلالات الحياتية والشعبية وبالتحديد عند العراقيات اللواتي يعتبرنه رمزا للنقاء والطهارة, وفي وسط وجنوب العراق يطلق عليه "تنور فاطمة" ويتم التعامل معه على وفق هذه الأهمية ويتوسلن لله تعالى بفاطمة الزهراء أبنة الرسول الأعظم(ص) في قضاء حاجاتهن وحفظ أولادهن والانتقام من أعدائهن, كما أن هناك طقوس خاصة لهدم التنانير القديمة وبناء الجديد منها يتخللها ترديد البسملة والصلوات من الأب أو الجد الذي يتولى عملية البناء على اعتبار أن عملية هدم التنور تحمل نذر الشؤم والبلاء. و هذه العادة متوارثة عند العراقيين منذ القدم وتستند إلى بعض التفسيرات ومنها تفسير أبن عباس سابق الذكر. ويمتلك صانعوا التنانير الجيدة سمعة طيبة في قراهم أو بين قومهم وغالباً ما يكونوا من ذوي الصفات الدينية والكثير من الطيبة والاعتدال. ويبدو أن هذه الشخصية بما تحمله من أرث شعبي قد استهوت المسرحي حسن هادي لتكون بطلة عرضه الجديد ولتكون مفردة التنور هي بطلة مفردات العرض التشكيلية التي تتحول في العرض إلى مجموعة دلالات زمكانية تفجرها مفردات النص ( القصيدة) بأسلوب التجريب على مستوياته المتعددة في العرض.
النص: أستند العرض إلى ثلاث قصائد للشاعر عدنان الصائغ هي ( خرجتُ من الحرب سهوا, و مرايا المتعاكسة, و العبور للمنفى) وقد حضت هذه القصائد باهتمام السويديين بعد أن صدرت مترجمة للغة السويدية في ديوان الصائغ (الكتابة بالأظافر) وبعد أن قدمت الممثلة السويدية ليزا فري بعضا من قصائد هذا الديوان للجمهور السويدي في أكثر من عشرة مسارح داخل مدينة مالمو وخارجها وفتحت الباب لترجمة ديوان الصائغ الأخير ( تأبط منفى), والقصائد الثلاث تتحدث عن موضوعة واحدة بصور متعددة وهي موضوعة العراقي بين الحرب والمنفى, ولكون العمل اعتمد أسلوب التجريب في جميع مفرداته فقد أخذت هذه القصائد دون التلاعب فيها مطلقا وأنما ترك المفردة الشعرية في القصيدة تقوم بدور المفردة المسرحية في النص المسرحي بما تحمله هذه المهمة من صعوبات في التلقي التقليدي, أي إنها تتطلب متلقيا ذا دربة سمعية وبصرية إلى جانب ذلك جهداً أدائياً متميزاً لإيصال هذه المنظومة إلى أكبر عدد من المتلقين, والصعوبة الأخرى تكمن في تطويع الإيقاع الشعري للقصيدة إلى إيقاع مسرحي يتماشى مع قوانين اللعبة المسرحية ناهيك عن كثافة الصور التي تحملها القصيدة والتي ينبغي ترجمتها إلى صورة متحركة بجسد الممثل وتقنيات العرض. ولعل هذه التحديات وغيرها شكلت مادة في التعامل مع النص بطريقة تجريبية تجاذبتها رياح العرض بين مد وجزر قرّب المسافة بين النصين ـ الشعري والمسرحي ـ وأعاد فرضية اعتماد القصيدة مشروعا جاهزا للعرض المسرحي, وهي الفرضية التي كُثرَ معارضوها وقلَ مؤيدوها! وإذا كانت قصائد الصائغ قد تحولت إلى عرض مسرحي بجزأين قُدما داخل العراق في بداية تسعينيات القرن الماضي حملتا عنوان ( هذيان الذاكرة المر والذي ظل في هذيانه يقظاً) بجهد مميز لمعدهما الفنان إحسان التلال الذي اعتمد المونتاج النصي المحكم أسلوباً في الإعداد, فأن ما يخالف التجربة الجديدة عن تلك هي اعتماد القصيدة نصاً متكاملاً دون عمليات جراحية أو مونتاجية لصناعة قصيدة مُمسرحة. وهي مهمة تحمل العديد من الصعوبات أهمها عملية الربط بين القصائد بطريقة توحي بأنها عملا واحداً أو نصاً مكتوباً على ثلاث مراحل, وهنا لعبت التقنية دورها في الاستلام والتسليم بين المفردات المكتوبة التي تحولت إلى متواليات من (المنطوق, المصور, المتخيل...... الخ) لتصل في النهاية إلى دخول منساب في رحم القصيدة الأخرى و... الأخرى في نسق متوالي, وهو ما يسمى بالجهد التجريبي في تماهي الصور المسرحية. وهذه التجربة (النص) تعود بالنقاش إلى حرارته فيما يخص توظيف الشعر في العالم الافتراضي الجديد ومفرداته التقنية التي فاقت الخيال نفسه.
العرض: اعتمد المخرج تقنية (الحضور والغياب) في خلق عالمين مختلفين في تشكيل صوره اضطره بالنتيجة إلى خلق مستويين للعرض أولهما المستوى المرئي المباشر والآخر خاص به بعيداً عن عيون المتلقين ولكي يحول هذه الفرضية إلى شيء قابل للتطبيق, أخذ يبحث داخل القصائد عن مفردات تستجيب لفعل التغير هذا دون أن تكون فرضية قسرية تحاول إثبات ما لا يمكن إثباته, وقد استجابت القصائد بما تحمله من كثافة صورية لهذا الافتراض فمنحته دون تردد مواقف كثيرة منها مثلا:
ـ "أركض, أركض, في غابة الموت, أجمع أحطاب من رحلوا في خريف المعارك, مرتقبا مثل نجم حزين, وقد خلفوني وحيدا هنا....."
في هذا الحوار استجابة لافتراض المخرج خلق عالمين تخاطبين من خلال توظيف مفردة الوحدة (وحيداً) في القصيدة إلى مفردة تخرج من عمق مفردة العرض الرئيسية (التنور) التي تحيل المستمع إلى عالم غير مرئي ومظلم في أعماق مكان مهجور. ولكي يستمر المخرج في إثبات فرضية الحضور الغائب هذه, يستثمر مقطعا أخر من نفس القصيدة هو:
ـ "ينحدر الليل صوب المنازل وادعة في مساء التشابه والزنبق المرِّ, يهرع سرب الكراكي إلى نبع روحي. غداً في صباح بلا طائرات، سنركض تحت رذاذ البنفسج, ملتصقين نلف الشوارع والكركرات......."
في هذا الحوار يغلق الممثل ـ المخرج ستارة العرض في عملية احتجاجية على هذا العالم كله وليخلق عالمه الخاص بعيداً عن عيون الناس جميعا في حالة رفض مطلقة لا نسمع خلالها سوى كلماته الصارخة في عزلته تلك وضربات تأتي من داخل الستارة المغلقة والتي رسمت على صفحتها المقابلة للجمهور مجموعة من الرموز الشعبية توحي بنصب الحرية للفنان العراقي جواد سليم وكفوف كتبت عليها كلمات مبهمة وأرقام تشكل عند جمعها دلالات متعددة كالأرقام ثلاثة وأربعة وسبعة والتي تحمل دلالات الموت والحياة في الإرث الشعبي العربي والعراقي وهي مستقاة من الإرث البابلي القديم, وقد رسمت هذه الرموز جميعا على خلفية سوداء داكنة برع في تكوينها الفنان التشكيلي جعفر طاعون الذي عرف بذكاء كيف يتعامل مع سينوغرافية العرض. ولخلق عالم افتراضي جديد يعمد العرض إلى غرائبية جديدة في تناوله لقصيدة المرايا التي تزخر بالصور المكثفة التي يحيلها المخرج إلى صور تشكيلية متحركة محولاً مفردات النص:
ـ "أحيانا.. يوقفني وجهي في المرآة, أنت تغيرت .. تغيرت كثيراً, أتطلع مذعوراً, لا أبصر في عيني سوى شيخ.."
هنا يقوم المخرج بتوظيف مرايا كبيرة على امتداد حائط عريض ويقوم بإجراء عملية حلاقة معكوسة, أي يحلق ذقنه داخل المرآة بعد أن يضع الصابون على سطحها ثم يكمل القصيدة...
"...... يتأبط عكاز قصائده..... متجها نحو البحر.. يتمرآى في صفحته الزرقاء, فيرى في أعماق البحر ولدا في العشرين, يتطلع مبهورا, في وجه المرآة... لا يدري الآن أيهما كان.."
في هذا الحوار ينشر الممثل الصابون على مساحة المرأة كلها ثم يعود إلى قذف الماء على المرآة من سطل الماء الذي يصنع به التنانير مع مؤثر صوتي للبحر وإضاءة زرقاء, ليخلق جواً افتراضياً محكماً للبحر راسماً بذلك لوحة تشكيلية سمعية بصرية متقنة.
في القصيدة الثالثة يلعب الممثل بمفردة العرض (التنور) محولاً إياها إلى دلالات متعددة (واسطة نقل, سفينة, قطار, مكان اجتماع مع الفتاة الأوربية, مكان للمضاجعة, الآخر.... الخ) وإذا كانت القصيدة تختتم بمفردة (الرئيس) التي تتكرر ثمانية عشر مرة ترافقها ثمانية عشر صفة, مثل: متاحف, شوارع, غيوم, تماثيل, توجيهات....) فأن المخرج عمد إلى بناء جدار عازل من الصخر بينه وبين البلاد التي تحولت إلى ملك للرئيس, وهو مستوى عزل ضمني جديد ليس بين الممثل والجمهور ولكن بين الجمهور المتمثل بشخصية صانع التنانير وبين الوطن كله المتمثل بشخصية الرئيس.
إن محاولة المخرج بناء عالمين افتراضيين يشكل الحضور فيهما معنى للغياب جعل من المفردة الشعرية أداة طيعة في التحول والاستجابة السريعة للعب المسرحي فضلاً عن محاولة خلخلة الحواس باستخدام الضوء والصوت وإمكانيات جسد الممثل المطواعة جعلت من التنور عرضاً مسرحيا ساخناً دق باب التجريب بعنف في بلاد تغطيها الثلوج على مدار العام.
(*) نشر في موقع "الحوار المتمدن" العدد: 819 - 29 / 4 / 2004 وموقع "كتابات" 28 نيسان 2004
|