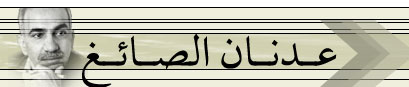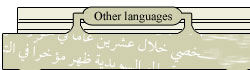|
ثقافة العنف في العراق .. بين عبود والصائغ
د. فلاح طاهر falahtahir@hotmail.com
تابع البعض كتاباً صدر مؤخراً للكاتب سلام عبود تحت عنوان "ثقافة العنف في العراق"، ورغم نبل المهمة في تعرية الثقافة الفاشية والعنف في العراق، وهذا ما أكده كثيرون، إلا أن بعضاً من "الخبط" المتعمد أو غير المتعمد في زج الأسماء النظيفة مع الأسماء المشوهة في سلة واحدة، والانتقائية القاصرة واجتزاء بعض النصوص وقلب المعاني وتفسيرها وفق مقاصد معينة، انحرف بالكتاب عن غايته الوطنية النزيهة، والتي كان يمكن أن يكون مشروعاً ثقافياً وطنياً لو توخى به الفرز والدقة.. وكان من ضحايا هذا الخلط و"الخبط" شعراء وأدباء عراقيون مبدعون كثيرون ومنهم الشاعر عدنان الصائغ.. وإذ أقدم للقراء هذا الفصل من حوار الشاعر عدنان الصائغ الذي ذكرته سابقا، والذي ناقش فيه كتاب الأستاذ سلام عبود، لكي نطلع – نحن القراء والمهتمين - على وجهتي النظر، للمشهد كاملاً..
عندما فاتح السيد سلام عبود الصائغ بمشروعه للكتابة النزيهة الجادة عن أدب الداخل، ماله وما عليه، واعطاء كل ذي حق حقه. ولأنه يفتقد لبعض المصادر ومنها مجاميع الصائغ، فقد طلب بعض ما لديه من كتب ونصوص، فوضع الصائغ بين يديه مجاميعه الشعرية وكتاباته الصادرة في الداخل، ومجموعة من كتب ونصوص عدد من شعراء وأدباء الجيل الثمانيني والتسعيني في العراق، بعضها من كتب الاستنساخ اليدوي، بحجم الكف التي انتشرت أواسط وأواخر التسعينات، والتي تسللت إليه منهم بطرق شتى..
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يأخذ عبود تلك النصوص المشتعلة بتوهجها وعذاباتها وصدقها وصراخها المكتوم؟.. وما الذي أخذه من مجاميع الصائغ الست؟
اترككم مع الصائغ:
* اطلعتُ مؤخراً على كتاب الكاتب سلام عبود "ثقافة العنف في العراق" ورأيت فيه جهداً مبذولاً، وقبل أن أبدي ملاحظاتي السريعة هنا، أجد من الانصاف القول أن هناك العديد من الجمل أنصفني بها الرجل.. وأنصف آخرين من الكتاب..
لكن هذا لا يمنعني من القول أن هناك الكثير من الأسماء الرائعة حقاً، نصوصاً ومواقف وذوات شفافة، لم تكن تستحق هذا الجلد والقسوة أبداً، زجها صديقنا عبود - سامحه الله - في كتابه، وخلطها مع أسماء أدباء السلطة والعنف..
وقام بصفها جميعاً - في كتابه - بالتساوي وكأنها صف واحد.
هذا الخلط – سواء قصد ذلك أم لم يقصد - أساء للحركة الثقافة العراقية برمتها.
وأجد من البديهيات القول أن هناك أسماء ذكر بعضها - وغفل عن ذكر بعضها الآخر- تستحق هذه القسوة في النقد فقد مارست قهراً على الأدباء وشوهت المشهد الثقافي العراقي بممارساتها وطروحاتها ونصوصها الموغلة بالدم والعنف والفاشية، ولا مأخذ لنا أبداً على ما ذكره بحقهم.
لكن تبقى المآخذ الأخرى على كتابه كثيرة - وليعذرني - ومنها أن ثمة نظرة قاصرة أو ناقصة في رؤية بعض النصوص، وتحليل خطابها المستتر، من خلال جحيم ورعب الواقع الذي كُتبت فيه - لا من خلال صقيع المنفى وحريته حيث يعيش هنا بأمان بعيداً عن كوابيس الرعب والموت - هناك "في الزمن الظالم" الذي لم نستطع الهرب منه كما فعل هو وأقرانه، حيث "يكون التعبير الفني - كما يصفه الكاتب نفسه في أبلغ وصف - ضرباً من ملاعبة الأفاعي السامة".
وإذ خصص لتجربتي الشعرية مساحة واسعة من كتابه، إلا أنني رأيته – للأسف - لم يشغلها إلا ببضعة أسطر مقتطعة من نصوصي بشكل أقرب للتشويه، صافحاً النظر عن أكثر من ثلاثة أرباعها التي ربما لم يكن قد قرأها. وحتى هذه المختارات التي انتقاها لم ينشغل بتحليلها والتوغل داخلها والتمعن بها، مكتفياً بالسطح فقط، سطحها المخادع الذي كان لابد منه لتسريب هذا الغضب العاج بين حنايا القصائد. وكنت أتمنى أن يلامس شيئاً منه، ليعطي حكمه ونتائجه بانصاف.
وكان لصديقي عبود أن يتجنب الكثير من مثل هذه المزالق لو قرأ نصوصنا بلا نيات مسبقة.. لو تأنى.. لو تفحص لو دقق لو استشار صديقاً مخلصاً له.. لو أعطاه لناقد أو أديب مطلع يراجعه له كما يعمل الكثير من الكتاب المعروفين والمرموقين وليس في ذلك انتقاصاً أو عيباً
وكان يمكن لكتابه أن يكون جهداً موفقاً لو أنه تعامل مع حيوات النص بمسؤولية وحرص وحياد، وتخلى عن مهنة استنطاق النصوص بأي وسيلة كانت، حتى ولو علقها من أقدامها بمروحة السقف كما يحدث في أي مديرية أمن في بلاد الخراب التي عذبتْ وشرّدتْ نصفَ أبنائها، وعذراً للتشيبه، لكن صدقاً هكذا أحسست وأنا أتصفح كتابه لأجد أحد نصوصي معلقاً من قدميه بمروحة سقف مكتبه يريده أن يعترف وفق ما يريد منه أن يعترف،
هذا ما حدث لنصي "مرايا الوهم".
وسأروي لكم كيف حدث ذلك:
كان نصي العاشق المسكين يتسكع حزيناً ومخموراً ويائساً في أحد شوارع بغداد ذات يوم من عام 1985 يبوح بعذابات روحه وقد عاد بعد غياب ليرى المدينة قد تغيرت وحبيبته أنكرت عهدها والمقاهي نسيته. وكان يعتقد أو يتوهم أن النساء سيحفظن عهده وحبيبته ستغسل الشوارع بالدموع وراءه وأن الحمائم ستهجر الحديقة حين ترى مقعده فارغا.. و.. و..
غير أن المحقق وقد قبض على النص لا يقتنع بهذا "الهذر" الرومانسي، فهو لم يعتد هذه المشاعر ولا بد أن يربطها بأمن الدولة و.. و..
ولهذا لابد لنصي أن يعترف.. نعم أن يعترف.. وأن يتكلم بما يريد منه المحقق - الناقد أن يتكلم، ولو تقطعت أطرافه من التعليق أو السياط..!! لا تستغربوا!!!
سأذكر النص "مرايا الوهم" ص19-21 من ديواني" العصافير لا تحب الرصاص – بغداد 1986،
ثم أذكر تحليل صديقي المحقق - الناقد ص10–11 من كتابه " ثقافة العنف في العراق" كولونيا – ألمانيا 2002
وسأترككم تحكمون أو تتفرجون على أغرب وسيلة للاعتراف في تأريخ "مديريات أمن النقد العراقي المعاصر"..
أورد القصيدة هنا كاملةً:
"توهمتُ أنَّ النساءَ سيحفظنَ ودي/ وانَّ المدينةَ - تلك الضياع الكبير -/ ستذكرُ وجهي/ إذا ما تغرّبتُ عن ليلِ حاناتها - ذاتَ يومٍ -/ وأن المقاهي ستسألُ صحبي/ لماذا تأخّرَ/ عن شايهِ والجرائدِ؟/ في أيِّ بارٍ تشظّى…؟/ بأيِّ الزحامِ أضاعَ أمانيهِ والخطواتِ؟/ على أيِّ مصطبةٍ داهمتهُ طيورُ النعاسِ المفاجيءِ/ فأنسلَّ من بين أحلامهِ والجنونِ…/ ونامْ/ توهمتُ أنَّ الجرائدَ – يا للحماقةْ -/ سترثي رحيلي المبكّرَ…/ إنَّ عيونَ التي/ قايضتني الندى، باللظى/ والقصيدةَ، بالبنطلونِ القصيرِ/ ستغسلُ أخطاءَها بالدموعِ، ورائي../ توهمتُ أنَّ الحمامَ الذي كان ينقرُ نافذتي، في الصباحِ/ سيهجرُ أعشاشَهُ، في الحديقةْ/ إذا ما رأى مقعدي فارغاً../ والكتابَ الذي فوق طاولتي/ مطبقاً, صامتاً / والأزاهيرَ كالحةً لا ترفُّ/ توهمتُ…/ يا ليتني ما صحوتُ من الوهمِ, يوماً/ فأبصرُ كلَّ المرايا مكسّرةً/ والمساءاتِ فارغةً، في المدينةِ، حدَّ التوحشِ/ لكنني…/ بعد عشرين عاماً مضينَ (.. وماذا تبقى؟) سأمضي مع الوهمِ…/ حتى النهايةْ..." - آب 1985 بغداد -
والآن لنرى كيف جاء تحليله ونقده؟
يقول:
(لقد أرغمتْ الحرب لطولها وقسوتها، الجميع على تحسس موضع الخطر فيها، فهي كما قال جواد الحطاب لم تكن مجرد نزهة رومانسية وحتى الشعراء الأكثر توفيقاً في المجال المهني كعدنان الصائغ، الذي طالما ذيل كتبه متباهياً بمكانته الأدبية وبما حققه مهنياً خلال فترة وجيزة، وهو دون شك يستحق ذلك، حيث "عمل محرراً ثقافياً في جريدة القادسية وكذلك في الطليعة الأدبية والجمهورية ومجلة الكتاب ومسؤولاً للقسم الثقافي في حراس الوطن ورئيساً لتحرير مجلة أسفار ورئيساً لمنتدى الأدباء الشباب"، كل هذا الزهو المهني لم يجعله بمنجاة من ورطة الوهم، ولم يحجب عن روحه الاحساس بالانكسار "توهمتُ… يا ليتني ما صحوتُ من الوهمِ, يوماً/ فأبصرُ كلَّ المرايا مكسّرةً/ والمساءاتِ فارغةً، في المدينةِ، حدَّ التوحشِ".. بيد أن الصائغ مثل كثيرين من أسرى الداخل لم يكن قادراً على مغادرة هذا الوهم)
يالهي، أي لوي مارسه الناقد عبود لنصي هذا كي يلائم طروحاته. وكيف راح يفسره على هواه مختلقاً له معانٍ وتفسيرات غريبة..
وليت صديقي عبود التفتَ - على الأقل- إلى تأريخ كتابة النص المثبت لديه في الديوان لرآه بأم عينيه "آب 1985 بغداد" وفي ذلك التأريخ كنتُ جندياً مرمياً في سواتر الحرب الجهنمية. لم أعمل حتى مصححاً في أي جريدة بعد!! ولا أملكُ زهواً مهنياً ولا بطيخاً
وما امتلكتُ هذا الزهو وما ادعيته بكل حياتي.
كيف يمكن أن أثق بهكذا تحليل لنص عن الحب والهجر ونسيان المدينة والمرايا والأحبة والحمام للعاشق المخذول بعد أن تنكرت له حبيبته وقايظت قصيدته الملتهبة، ببنطالها القصير.
لقد عدتُ - وكنت وقتها جندياً - من جبهة الحرب، إلى المدينة لأجد كل شيء مخرباً. وأردت أن أعبر عن خلجات روحي فلم أجد أمامي - في زمن الرقابة الحديدية والرصاص - سوى الرمز..
هذه هي القصيدة كاملة وهذه هي دلالاتها. فكيف قلب السيد عبود المعنى؟ كيف توهمه أو حرّفه؟ كيف حلّله؟ كيف ابتكر له تفسيراً عجيباً غريبا؟ً تفسيراً ملتبساً لا أدري كيف تفتق عنه ذهنه حقاً..!؟ إذ يرى النص إنكساراً لوهم "الزهو المهني" الذي حققته الشاعر.
ولو قلب هذا الديوان، ولو قلب دواويني الأخرى كلها بين يديه لرآها انكساراً يجر انكساراً..
أين "بيت القصيد"- كما يقول النقاد العرب القدامى - من تحليلاته وتخيلاته؟ وأين مكان هذه القصيدة من ثقافة العنف..!؟
أكانت رغبة منه أن يظهر كتابه سميكاً بأي تحليل أو حشو كان؟.. أم ماذا؟
كان بأمكانه لو أتعب نفسه قليلاً أن يغرف من نصوص المديح والزهو والعنف لدى بعض الأدباء ما يملأ به مئات المجلدات. فلماذا تركها وأمسك بخناقي؟ ما الغاية من ذلك؟
وموضوعة العنف والحرب والمديح - في العراق - لا تحتاج إلى هذا اللوي والالتواء والحشر والاستنطاق بالقوة للنصوص.
هناك براميل ومخازن وأطنان من نصوص العنف في العراق (انظرْ لمتابعة هيفاء زنكنة لبعض ذلك النتاج أو زهير الجزائري وغيرهم، مثلاً) ولو كلف صديقي الطيب عبود نفسه، لو بذل مجهوداً حقيقياً لو قلب الصحف الرسمية لشهر واحد. شهر واحد فقط. وليس عاماً أو عقداً أو عقدين، لخرج بأربع كتب ضخمة وليس بكتاب..
لكنه بدلاً من ذلك راح يخلط حابل النصوص بوابلها، رديئها بجيدها، ضد الحرب بـ"مع الحرب"، لكي يحكم عليها دفعة واحدة بأنها من ثقافة العنف، فهو حين يختار قصيدتي "موت طلقة" مثلاً من الديوان نفسه:
"أعرف أن الطلقة رعناء حد الموت، أسخر منها وأمد لساني حين تمر بهزء"، الخ..
يعتبرها – فوراً - من أدب تمجيد الحرب دون أن يكلف نفسه تحليل خطابها المستتر. بل ودون النظر حتى إلى عنوان الديوان الذي اقتطف منه تلك القصيدة، وماذا يعني في الأقل؟ ولم يقلّب حتى، أو يتفحص القصائد الـ 31 الأخرى ليرى ماذا في غابة الأفاعي التي كادت أن تلدغني مراراً.
ففي الديوان ( وليعذرني القاريء أن أوردت منه بعض المقاطع المتفرقة، ربما لم ينتبه إليها عبود أو لم يشأ الاشارة أو الاقتراب منها ولا أدري لماذا وهي واضحة في دلالاتها، وكنت قد وضعت دواويني ونصوصي وكتاباتي بين يديه، حين التقينا في شمال السويد أول وصولي لها عام 1997)
أقول ففي هذا الديوان نفسه "العصافير لا تحب الرصاص" أبدأ بقصيدة عنوانها "طلقة":
"يهبطُ الغصنُ.. ثانيةً/ ثم يصعدُ/
والبلبلُ المتأرجحُ منشغلٌ بالغناءْ/ طلقةٌ...!/ جثةٌ...!/ يقفُ الغصنُ، مرتجفاً/ لحظةً/ ثم يسكنُ..../ تصمتُ ـ في الغابِ ـ / كلُّ البلابلْ".
وأنتهي بقصيدة "حكمة مؤقتة":
"في ضجيجِ الطبولْ
لكَ أنْ.. تنتحي، جانباً
وتؤجّلَ ما.... ستقولْ"
وبين مفتتح الديوان وخاتمته تموج عشرات القصائد..
تعال معي لنقلب ما بينهما من نصوص، ففي قصيدة "هواجس لا تعني أحداً":
"يكفيني - في هذا العالمِ – يكفيني/ بيتٌ من طينِ/ بنوافذ / من بحرٍ وشجيراتٍ وارفةٍ/ لا يقفُ الدائنُ في عتبةِ بابي – آخرةَ الشهرِ – ولا…/ تكفيني كسرةُ خبزٍ بمساحةِ قلبي/ وكتابْ…! فلماذا يحتجُّ الناسُ على حلمي، ويكيدُ لي الأصحابْ/ أنا لا أطمحُ في كرشٍ منفوخٍ/ وعماراتٍ/ لا أطمعُ أنْ أتسلقَ أعناقَ الخلاّنِ… إلى طاولةٍ فخمة/ ورباطٍ للعنقْ/ فلماذا تتسلّقُ عنقي المهزولْ/ يا خلي…!/ وتفكّرُ، من أيّةِ منطقةٍ / يصلحُ للشنق"
وأقول في قصيدة "الثلاثون" مثلاً:
"ثلاثين أطفأتَ… يا صاحبي/ وها أنتَ منكفيءٌ فوقَ طاولةٍ آخرَ البارِ/ بين القصيدة,ِ والحزنِ/ ها أنتَ من دونِ بيتٍ/ تكدّسُ كتبَكَ تحتَ السريرِ/ وتحلمُ في بنطلونٍ جديدٍ/ وفجرٍ جديدٍ، بوسعِ مجاعاتِ عمرِكَ.."
وفي قصيدة: "تداعيات رجل حزين في ليلة 9 آب 1983":
"هل تبحثُ مثلي… في خارطةِ الكلماتِ المنسيّةِ عن وجهكَ/ هذا/ المغبرّ… من التجوالِ… وأتربةِ الغربةِ/ أمْ تبقى تحت رذاذِ الحزنِ… وحيداً - كشجيرةِ صفصافٍ يابسةٍ -/ تتسكعُ بحثاً عن امرأةٍ… تؤويكَ/ بمنتصفِ العمرِ/ تقاسمُكَ الرغبةَ في تهذيبِ العالمِ بالكلماتِ/ أو الموت، وحيدَين،…/ على أرصفةِ الأشعارْ/ أيّ بلادٍ تعرفُ حجمَ حنينكَ في هذا القبوِ المظلمِ/ تعرفُ أنَّ الشرطي...../ في ساحاتِ العالمِ/ يبقى أكثرَ ظلاً من كلِّ الأشجارْ"..
"آهٍ.. يا صافيةَ العينين/ لماذا لا تفتحُ بعضُ المدنِ الحجريةِ.../
غاباتٍ للعشاق/ وتفتحُ – كلَّ صباحٍ – زنزاناتٍ أخرى"
"هل يكفي – ما في العالمِ – من أنهار/ كي أغسلَ أحزانَ يتيم/ هل يكفي ما في هذا العصرِ من القهرِ/ لأرثي موتَ الإنسانِ / بعصرِ حقوق الإنسان"
وفي قصيدة " ليست هي مرثية لي":
"غرّبتني الأسِرّةُ.. أو/ غرّبتنا الليالي معاً…/ أفي كلِّ يومٍ، سريرٌ جديدٌ / ومنفى…/ وجوعْ/ أفي كلِّ يومٍ،.. سأوقدُ نفسَ الشموعْ/ وأطفئها بالدموعْ/ شمعةً../ شمعةً/ .... وأنامْ"
وفي قصيدة "أحزان المغني ع":
"قيثارتي روحي.. / شددتُ بها/ أعصابي المتآكلةْ / لاشيء عندي غير موّالٍ حزينٍ/ .. ضيّعتهُ الجلجلهْ / فلمنْ أغني..!؟/ والستائرُ مُسدلهْ/ والشارعُ الملغومُ بالخطواتِ / نامَ على رصيفِ المقصلةْ"
وفي قصيدة "أحزان عمود الكهرباء":
هاكَ عمري، وفلّهِ.. يا صديقي/ لن ترى فيه غيرَ الشجونِ/ وهذا البياضِ الوقورِ الذي يقفُ – الآنَ – بين المكاتبِ، والحلمِ../ لن ترى – بعد هذا العناءِ الطويلِ –سوى قلمٍ ناحلٍ/ يتآكلُ شيئاً، فشيئاً / كنتُ أبصرهُ – في زحامِ المدينةِ –/ مندفعاً في شرودٍ.. / إلى بابِ إحدى الجرائدِ/ أو حاملاً كيسَ صمونهِ، والكتابَ.. / إلى بيتهِ / ما الذي ترتجيهِ من الركضِ/ ها أنتَ قطّعتَ عمرَكَ / بين الوظيفةِ، والشعرِ/ ها أنت وزّعتَ عمرَكَ../ لا…!/ أنتَ وزّعكَ العصرُ/ بين الدوائرِ، والشغلِ،/ بين القصائدِ، والجوعِ…/ …، بين الصحابِ، النساءِ، المقاهي، المخافرِ، أبنائِكَ الخمسةِ، طاولةِ البارِ، قائمةِ الكهرباءِ، الغسيلِ على شرفاتِ الفنادقِ، منتصفِ الفيلمِ، لغطِ الإذاعاتِ، طعمِ الفلافلِ، باصِ الحكومةِ، سبورةِ الدرسِ، صفّارةِ الشرطيِّ، الجرائدِ، لائحةِ اليانصيبِ، الأغاني العقيمةِ، كتْبِ الحضاراتِ، بردِ المصاطبِ، ليلِ العواءِ الطويلِ، أزيزِ المراوحِ في القيظِ، شاي المقاهي، الذبابِ، المطابعِ، بطءِ البريدِ، زعيقِ المراكبِ في الشارعِ المتدافعِ، كذْبِ المحلاتِ جمعيةِ الأدباءِ، دخانِ المصانعِ، بائعةِ الحبِ تعلكُ ضحكتها...، الوردةِ الاصطناعيةِ، الهاتفِ المتقطّعِ، بابِ البنوكِ، المعارضِ,.../ قلْ لي متى تستريحُ إذنْ..؟/ هي أعصابُكَ – الآنَ – مشدودةٌ/ بين أعمدةِ العصرِ/ مكتظةٌ بعواءِ المشاغلِ واللغطِ.../ مَنْ يمنحُ العصبَ المتآكلَ، بعضَ الهدوءِ الجميلِ/ على مقعدِ البحرِ/ مَنْ سوف يتركُ طيراً طليقاً/ يتأرجحُ منفرداً, / فوق أسلاكِ أعمدةِ الكهرباء/ مَنْ يُبدلُ - الآنَ – / هذا الموظفَ ذا الربطةَ الأرجوانيةَ اللونِ بالحلمِ...!/ بالأرجلِ الحافياتِ على ضفّةِ النهرِ.../ بالدفترِ المدرسيِّ الممزّقِ.../ بالـ……/ حلمٌ أنْ تعودَ العصافيرُ, ثانيةً/ بعد موتِ الحدائقِ في الروحِ/ أنْ تفتحَ المدنُ الكونكريتيةُ القلبِ شبّاكَها للقصائدِ/ أنْ تستقيلَ من الحزنِ, يا صاحبي!/ حلمٌ أنْ تغني كما تشتهي/ وتسيرَ كما تشتهي
وتموتَ كما تشتهي…!"
وفي قصيدة "ورقة ساقطة من الطلاسم":
"كيف يا ربُّ... خرجنا من تبوكْ
ووقفنا – كالمساكين – بأبوابِ الملوكْ
كيف بدّلنا الرماحَ السمهرياتِ بأوراقِ الصكوكْ
إنْ تكن تدري... فأني لستُ أدري...!"
وفي قصيدة "حادثة مبكرة جداً":
"في زمانٍ قديمْ/ بينما كنتُ أبحثُ عن دفترٍ أبيضٍ للكتابةْ/ عثرتُ على جثةٍ للقصيدة/ مرمية في الطريقْ...!"
وفي قصيدة "تمرين لكتابة قصيدة":
"في زحمةِ الحرسِ المدجّجِ بالشتائمِ، في الليالي الكالحاتِ بلا بصيصٍ، في أغانيكَ الحزينةِ خلفَ نافذةِ القطارِ، وفي بقايا الزادِ والسفرِ الموحّدِ نحو حاميةِ المدينةِ، في الرشاوى، في المكاتبِ، في الدفاعِ المستميتِ عن القصيدةِ…
في التحمّلِ، في التجمّلِ، في العراءْ
وأنا وأنتَ على الطريقِ:
ظلاّنِ منكسرانِ في الزمنِ الصفيقِ…
إنْ جارَ بي زمني
اتكأتُ على صديقي…"..
والخ.. والخ.. من هذا الديوان،"العصافير لا تحب الرصاص" ورغم اشادة الكثيرين له من شعراء ونقاد، إلا أنني – وهذا رأيي الشخصي - لا أعتبره متميزاً بفنيته وبجرأته، قياساً لـ "سماء في خوذة" و "غيمة الصمغ" و"أغنيات على جسر الكوفة" و"مرايا لشعرها الطويل"، وهي منشورة في الداخل.
ولهذه القصيدة التي ذكرتها أخيراً - أي "تمرين لكتابة قصيدة" - ذكرى وحادثة، منفصلان، لن أنساهما ما حييت فقد أهديت هذه القصيدة لشاعر مبدع ونبيل ومرتبك دائماً هو عبد الرزاق الربيعي، من أحب الأصدقاء الشعراء إلى قلبي وأشفهم، وهذا الصديق كانت السلطة قد سُلمتْ لهم - ذات يوم من سنوات الحرب الكالحة – جثة شقيقه عبد الستار الذي لم يتجاوز الثالثة والعشرين عاماً بتهمة الإنتماء لأحد الأحزاب المعارضة، وكانت آثار التعذيب على جسده واضحة ولم يكن هناك اثر للرصاصة بما يؤكد انه استشهد تحت التعذيب، وقد منعوهم من البكاء عليه أو اقامة شعائر العزاء!!.. ورغم ان التهمة لم تثبت عليه لكن عيون رجال الأمن ظلت تتلصص على كل من يزور البيت وقد قطع الكثيرون علاقتهم به خوفاً.
ظل صديقي النبيل في الليالي الموحشات، يجوب أزقة "الدولعي" في بغداد وهو يعوي بصمت جارح..
أما الحادثة فأنني عندما قدمتُ ديواني ذاك "العصافير لا تحب الرصاص" إلى دار الشؤون الثقافية العامة لطبعه، تمت أحالته إلى خبير الدار الذي قرأه ثم أوصى بمنعه وحين اطلعتُ على تقرير الخبير وجدت لديه ملاحظات كثيرة، أذكر منها أنه شطب هذه العبارة من قصيدتي المهداة لصديقي عبد الرزاق:
"في زحمةِ الحرسِ المدجّجِ بالشتائمِ"
مستبدلاً اياها بعبارة من عنده هي:
"في زحمة الدرب المعفر بالأماني"..
كتبتُ طلب اعتراض إلى مــدير عام الدار د. محسن الموسوي، فأحال الديوان مرة ثانية إلى خبير آخر هو الشاعر يوسف الصائغ الذي كان يشغل وقتها منصب مدير عام دائرة السينما والمسرح، وكانت علاقته مع الدولة في أوج ازدهارها
وقد أعجب بالديوان وأجازه كله بلا حذف.. مع كتابة كلمة على غلافه الأخير.. وصدر الديوان
بعد شهور، وفي صدفة غرائبية، كنا: الخبير نفسه وهو شاعر خمسيني، وأنا في أمسية مشتركة مع آخرين في كركوك. وبعد عودتنا ليلاً إلى الفندق وكانت غرفتنا مشتركة أيضاً، شربتُ كثيراً لأتغلب على خجلي وألمي وارتباكي وفاجأته بلا مقدمات بأسئلتي السريعة المتلاحقة: أسألك فقط يا استاذ "..." لماذا بدلّتْ عبارتي تلك. أي درب؟ وأي معفر بالأماني؟ ها هو الديوان قد صدر فما الذي حدث؟ هل انقلبت الدنيا؟ لماذا الخوف والمزايدات بالرقابة وشهوة الحذف والقمع؟
نظر لي طويلاً بصمت ثم أجابني بحرقة وعمق وحنان أبوي شفيف: نعم! يابني!، لقد تقصدتُ حذف هذا المقطع ومنع الديوان. أنت لا تعرفهم هؤلاء الـ.... انهم لا يرحمون، لقد وجدتك شاعراً شاباً، في مقتبل العمر، ومندفعاً، لا تعرف شيئاً عنهم.. كنت خائفاً عليك حينما رأيتك تكتب بهذه الحدة!! يا بني! أليس لك عائلة؟ أليس لك أم أب أخوة أخوات؟
وسهرت أغرب ليلة! وأنا غير مصدق ما تلفظتُ به أمامه، وغير مصدق ما سمعته منه.
كنتُ أتصور أنني أمام رقيب أو شرطي، وإذا بي أجد نفسي أمام شاعر وانسان رقيق وموظف مسكين وطيب..
أروي هاتين الحادثتين، لما لهما من وجع ودلالات يطول شرحها ليرى صديقي عبود من خلالهما مشهد ثقافة الداخل ومعاناة الكتابة هناك وصعوبة الحكم على أديب من خلال موقف أو نص.
عندما التقاني الصديق سلام عبود مؤخراً في ستوكهولم بعد سنوات ودعاني مع الصديقين الشاعرين جاسم ولائي وابراهيم عبد الملك، قلت له: ياسلام عبود، نادِ على هذا الجرسون السويدي الواقف أمامك، واسأله، ما معنى "العصافير لا تحب الرصاص"؟
نعم.. كيف يمكن أن أثق بدارس أو ناقد أو محلل أو حتى جرسون لا يعرف ماذا تعني - على الأقل - عبارة العصافير لا تحب الرصاص..
لكن صديقي الكاتب – وليعذرني - ربما لاستعجاله، أو ضعف أدواته النقدية كروائي وقاص وكاتب، أو لاثبات شيء يعتلج في داخله لا علاقة لي به، أنتهى أو التهى بالسطح غير عابيء أو غير ملتفت لما يمور به عمق البحر أو عمق القصيدة أو عمق الجرح أو أعماق الشاعر..
كيف نرى ونقرأ ونتفحص أي نص، إذن؟
وليسمح لي أن أسترسل قليلاً وأجيب:
أن نكون أكثر صدقاً وحباً وسمواً وتفحصاً وتطابقاً مع أنفسنا ومبادئنا وضمائرنا وإبداعنا، بلا ضغائن ولا حسابات، ولا زوايا نظر محددة أو مجتزئة، وأن لا تكون قراءتنا للنصوص مدبرة أو اعتباطية أو مرتجلة أوساذجة أو ناقصة، لكي نرى الآخر وابداعه ومواقفه على حقيقته، وأن يرانا الآخر هكذا بضعفنا وقوتنا، بجرأتنا وخوفنا.
وأجيب أيضاً: ان نقرأ النصوص على أرض الواقع، بلا اجتزاء وبلا مزايدات..
ليعش السادة المزايدون علينا وعلى جراحاتنا هناك مثلما عشنا، ويعملوا ويكتبوا ويرونا بطولاتهم وكتاباتهم..
وكنت أتمنى أن يكون صديقي عبود باحثاً واقعياً ومنصفاً وساعياً إلى الحقيقة في تحليلاته!! وما بيننا إلا الاحترام والمودة..
ولا ضير أبداً وبعد أن طبع كتابه الضخم واستلم حصته من أرباح النقد الفضائحي المجاني السائد في مثل هذه الأيام، لا ضير أن يستمع إلى وجهات النظر، الكثيرة هنا وهناك سلباً أو ايجاباً شمالاً أو جنوباً بلا تشنج ولا امتعاض. مقدماً لنا دليلاً ملموساً عن ابتعاده عن ثقافة العنف التي مارسها جميع أدباء العراق (عداه هو ونصوصه بالطبع) – كما أثبت في كتابه المذكور – من الجواهري والسياب والبياتي وفؤاد التكرلي وسعدي يوسف وحسب الشيخ جعفر وعيسى حسن الياسري ومحمد خضير وابراهيم أحمد وجنان حلاوي وعبد الخالق الركابي وعدنان الصائغ وحميد المختار.. والخ.. والخ، حتى أصغر أديب تسعيني يجلس الآن في مقهى حسن عجمي ينتظر أن يستلم حصته التموينية من العنف الثقافي..
وعودة إلى أسلوب اللوي وقلب الحقائق أو قصها يشير صديقي عبود –في موضع آخر - إلى أن قصائدي في دواويني التالية كغيمة الصمغ أخذت تنتقد أو تدين الحرب.
وهذا اعتراف جميل لا أدري كيف خرج منه.
لكنه يستدرك بسرعة ليطرح تصوراً عجيباً غريباًً لا يقل برودة دم عما سبق فيرى أن إدانة الحرب في قصائدي جاءت بعد أن بدأت السلطة تمهد للسلام وتنتقد الحرب.
إن أي متابع بسيط يدرك أن السلطة لا تزال حتى هذه اللحظة تلعلع بتمجيد "كونات" قادسية صدام وأم المعارك ويوم النصر العظيم ويوم الزحف الكبير.. والخ.. والخ.
ويستمر الصديق عبود في طروحاته الغرائبية مرة أخرى فعلى سبيل المثال لا الحصر
يصف الصديق القاص فيصل عبد الحسن حاجم، حالنا، حال الجنود في سنوات الحرب حيث الموت بالمجان قائلاً:
".. كان الايرانيون يريدون قتلنا من الخطوط المواجهة لنا، وفرق الاعدام خلفنا، وحزب النظام يهدد في المدن التي نسكنها بالانتقام من أهلنا في حالة الفرار.."
وأمام قسوة مشهد دموي سائد كنا نعيشه يومياً، ربما لم يكن صديقي عبود قد سـمع به وهو يتصدى لهذه المهمة الصعبة والمهمة برأي
مهمة الكتابة عن نصوص الحرب ونصوص الداخل.
نسمع عبود ولأول مرة يسترسل بوجع وبشكل مختلف - وجميلٌ جداً أن يسترسل هكذا - فيقول بصوت مخنوق:
"إن من الجنون مطالبة كاتب عراقي يعيش في الداخل بالكتابة عن فرق الإعدام أو فرق التنكيل بالأهالي، ذلك سخف وتفاهة. لكننا لم نرَ في الوقت نفسه ظلالاً ولو باهتاً لتلك الفرق، لم نعثر على بقع مجهرية من الخوف من تلك الفرق مرتسمة على قلوب وملامح أولئك البؤّس المقادين على مدار عقود من الزمن إلى ساحة الحرب والموت، فحتى الموتى كنا نراهم يبتسمون أو يعودون إلى بيوتهم للتلصص على ذويهم الأحياء الذين زغردوا حينما جيء بجثثهم ممزقة.."
لا يا صديقي عبود أقول لك بثقة واصرار هناك العشرات من النصوص المدمّاة، هناك المئات من صور الحزن والغضب الواضحة في نصوص أغلب الذين ذكرتهم والذين لم تذكرهم وهم كثر، لكنك لاتريد أن تراها، وتصر على انها غير موجودة في أدبنا.. وهذا ما يسعى إلى تأكيده الإعلام الرسمي ليل نهار ومنذ أكثر منذ عشرين عاماً عبر وصفه ليل نهار "للروح المعنوية العالية للجندي والكاتب معاً على خط النار، مروجاً لالتحام الجماهير مع القيادة الحكيمة في معارك التحرير"..
وغير هذا الأدب المنشور الذي استطاع مؤلفوه تسريبه كما بينت ذلك، هناك الكثير من النصوص المخبأة، في انتظار فجر الخلاص..
لقد قرأنا في الداخل، الكثير من هذه النصوص المخبوءة وسأذكر قصة لقاص عراقي معروف أتجنب الاشارة إلى أسمه الآن، لأنه مازال يعيش في الداخل. القصة تصور جنود مفرزة الأعدامات وقد صفوا أمامهم مجموعة من الجنود العراقيين الفارين من الجبهة. أحد هؤلاء الجنود الفارين كان ضخم الجثة يصرخ صراخاً مراً وموجعاً يقطع أنياط القلب وعبثاً حاولت لجنة الاعدام ايقافه واسكاته. كان يتقافز هنا وهناك متشبثاً بالحياة بشكل غريب. هذه القصة بالطبع لم يستطع كاتبها رغم تمويهاته الذكية أن يسربها للنشر. وغداً حينما يقيض له أن يهرب وعائلته من البلد كما فعل الذين قبله وينشرها سيجد صديقنا عبود يقول له ببساطة وبرودة دم مثلاً "إنها من نتاج أدب الخارج وليس الداخل"..
وكان من المضحك المبكي أن أقرأ مثل هذا الكلام عن ديواني "نشيد أوروك" الذي استنزفني عمري هناك حينما بدأت كتابته في اسطبل مهجور للحيوانات عام 1984 وتنقل معي في محطات منفاي بعد خروجي من الوطن عام 1993 حتى وصولي بيروت صيف 1996 وطبعه هناك، ليقدم مشهدا بانورامياً عن الوطن والمنفى معاً.
يقول عنه عبود ببساطة شديدة جداً: "بتقديري الشخصي إن نشيد أوروك هو من نتاج الخارج وليس من نتاج الداخل"..
كيف قدر يا ترى أو تصوّر أو أطلع أو رأى أو حلم أو تكهن بذلك!!؟ أي فتاح فال؟ أو عصفور أخبره بذلك؟
والكثير من الأصدقاء والأدباء يعرف تفاصيل كتابة النشيد أو شاهد في بغداد مسرحية الهذيانات بعرضيها: الأول عام 1989 والثاني عام 1993 اللذين أُعدا عنه، وقُدما في أكاديمية الفنون الجميلة ومسرح الرشيد، وفي حوزتي شريط فيديو عن عرضه الثاني. هذا أولا.
وثانياً:عندما قدمت النشيد للطبع عام 1995 رفضت الرقابة الأردنية الموافقة على طبعه، وعندي كتاب رسمي منهم. وأسأل كيف يمكن لأي كاتب أو حتى كاتب عرائض انجاز عمل شعري بهذا الطول والوثائق والاستشهادات والتضمينات خلال عامين (أي من عام خروجي من العراق 93 إلى عام تقديمه في الأردن 95 أو طبعه في بيروت 96). وقد حُشر الديوان حشراً في طبعة بيروت عام 1996 بـ 232 صفحة. والكتاب لو طُبع بشكل طبيعي لكان يربو على 600 صفحة.
ويضيف عبود في موقع آخر من كتابه: (أما عدنان الصائغ فيؤرخ تأليف كتابه نشيد أوروك" بين عام 1984-1996 ومن بين أماكن كتابته: معسكرات وسجون واصطبلات. ويوضح أنه "رمي لمدة عام ونصف في اصطبل" - مجلة الدستورية ع 14 فبراير 1997 - لكنه يعدل من ذلك في مجلة الوطن العربي فيقول: "بعد أن مُنعتْ كتاباتي في العراق على أثر صدور ديواني تحت سماء غريبة في لندن العام 1994 حينما رأت فيه السلطات العراقية تهكماً وتهجماً على شخصية ديكتاتور بلدي، لم استسلم للتهديدات والملاحقات فكتبتُ هذا النشيد رداً على سياسة القمع والارهاب" - مجلة "الوطن العربي ع 1041في 14/2/1997")
وأضيف على ما قلته سابقاً: لو كلف الصديق عبود نفسه وقرأ جيداً - وبلا استعجال - صفحتي المقابلة نفسها، لوجدني أقول فيها قبل هذا الكلام ببضعة أسطر فقط: "لقد كلفني هذا العمل اثني عشر عاماً من عمري"
لو قرأ ذلك لأدرك بنباهة ولانتبه ببساطة إلى الخطأ المطبعي الذي قلب كلمة "نشرتُ" إلى "كتبتُ".
وليس صعبا معرفة هذا الخطأ من قراءة معنى السطر.
مشكلة عبود انه لا يقرأ أو يقرأ وذهنه سارح يريد فقط مسك أي كلمة أو نقطة أو فارزة حتى لو كانت خطأ مطبعياً ليضيفها إلى رصيده في ثقافة القمع.. والأمثلة كثيرة أكثر من أن تعد وتحصى.
بل حتى أن الكثير من السطور العابرة التي يقولها تعليقاً على جملة أو رأي أو تحليل أو اضافة أو ذكر أسم أديب نجده لا هم لديه إلا حشره في مديرة أمن ثقافة العنف تلك، ممارساً عليها ربما عنفاً أشد.
وأخيراً أقول بألم وعتاب شديدين:
إن ما أثار استغرابي، وقرفي معاً، هو حشر سطر من عنده إلى أحد نصوصي حينما أضاف لها متبرعاً هذه الجملة:
(من القائد.. إلى الفاو)
وليس في نصي المذكور، ولا في نصوصي الأخرى ولا في دواويني وكتبي كلها مثل هذا السطر.
وهذا أمر منافٍ للأمانة الثقافية والانسانية.
ولا أدري لماذا فعل ذلك؟
وهي نقطة محيرة لم أجد لها تفسيراً
ترى لماذا كان صديقي عبود مصراً أن يمضي في تسويد مشهد الإبداع العراقي برمته إلى النهاية.
ولأي هدف أو غرض في نفسه، لا يريد أن يجد أو يرى فيه نافذة واحدة مشرقة..
إن خطل هذه النظرة السوداوية وخطورة مثل هذا الطرح يمكن أن تنعكس على كثيرين – مثقفين وقراء - ربما لم يكونوا قد اطلعوا على نتاج الداخل. وقد ذكرت ذلك الأمر في رد لي تحت عنوان "قراءة ناقصة لمشهد ثقافي كامل" (صحيفة المؤتمر ع 296 في 16-22/3/2002) قلتُ فيه: "ومما يؤسف له أن هذا الاستقراء الناقص للاستاذ عبود قد جر استاذاً، وقلما رشيقاً وشيقاً، كالدكتور الأعرجي إلى إطلاق أحكام كانت أشد مضاضة على أدباء الداخل من كل قنابل الحرب التي سقطت على رؤوسهم. وكان الأجدى به وهو الناقد الحصيف - وقد غاب المشهد عنه كما يقول طيلة تلك الأعوام – أن لا يكتفى بكتاب العنف هذا دون أن يقرأ أو يطلع بنفسه أو يسأل – في الأقل - مؤلفه سلام عبود: أهذا هو كل الأدب العراقي!.."
لقد كان الكاتب سلام عبود والدكتور محمد حسين الأعرجي وغيرهما محقون مع أسماء اساءت وشوهت المشهد الثقافي، لكن من جانب آخر – وهذه نقطة خلافي معهم – هناك الكثير من الأسماء الإبداعية في الداخل كانت عكس هؤلاء تماماً، إذ قدمت - خلال العقدين المنصرمين ولا زالت - أدباً راقياً، شكلاً ومضمونا، بعيداً عن ثقافة العنف..
نعم كان صديقي عبود كثير القسوة والتجني مع نصوص وأسـماء وضعها في خانة العنف والسلطة والدم وهي لبست كذلك أبداً: رشدي العامل محمد خضير محمود جنداري حسن مطلك فيصل عبد الحسن وارد بدر السالم عبد الستار ناصر عبد الخالق الركابي أحمد خلف جاسم الرصيف علي السوداني علي الشلاه حميد المختار ابتسام عبد الله حسب الله يحيى خزعل الماجدي زيدان حمود عائد خصباك كزار حنتوش عبد الرحمن مجيد الربيعي عبد الرزاق المطلبي غازي العبادي فؤاد التكرلي فاتح عبد السلام محسن الخفاجي محمد حياوي محمد مزيد محمد شاكر السبع محمود عبد الوهاب مهدي عيسى الصقر مهدي جبر هادي الربيعي وغيرهم. وعشرات من أدباء الداخل وحتى أدباء الخارج وقد ذاقا من الظلم والعنف ما يفوق الوصف.
هناك الكثير ممن فاتني ذكرهم..
وهناك الكثير الكثير:
أسماء ظالمة وأخرى مظلومة وتفاصيل ملتبسة وتحليلات ساذجة وأمور مختلطة. أترك للباحثين والنقاد والأدباء والقراء والزمن وله أيضاً مناقشتها وتصحيحها بضميرٍ ومسؤولية.
نشر في موقع "كتابات" 7-7-2003
|