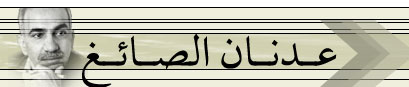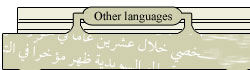|
شهادة عن الجيل الثمانيني في العراق
المنفى الآخر
عدنان الصائغ
"ويحك يا ننار لقد هوت مقدسات أور وذبح البرابرة
شعبك. لقد تشرد القوم وأصبحت أور خراباً" - مقطع من "مرثية أور" 2000.ق.م -
"أشش .. وإلا سينتفض الندى المتخفي بأستار أجفاني ففي
تلك الظلمة المعبّأة بالحرس في قبر الليل الذي يسع
الكثيرين. لنقل كل شيء بهدوءٍ في القلب" - ياروسلاف سيفرت – شاعر جيكي -
نهاية الثمانينيات وقاعة مسرح الرشيد غاصةً بالحضور أثناء مهرجان بغداد المسرحي، وقد امتلأت المقاعد كلها ووقف الكثيرون وأنا معهم على الجانبين في انتظار أن تُفتح الستارة .. لكن ضجة غير طبيعية حدثت خارج القاعة أدارت الأنظار إليها، أشخاص بالملابس الزيتونية يهرولون دخولاً وخروجاً، آخرون بأيديهم أجهزة لاسلكية يتفرسون بالوجوه، دقائق مهولة من الانتظار المشوب بالخوف والترهب كانت تسود الأعناق المشرئبة إلى البوابتين .. لحظةً ودخل أحدهم منتفخاً بخطىً حديدية نظر إلى القاعة من فوق إلى تحت ومن جميع الزوايا ثم أعطى أوامره لرجاله حيث انزرعوا بأسرع من لمح البصر في كل الأماكن، وبعد أن تم له ذلك خرج مسرعاً، ليدخل آخر أكثر انتفاخاً وجموداً. نظر إلى الصف الذي كان يجلس فيه الوزير لطيف نصيف جاسم والذي قد أُفرغ إلى النصف فوراً، إلا انه كما يبدو لم يقتنع فأمر حارسيه أن يفرغا صفاً جديداً أمام الوزير... فغر الحارسان فاهيهما دهشةً وهما يريان صعوبة القيام بمثل هذا العمل خاصةً وان بعض المقاعد تحمل ضيوفاً وفنانين وأشخاصاً لهم وزنهم و... و... إلا انهما مضيا لا يلويان على شيء .. كانت عيناي مفتوحتين إلى أقصاهما وكذلك أذناي في محاولة لتسجيل كل ما يحدث، والتقاط المشهد من كل جوانبه، أن مهمة الكاتب أن يكون رائي عصره و"الشاهد على ما يحدث في وطنه " كما تصفه نادين جورديمر.
راح الحارسان يحاولان بجهد جهيد اقناع الجالسين في الصف الطويل بالتخلي عن أماكنهم، وكان الأمر يلقي سهولة حين يكون الجالس عراقياً إلا أن بعض الصعوبة كانت تجابههما حين يكون الجالس عربياً ... عندما وصل أحد الحارسين وكان ضخم الجثة إلى أحد المقاعد همس في أذن شاغله بسرعة دون أن يكلف نفسه بالشرح حين رأى أنه أمام شخص عراقي، لكن الشخص الذي لم أكن أرى منه سوى قفاه امتنع عن القيام وسمعته يقول بأنه: "مدير عام في........"
لم استطع التقاط الكلمات الأخيرة لكنني خمنتُ من حركة الحارس الجمهوري انه شخص مهم بدليل انه تركه بأدب وانحنى ليمر من أمامه باتجاه سيدة ليهمس في أذنه شيئاً، فما كان من السيد المنتفخ إلا أن هتف بصوت واضح وبارد: "سوكه عجل".
التفتُ إلى رقبة الرجل وأحسستُ بعروقها ترتجف تحت ياقة قميصه المنشاة ثم وقبل أن تصله الكف الضخمة نهض من مكانه وانسل بين الجمهور...
خرجتُ مع أبني مهند إلى الصالة فأوقفني أحدهم بنظرات حديدية: الى أين؟ قلتُ له أن ابني يريد الذهاب إلى التواليت.. تفرس في وجهينا طويلاً ثم سمح لنا. في باب المرافق الصحية للرجال والنساء وقف أحدهم يتفرس في وجوه الداخلين والخارجين.. بقيتُ في الصالة أرقب وجوه بعض الفنانين والمثقفين العراقيين والعرب وقد تسمروا في الصالة. لا يسمح لهم بالخروج حيث أُوصدت الأبواب جميعاً ووقف حراس غلاظ يمنعون الدخول والخروج وعبثاً حاول الصحفيون ولجان التحكيم الذين كانوا يتنقلون بين المسرح وفندق "المنصور ميليا" أن يقنعوهم بالسماح لهم بالخروج تلبية لمتطلبات عملهم ولمواعيد صحفية مهمة ومستلزمات تحكيمية تخص المهرجان، إلا انهم جوبهوا بوجوه جامدة لا تتحرك وعيون لا ترمش..
رأيت سلوى النعيمي وصحفي عربي معروف آخر نسيتُ أسمه، يتذمران من هذا الاجراء غير المعقول إلا أن أحد الفنانين من موظفي السينما والمسرح ركض باتجاههما متوسلاً أن يهدأا لأن الأمر كذا وكذا...
سمعتُ ابني مهند يصرخ: بابا.. بابا، هرعتُ إليه فوجدته يرتجف بيد أحد الحرس الذي بادرني بالقول: هذا ابنك؟ أجبتهُ هلعاً: نعم، ماذا في الأمر؟ قال: كان يحاول الاتصال بالهاتف العمومي. ممنوع .. أجبته وقد فهمتُ الاشكالوية على حدّ تعبير صديقي خضير مري الذي تركته في إحدى مصحاة بغداد:
- انه طفل لا يفقه شيئاً وهو مولع بالتكلم في الهواتف.
دفعهُ إليّ متجهماً وانزرع أمام الهاتف كأنه عمود .. حين عدتُ إلى القاعة التي كانت ساكنة كأن على رأسها الطير. حتى لأكاد أسمع شهيق أنفاس من حولي .. لحظات وسمعنا الهرولة من جديد وتراكض الأقدام والدفع بالمناكب وما هي إلا دقائق حتى أطلتْ وجوه جديدة أخذت تتفرس في المكان وتعطي أوامرها بالنظرات، فتبدلتْ مواقع وتغير حراس ثم دخلت نساء لهن هيئة الخدم الرئاسي وبعدهن مربيات عديدات .. ثم .... دخلت "حلا".
نظرتْ إلى الصف الفارغ للنصف حيث هب الوزير بعينيه الزئبقيتين باشاً هاشاً لمقدمها، إلا أنها أشاحت بنظرها وتقدمت بخيلاء وأبهة نحو الصف الذي أفرغه الحرس الرئاسي، وجلست في المنتصف تحيطها الوصيفات والمربيات. لم تكن قد تجاوزت الثالثة عشرة من عمرها إلا أن الهالة الرئاسية جعلتها تبدو أكبر سناً بقليل، وعلى مقربة منها جلس أطفال عديدون كان أحدهم علي بن حسين كامل، كما تهامس البعض, ولأن مهند لم يكن يفهم بأعوامه الستة ما الذي يحدث، ولماذا نحن واقفون بينما هذه الكراسي الفارغة قريبة منا فكان يتسلل من بيننا ليجلس على أحد المقاعد فيتقدم منه الحرس ليبعده وهكذا تكرر المشهد بوضعيات مختلفة حتى غدا لوحده مسرحية ألهتني والبعض عن متابعة ما يدور على خشبة المسرح..
ويبدو أن الحرس ضجروا أو اطمئنوا أو انشغلوا عن إبعاد مهند الذي اقترب من الطفل الرئاسي المدلل (الذي سيُذبح أبوه وأعمامه بعد سنوات) وبغريزة طفولية بدءا يتجاذبان الكلام والقهقهات على بعض اللقطات الظريفة وحين لاحظ الحرس أن الطفل الرئاسي بدا مرتاحاً لوجود هذا الطفل الشعبي الحشري كفّوا نهائياً عن إبعاده.
بعد أن انتهت المسرحية(ولا أدري كيف بدأت وكيف انتهت) وخرجت أبنة الرئيس بموكبها المهيب أولاً، وبعد ان مرت فترة طويلة سمحوا للفئران البشرية أن تخرج من عنق الزجاجة ..
لا ادري لماذا مرّ هذا الشريط الأسود في ذاكرتي وأنا أجلس الآن أمام صخرة الروشة مستسلماً لرذاذ أمواج البحر وهي تغسل روحي من صدأ السنوات، وتأخذني بعيداً عن هناك..
هناك حيث دفنا في الثكنات والأقبية أجمل سنوات عمرنا، هناك حيث يعيش ما تبقى من جيلنا ضياعاً كاملاً بين رماد حربين وحصارين مزدوجين وتهميش مُرٍّ على مستويين: حياتي وابداعي، هناك حيث يتوزع أصدقاؤنا على الأرصفة يبيعون كتبهم من أجل لقمة العيش وحيث يتفسخ بعضهم في الزنزانات، هناك حيث اختفى صديق طفولتي الشاعر علي الرماحي قبل ثماني عشر عاماً حين دفعه أربعة رجال غلاظ الى سيارة لاندكروز بيضاء على مبعدة شهقة من حنجرتي اليبيسة، هناك حيث أعدموا صديقي الكاتب حميد الزيدي رمياً بالرصاص لأنه حاول التسلل عبر الحدود هرباً من الزنزانة الكبيرة، وحيث جُنَّ الروائي عبد الحي النفاخ وظل يتمشى كل فجر بدشداشته البيضاء المخّرقة على ضفاف شاطيء الكوفة وهو يحاكي نفسه .. (بعد سنوات، كنا: جبرا ابراهيم جبرا وأنا نجلس في مقهى فندق القدس في عمان، حدثته عن حكاية روايته "البحث عن وليد مسعود" فقد استعارها حميد الزيدي من صديق أُعدم قبله ثم انتقلت الرواية من حميد إلى عبد الحيّ ومنه إليّ وقد تركتها قبل سفري عند "...."(1) فظل جبرا يرتجف رعباً).
أمرّ على البيكاديللي باتجاه شارع الحمراء ثم انعطف على مقهى المودكا فأرى غليون الشاعر بول شاؤول يسرّح غيوم الحداثة، يسألني عن أخبار الأصدقاء في العراق؟ تعلو صوتي غصة مخنوقة وأحتارُ من أين أجيبه..
منذ أن وطأتُ بيروت قبل شهرين متسللاً من دمشق قادماً من عمان في رحلةٍ مضنية والأصدقاء يسألوني عن شتاتنا: الياس خوري، علي سرور، شوقي بزيع، حسن داود، اسماعيل فقيه، أنسي الحاج، شوقي أبو شقرا، يحيى جابر، غادة فؤاد السمان، مردوك الشامي عناية جابر، عبده وازن، وعبيدو باشا، ولا يجدون على شفاهي سوى الدموع ..
أتطلع إلى وجوه الأدباء هنا، مرتوية، هادئة الأنفاس، انهم لا يتلفتون كثيراً في نقاشاتهم وأحاديثهم خشية وجود مخبر كما يحدث في بلدي ..
ينحني النادل الأنيق بعنقه الصقيل أمامي ليسألني بهمس عما اطلبه، أتذكر عنق المدير العام الذي كاد أن يتفتت بضربة كف،.. ينحني أكثر وهو يضع بأدب جم إبريق الشاي وتوابعه الأنيقة فيتراءى لي قدح الشاي الراقص الذي يرميه عليك أبو داوود في مقهى حسن عجمي ووجوه الأصدقاء الشاحبة الممصوصة وهم يتلفتون بحذر طائر لأقل نأمةًٍ أو نظرةٍ، متأبطين كتبهم ومخطوطاتهم بحثاً عمن يبادلهم حصيلة العمر بلقمة يوم:
"ن . ن"(2) أيها الشاعر أين أنت الآن؟ أما زلت تحلم أن يبعث لك سليم بركات تذكرة طائرة لتسافر إلى قبرص؟.
وأنت يا "ع . ر"(3) الروائي الكبير ما الذي ظل في مكتبتك المهولة لم تبعه بعد؟ عبثاً تستنجد بسرفانتس وأبي الفرج الاصفهاني وفوكنر والنيسابوري من أجل أن ينقذوك من المحنة.
وأنت يا "م"(4) القاص الذي وصلتني رسالته من بلد بعيد وهو يحدثني عن أخيهِ صديقي الروائي الذي اُعدم شنقاً في 18/7/1990 ولم يسمح لأهله باقامة العزاء: "إنه يعيش معي يا عدنان في كل اللحظات والأماكن أنه شجرة حزن تكبر داخلي إلى أن تقضي عليّ، أشعر بمسؤولية أن أعيش وأعمل عن شخصين لا عن شخص واحد. انه حيٌّ داخلي بل أكثر حياةً مني عند نفسي.. انه رجل مثقف ومبدع أصيل وإنسان حقيقي ورجل شجاع وصادق وأسطورة نادرة، كان رحيله أكبر كارثة في حياتي وأكبر خسارة للثقافة العراقية .. أبعث اليك مع هذه الرسالة بعض ما عندي عنه هنا وبعض المعلومات تجدها في ظهر إحدى الأوراق المستنسخة مع الرسالة ولكن تذكرْ دائماً أن تتحاشى ما قد يضر بأهله وبناته هناك في الداخل...".
وأنت يا "أ.. "(5) الشاعر الذي كتب لي من بغداد في 5/6/1996 وهو يحدثني عن نفسه "ما زال صديقك يكتب ويعيش بل يعيش ليكتب، يشتري الكتاب بمعجزة، ويبيعه ليشتري كتاباً آخر، بينما يرقب بطن زوجته الصبورة التي أعلنتْ عن ثالث سيشارك الجميع إرث الفاقة والعوز إذا استمر الوضع على ما هو عليه ... ماذا عن البياتي والأخضر والحيدري.. وماذا عن الشعر؟ بي عطش عظيم لكل هذا، قل لهم ان هناك من ينتظرهم…، يسعدني أن أطلعك على فوزي بجائزة "حسب الشيخ جعفر" الشعرية الأولى للعام 95/96 وكان من المؤمل اصدار المجموعة الفائزة إلا أن الالتفاتات والمماطلات الرخيصة حالت دون ذلك وما زالت المجاميع مركونة على رفوف دار الشؤون …. ماذا عن أصدقائنا؟ هل لك أن تتخيل مدى الغربة التي أعانيها هنا .. نعم، لا يمر يوم دون أن أفقد صديقاً عزيزاً وكان آخر هؤلاء "ح . ن" تعرفه بالتأكيد، لقد حصل على الدكتوراه وغادرنا إلى ليبيا. ماذا عن الدكتور عبد الاله الصائغ .. الخال العزيز؟ هل علمتَ بسفر الغانمي سعيد وبالتأكيد علمتَ بمغادرة فاضل ثامر والدكتور صالح هويدي وحاتم الصكر... و.. و.. ماذا عن عبد الرزاق الربيعي؟ ماذا عن فضل الذي تحوّل إلى صحراء لكثرة مكوثه هناك، وماذا عن الآخرين جميعاً محمد مظلوم، زاهر، الصائح، تركي، الشلاه، السوداني، ماذا بالخصوص عن عبود الجابري الذي أرقني سكوته، وعلي حسين علي الصامت بطبعه....، أيها العزيز اعذر لهفتي وأنا أكاد أتشبث بقميصك...".
ها أنت يا صديقي الناقد "ح . ن"(6) الذي بعث لي من ليبيا يذكرني بقول الجواهري رداً على كل شيء:
ونحن غداً لموعودون فجراً يُلفُّ على القريب به البعيدُ
ويا صديقي الشاعر "ع"(7) الذي يتخثر في اليمن بلا زوجة ولا وطن ولا أهل ولا راتب وهو يقول لي: "انتظرتُ رسالتك طويلاً، لا تقطع "خيوّ" يكفينا أنّا خسرنا الوطن والأهل ولا نريد أن نخسر أحبتنا .. بالنسبة لخطتك التي رسمتها لإنقاذي رائعة وسأحدد هذا بعد شهرين، ما دمت أحلم بالوصول إلى تونس، طبعاً لن أسافر إلى عمان هذه العطلة سيعطوننا تذكرة "ون وي" بسبب إلغاء عقد عملي ولهذا سأستخدمها في الوقت المناسب عندما أودع صنعاء تماماً ...".
وشكراً لك يا صديقي الشاعر "ج . خ"(8) الذي كتب لي من بغداد في 12/6/1996 "من كان يصدق أن الصائغ هذا المجنون ببغداد وحدائقها وشوارعها ونسائها يتغرب عنا، سأحقق رغبتك وأقبّلْ لك كل أعمدة شارع الرشيد، وسأحدث باعة الكتب والصحف وعمال المطاعم المتواضعة والمقاهي وباعة الأرصفة عنك وعن شوقك لهم، أما الأصدقاء فأرجوك أن تعذرني فلم يبق منهم إلا القليل، لم يكن صديقنا اسماعيل عيسى وحده الذي خطفه الموت في غفلةٍ منا فقد مات قبله جاسم التميمي مدهوساً في أحد شوارع بغداد التي أحبها مثلك، ومات بعده محمد شمسي المغامر الذي طاف غابات وأدغال افريقيا دون أن يصاب بشيء ولكنه مات على فراش المرض دون أن نفعل ـ نحن أصدقاءه ـ له شيئاً، كما مات مجيد نعمان، ومات الفنان عبد الجبار كاظم، ومات فوزي مهدي الساخر، ومات المطرب الريفي الجميل سعدي البياتي، ومات حميد العلوجي و.. و.. لا أتذكرهم .. مات زوج لطفية الدليمي، ومات ابن وداد الجوراني عماد وهو في عز الشباب ...".
وأنت يا صديقي الفنان المدهش "ج …"(9) بماذا أجيب رسالتك التي أدمتني: "أما بعد، أما من نهايةٍ لهذا البَعْد .. ونهاية لهذا البُعْد، أما من نهاية لآلامنا، لتمزق أشلائنا، لتطلعات أرواحنا، ونظرات عيوننا المحدقة في الفراغ، آهٍ يا أخي يا ابن وطني الذبيح يا ابن الحسين الذبيح، آه يا عدنان يا جريح، كلنا جرحى وكلنا ذبحى. ولدي "ح" ستة أعوام ما رأيته، أمي تموت وتدفن في كربلاء وما رأيتها، ابنتي " أ " الآن في العراق وها هي ستة اشهر مرت على فراقها، ماذا أفعل؟ الأصدقاء يموتون ويرحلون ويذهبون وأنا وحدي وأنت وحدك وكل منا وحده ...".
هل يصلح كل هذا مدخلاً قاتماً لجيلنا الثمانيني الذي فتح عينيه على مشهدٍ دموي فرش ظلاله على ثقافته وحياته وأحلامه ورسائله وأفكاره وكتاباته. كنا فيه شهوداً وشهداء وضحايا ومنتظرين ومرتهنين ومتفرجين، على أخطر مراحله قبل أن نتجه إلى الشتات ونتوزع في المنافي القسرية أصدقاءً تجمعنا المنافي ويفرقنا الوطن كما كتبتُ ذات مرة من عمان إلى الصديق الشاعر محمد مظلوم المقيم في دمشق، وهكذا لم يبقَ لنا سوى تبادل الرسائل - أوطاننا المسافرة في صناديق البريد، والشهادات الأكثر صدقاً - عما يدور بنا ويحدث - من كل التنظيرات التي نقرأها هنا وهناك...
وإذا كان العنوان يؤسس غواية النص كما يذهب إلى ذلك كونغور فانه سيفسر لنا سر شتات هذا الجيل مفضياً بنا إلى شتات نصوصه، ذلك أنه ما من جيل في العالم عاش ما عشناه منذ أن قذفتنا دوائر التجنيد الإجباري جنوداً منكسرين على جبهات الحرب قبل أن نذوق متعة الحياة والقراءة والنشر والحب والسفر، حتى خرجنا بعد عقدين من بوابة "طريبيل" شباناً مكتهلين نبحث عن فرص النشر وأدوية القرحة والكتب التي لم تصلنا، نجرُّ وراءنا حشداً من الأطفال الذين لم يفهموا حتى الآن أين وطنهم ولماذا هم مشردون؟
أي طوفان أسود غطانا جميعاً وزرع في دواخلنا هذا الخراب والاضطراب، حتى ونحن نتوزع الآن في عواصم العالم المفتوحة على الحرية نجد ان ما تراكم في ذواتنا يحتاج ربما إلى سنين طويلة أو أعمار إضافية لاقتلاعه والتأقلم مع الحياة الطبيعية ومناخات الحرية التي حرمنا منها طيلة أكثر من ربع قرن ..
"أنت غير قادر على تحريك العين هكذا، أن لم تكن حراً، هذه الحرية لم تمنحنا الجماعة ولا الطبيعة، أنها ليست حرية متاحة. أنتَ اكتسبتها بالدربة والشظف والمقايسة والنقد .." هكذا كتب الشاعر سعدي يوسف في تقديمه لديواني "تحت سماء غريبة" 1994 وهي المجموعة الأولى التي تصدر لي بعد خروجي من الوطن.
كيف يمكن انتزاع الحرية من بين مخالب الدكتاتور، كيف يمكنك أن تسير بحياتك وابداعك وسط حقول الألغام والأسلاك والحرس والممنوعات .. ربما في هذا تكمن مهمة الكاتب وتحديه ومشاكسته، وسر ديمومة نصه حين يعايش نبض الشارع ويتصاعد معه وبه. وهذا يقودني إلى الكاتب الألباني إسماعيل كاتدريه: "على الكاتب أن يعمل على صيانة الحرية في أعماله، أن ديكتاتورنا كان أكثر ذكاءً من ستالين ولذلك كان الاحتجاج يتم عن طريق الأدب واللغة لأن النظام السياسي عاجز وضعيف أمام الأدب العظيم" فهل يمكن التحايل على السلطة وهل يمكن للمبدع "ان يراوغ شرطيه" كما يذهب الى ذلك لينين.
إن مقولة برخت: "أنتم يا من ستظهرون بعد الطوفان الذي غرقنا فيه" والتي وضعتها افتتاحية لمقالتي في العدد المزدوج 11/12 الذي صدر من مجلة "أسفار" عام 1992، قد جاءت بمثابة رد مبطّن وحاد على رعد بندر (شاعر أم المعارك ومستشار وزير الثقافة والإعلام يوسف حامد حمادي وقتذاك) حين عمد – بقصد في نفسه – إلى زج المجلة بمواد في المدح والردح، لا علاقة لها بالثقافة وأراد لكلمتي الافتتاحية أن تكون كذلك. وقد كنتُ في امتحان عسير لا أنساه ما حييتُ. عشتُ خلاله ليالٍ ممضة كأنها الجمر حتى اهتديت إلى حل مجنون أقرب إلى الانتحار، لم أستشرْ به أحداً من أصدقائي خشية أن يعترضني. هرعتُ إلى مطابع دار الشؤون الثقافية حيث تطبع هناك وقمت بتقسيم العدد إلى قسمين، ضم الأول مواد مهرجان الميلاد. وضم القسم الثاني مواد المجلة. فاصلاً بينهما – بما يشبه التنصل - بتايتل العدد وأسماء التحرير والفهرست الذي بدأ من الصفحة 35 ومن ثم جاءت افتتاحيتي " عن الثمانيين والحصار وبول ايلوار" والتي لم يكن فيها أي اشارة للميلاد والاحتفال. بل والأدهى، رويت فيها حكاية بول ايلوار حين تلقى في بريده اليومي ذات يوم رسالة وقّعها فريق من الرفاق الشيوعيين الفرنسيين جاء فيها:ـ الى الرفيق ايلوار .. نريد منك أن تكتب قصيدة بكذا أبيات عن الموضوع الفلاني… يقول الشاعر الأرمني روبان ماليك وكان يعمل سكرتيراً له: "ما ان قرأ ايلوار اللطيف، العذب، الرقيق، هذه الرسالة حتى راح يصرخ كالثور ثم مزق الرسالة ونفش شعره ووصل الى حافة البكاء" ولا حاجة – قلتُ - للسؤال عن السبب. لقد ثار ايلوار واستغاث لأنه شاعر أصيل.. والخ المقالة..
لكن السلطة أدركتْ ما ذهبتُ إليه ليس بذكائها وإنما بواسطة مخبريها من المثقفين فقادني العدد إلى التحقيق، ولم تنقذني إلاّ الصدفة وتدخل شاعر كبير مقرّب وانشغال الوزير بمكالمات هاتفية انهالت عليه حول قصة قصيرة للقاص صلاح زنكنة بعنوان "موت الإله" منشورة في العدد نفسه رأوا فيها تطاولاً على الذات الإلهية، وكانت الحملة الإيمانية للدولة على أشدها وفي بداياتها التصعيدية فانشغلت الوزارة بانتزاع القصة من العدد وتمزيقها قبل توزيعه وسحب ما وُزّع منه من المكتبات. وتلك حكاية أخرى، ألا ترون أن الحكاية تنجب الحكاية وتمنعني عن الاسترسال. تاركاً لمؤرخي الصحافة العراقية أن يروا ويرووا حكاية أغرب عدد..
وخرجتُ من المجلة بعدها بصعوبة ومن الوطن بأصعب.
أعود إلى جيلي لأرى أن أهميته وافتراقه عما سبقه من أجيال يكمن في أنه عاش الواقع السياسي في اقسى سنواته وتراكمت على نصوصه افرازات المرحلة قبل أن يعيها.
فإذا كانت الأجيال التي سبقتنا: رواداً وستينيين وسبعينيين قد وجدتْ تحت أقدامها أرضية صلبة استطاعت أن تستند عليها وتؤسس فقد وجدنا أنفسنا فوق أرض رجاجة ملتهبة نؤسس فوق ما بدأ يتهدم في داخلنا، لكن ما الذي أسسناه. ان نظرةً بانورامية لنتاج الجيل ترسم لنا تنوعاً غريياً على الصعيد الفني وتنقلات حادة في مستويات النص بين الكلاسيكية الفجة والحداثوية المتطرفة هروباً جماعياً من الواقع المعاش انعكس ذلك على الصعيدين: الثقافي (النص) والاجتماعي (الحياة).
وإذا كانت الحرب قد جرت أغلبية أبناء الجيل إلى لهيب السواتر البعيدة وقيء الثكنات فأن هذا يعني من جانبٍ آخر وضعهم بمواجهة القسوة والموت وجهاً لوجه مما انعكس ذلك على حدية نتاجهم وأفكارهم ومواقفهم وصداقاتهم ومزاجهم وكذلك في التناقضات التي تجدها بينهم فشهد الجيل معاركَ أدبيةً وتهميشية وتسقيطية وتخوينية إلى حدَّ انهم حملوا معهم هذا التراث الفاجع حتى وهم يعيشون مناخاً آخر.... فالاتهامات: ان هذا تقليدي وهذا ابن المؤسسة وذاك كتب قصائد عن الحرب وهذا عمل مصححاً في جريدة بابل وهذا كتب قصيدة في رثاء عدنان خير الله طلفاح وهذا رأى شمس "القائد" ساطعة على الفراتين وشموسنا رماد، وهذين فازا بجائزة ونحن أحق بها منهما، وهذا فاز بجائزة كبيرة لا يستحقها، وغير ذلك الكثير.. مما جعل الساحة مضببة والنفوس متشنجة، دون أن يتاح للناقد أو الدارس أو المراقب فرز الاصوات بهدوء، ودون ان يحتكم الجميع الى غربلة التأريخ التي هي أكبر من التصورات القاصرة لضيقي الافق.
لكنني من ناحية أخرى وأنا أتحدث عن تجربة الجيل ككل متسامياً ومتجاوزاً للصغائر، أرى أننا يجب أن نفرز ألوان المشهد الثقافي العراقي كاملاً وإلا فأن الخطوط والألوان ستختلط ولن يستطيع المشاهد البعيد أن يرى شيئاً من هذه الفترة الحاشدة. أن ظلماً كبيراً سيلحق هذا الجيل الذي أرى أنه ما من جيل أدبي في العالم قاوم السلطة بوسائله المختلفة مثلما فعل جيلنا، وكذلك الأجيال الأخرى التي لا يمكن إلغاء دورها، ومن يقول أن المثقف العراقي كان بوقاً للسلطة فأنه ـ برأيي الشخصي ـ قاصرٌ تماماً عن أدراك طبيعة المرحلة التي عاشها العراق بشكل عام والمثقف العراقي بشكل خاص، وهو عاجز أيضاً عن قراءة ما خلف النصوص التي تشكل بخطابها المستتر إدانة للحرب وللنظام مررها الأدباء الجادون من بين مقصاته وعيون رقبائه وسيكشف التأريخ آجلاً أو عاجلاً ما ذهبتُ إليه.
وأنا حين أقول ذلك، فلكي ألفتُ أنظار الخارجين من المجزرة والمتنعمين بهواء الحرية المعقم لكي لا يتوهموا أنهم وحدهم الأبطال وأن كل من في الداخل هم خونة..
أعرف أن كلامي هذا سيزعل بعض من نصبوا أنفسهم أبطالاً في غفلة من التاريخ، لكن يمكنني أن أراهن على المستقبل، على الأدب السري الذي يُكتب هناك، والذي سيفقأ الكثير من البالونات التي وجدناها هنا تخيم في سماء المنفى.
أننا يجب - ونحن نرى المشهد الآن من بعيد بوضوح أكثر نوعما - أن أفرق بين ثلاثة مثقفين.
الأول: هادن السلطة وصفق لها وزمر في كتاباته بطواعية.
والثاني: دخل المؤسسة الثقافية بحكم مهنته ككاتب أو صحفي أو فنان وعمل من داخلها لكنه أعطى نتاجاً خالصاً، بعيداً عن طبول الإعلام.
الثالث: آثر العزلة والصمت.
لكن هل يحق لي أن أعطي أحكاماً وتقسيمات؟
ثم هل هذا التقسيم كاف ليشمل الجميع؟
لا بد من فرز أكثر لكي يتجلى المشهد الثقافي بشكل عام والجيل الثمانيني بشكل خاص لأن في تجربته اختصاراً وتكثيفاً لكل ما مر في تاريخ العراق المعاصر، ممهداً بذلك من وجهة نظر شخصية لمن سيتناول الأمر بدراسة تفصيلية. ما يهمني بالدرجة الأولى من كل هذا أن نفرق بين موقفٍ مع السلطة ونشاط تطوعي ليس فيه جبر ولا قسر، وبين موقف ونشاط جبري وقسري أملته الظروف الموضوعية لهذا المثقف أو ذاك ومع ذلك يبقى السؤال الأهم والأجدى: من كان مع الطغيان والاستبداد ومن كان ضدهما. وعلى هذا المقياس يمكن أن يحاكم المثقف أو الحزب أو المجتمع. لقد وصل الأمر أحياناً إلى درجة التخوين الجماعي، وأصبح جلد الذات يُمارس لجلد الآخرين حتى تضاعفت عملية الإتهام والتشويش إلى حد توجيه الإتهام بأن هذا علق لافتة في يوم 17 تموز، وذلك شُوهد يصفق في المسيرة الرسمية .. وغير ذلك الكثير، وأتذكر قول برخت: "ينبغي أن نحذر ونحن نطارد الوحش من أن نتحول الى وحش مثله". أن بإمكان الثورة أن تسقط الاستبداد الفردي والاضطهاد المستغِل ولكنها لن تأتي أبداً بإصلاح حقيقي لطريقة التفكير بل تولد بالعكس أحكاماً مسبقة جديدة تشكل مع الأحكام المسبقة القديمة تخوماً تفصل الثورة عن الجموع الكبيرة المحرومة من التفكير أما بالنسبة للتنوير فلا شيء مطلوب غير الحرية بمعناها الأكثر براءة كما يذهب الى ذلك ايمانويل كانط فإذا لم ننتصر على القمع في داخلنا وإذا لم نفتح أبواب الزنزانة أمام الآخر ليخرج من ذاتنا ويمارس حريته فإن هذا يعني أننا سنكون دائماً الجسور الممهدة نحو وصول طاغية جديد. إن خصومة فولتير مع روسو وصلت إلى أعنف النقاشات والمجادلات في الصحف لكنهما تآلفا في الإنتصار الى الحرية فعندما صادرت السلطات السويسرية كتاب روسو وأمرتْ بإحراقه كان فولتير أول من دافع عن روسو وهاجم السلطات السويسرية متمسكاً بمبدئه الشهير: أنا لا أتفق معك في كلمة واحدة مما قلته ولكنني سأدافع عن حقك في الكلام وحرية التعبير عن أفكارك حتى الموت ..
فكيف تصرفنا مع حرية الرأي في الداخل أو في الخارج؟
أعود إلى الخريطة المتخيلة التي رسمتها لأتفرس فيها من الداخل مستذكراً تفاصيل ما مرّ: الصنف الأول وهو قليل إبداعاً وكماً لا يحتاج إلى كثير جهداً لفرزه، لكن مهمته لم تعد في إطار التطبيل والتزمير بل تعدّته الى مهمة أخطر وهو تلويث الأسماء النظيفة وزجها بالترغيب والترهيب في المهرجانات الدعائية والتمجيدية أما الصنف الثاني فهم الأكثر شيوعاً في المشهد الثقافي بل إن الجماهير كلها بشرائحه يمكن أن ينطبق عليها هذا القياس فهم يعيشون داخل حدود النظام ومؤسساته الثقافية والتربوية والاجتماعية والعسكرية والخدماتية التي فرضت نفسها بالضغط القمعي التدريجي على مدار ثلث قرن أو أكثر، لكنهم بأفكارهم وطروحاتهم لا ينتمون إلى النظام ولا يحبونه، وقد عجز النظام بكل وسائله – إلاّ بحدود ضيقة - في كسب ود الشعب بشكل عام والمثقفين بشكل خاص مستخدماً آلاف الوسائل الإرهابية والقمعية والتحايلية لكن أول شرارة من الإنتفاضة كشفت للنظام إنه غير مرغوب به وإنه لا قاعدة جماهيرية وفكرية لديه، ومع ذلك كان الجميع مضطرين لأن يكونوا داخل المؤسسة، فلا صحيفة في العراق للقطاع الخاص أو للرأي الحر، ولا مركز ثقافي ولا مطابع ولا مهرجانات ولا أمسيات ثقافية ولا .. ولا ..، فإذا لم يعمل الكاتب في مجلة أو مؤسسة ثقافية فإنه مضطر لأن ينشر نتاجه في صحيفة أو مجلة وإذا لم ينشر فإنه مضطر أن يقرأ جريدة أو يشاهد تلفزيوناً أو يستمع الى إذاعة أو يحضر ندوة وهذه كلها واقعة تحت مناخ السلطة.
الصنف الثالث: وهم قلة رائعة ممن آثروا الصمت والعزلة والأقل من هؤلاء من كان يجابه السلطة بموقفه الصلب ولا يهادن فيفضي به الأمر في النهاية إلى إحدى الطرق: السجن أو الموت أو المنفى أو الجنون.. أو النسيان.
أقول هذا ولا تصنيف نهائي للثقافة أو السياسة أو الحياة، ثمة تداخلات تقلب كل التخطيطات رأساً على عقب، لكن ما يبقى في النهاية هو مقدار الصدق الإبداعي والحياتي لدى هذا المثقف أو ذاك مدخلاً مهماً لموضوعة الحرية والوطن والسلطة للتأكيد على السؤال الذي يقلق الجميع في الداخل والخارج معاً هو إنك حين تنال الحرية كيف ستعيشها، وهل ستمنحها للآخر؟..
لقد وجدت أثناء نقاشي مع بعض الأدباء الذين غادروا الوطن منذ سنوات طويلة تراجعاً في تذكر قسوة النظام وفهم أساليبه الدموية، من جانب آخر وجدت (البعض) أقول البعض ينصبون أنفسهم حكاماً. لقد سمعت أحد الناشئين يحاجج شاعراً مثل زاهر الجيزاني أنه كان يكتب داخل المؤسسة الرسمية بينما هو أي الناشئ كان خارج إطار المؤسسة، أي حيرة مرة تحملها الإجابة على مثل هذا الطرح والطريف في الأمر أن هذا الناشيء الذي لم يكن له اسم في الداخل ما أن أتيحت له الفرصة في الخارج حتى ارتمى في أحضان أول مؤسسة حزبية واجهته وأصبح بوقاً مدوياً لها، غاضاً الطرف عن أخطائها للحفاظ على ربع الكرسي الذي أجلسوه عليه مسؤلاً للقسم الثقافي في "...". كما أن البعض ممن حاول بجهد جهيد أن يحظى بفرصة نشر مجموعته الشعرية أو القصصية في دار الشؤون الثقافية إلاّ أنه كان يجابه بالرفض لضعفها الفني وليس لموضوعها المغاير أو طروحاتها السياسية الضدية لكنه ما ان اصبح خارج الوطن حتى اخذ يصرّح هنا وهناك انه كان يرفض النشر لدى المؤسسة بالرغم أن العديد من قصائده كانت تفترش الصفحات الثانوية لجرائدها في أحسن الأحوال. ما أسهل الادعاء وما أصعب الموقف (الجميع يريد أن يغير الناس لا أحد يريد أن يغير نفسه – تولستوي) لهذا فانا أحلم مع ميشيل فوكو بالمثقف "هدام القناعات والبدهيات العمومية، أحلم بالمثقف الذي يتحرك باستمرار دون توقف غير عارف أين سيصبح غداً ".
أين علامات الاتصال والانفصال بين السلطة والثقافة في العراق؟
هل هي متشابكة إلى حد أن يصف أحدهم جميع المثقفين العراقيين في الداخل بأنهم أبواقاً مبوقة لمديح النظام ويستشهد برؤية أسمائهم في الجرائد. لكن النظرة المنصفة ترى غير ذلك ..
ان شاعراً مشاكساً مثل كمال سبتي وجد نفسه بحكم سنه القانونية جندياً في جريدة القادسية أثناء الحرب.. ماذا يفعل؟ .. وشاعرة شفافة مفعمة بالطفولة مثل دنيا ميخائيل وجدت نفسها تكتب في صحيفة بغداد اوبزيرفر بحكم دراستها الأدب الانكليزي، ماذا تفعل؟ .. الخ .. الخ، لكن السؤال الأجدى الذي لا يسأله أحد هو: ماذا كتبوا؟ فهل تتساوى كتابة كمال سبتي بكمال الحديثي، أو دنيا ميخائيل بـ...، والخ.. والخ..
لهذا فان أول فرصة حرية فُتحتْ أمامهم فروا: كمال سبتي الى اسبانيا هارباً بملابسه الفنتازية، وزاهر الجيزاني باطفاله السبعة الى جبال كردستان، وأحمد عبد الحسين بكآبته الخلاقة الى ايران، ومحمد جاسم مظلوم بمشروعه المُجهظ الى سوريا، وباسم المرعبي بعزلته الشعرية الى السويد، ودنيا ميخائيل بطفولتها المدهشة الى امريكا، وعبد الرزاق الربيعي بقلقه الدائم الى اليمن، وعبد الحميد الصائغ بفصد دمه الى السعودية، ومحمد النصار بتنافساته الصحراوية الى عمان، وفضل خلف جبر بتحليقاته المعقدة الى اليمن ونصيف الناصري وعلي عبد الامير وعلي الشلاه وعلي السوداني، وباسم قهار، ورضا ذياب، وناجي عبد الامير، وكريم رشيد، وعصام محمد وعدنان حسين، وكفاح الحبيب، وكفاح محمود، وعلي المندلاوي، وسعيد الغانمي، وعواد علي، وكريم جواد، وصلاح حيثاني، وناصر مؤنس، وصلاح حسن، وفاضل الخياط، وسلام سرحان، وشريف شعلان، وشكر خلخال، وعقيل منقوش، وكريم جثير، وانا، وعذراً لمن نسيت اسمه .. والبقية تأتي ..
لكن لاحظوا معي تسلسل سنوات الهجرة من الوطن، هناك من خرج عام 87، وهناك من خرج عام 93 وهناك من سيخرج بعد أعوام، فهل تصلح الأعوام مقياساً للوطنية أو الشعرية - كما يتعكز بعض ضعاف المواهب على ذلك ناسين أو متناسين أن أغلب المثقفين في الداخل يتمنون الخروج من الجحيم، لكن لكل ظروفه ولكل زمن أحكامه...
هل أقول هذا رداً على الذين كلما سمعوا بمثقف عراقي فر مؤخراً من قفص النظام كشروا أنيابهم وشحذوا سكاكينهم التقصيبية، في انتظار وصوله اليهم ناسين أنهم كانوا هناك قبله ذات يوم. مما أدى ذلك بالانكفاء على الذات لدى أغلب الذين بدأوا يخرجون من الجحيم ليواجهوا جحيماً آخر.
قبل عام وصل عمان كاتب مهم(10) نال كتابه الأخير صدى طيباً في الداخل والخارج وكان يأمل أن يستقر نهائياً وقد ظل طيلة شهور مرة يلهث للحصول على لقمة يوم أو موطيء قدم في أية صحيفة أو مؤسسة وطرق الكثير من الأبواب وحين قدم كتابه ( الذي رفضته المؤسسة الرسمية في العراق إلا بعد حذف دراسته عن الجواهري وسعدي يوسف) إلى إحدى المطابع التابعة لأحد الأحزاب المعارضة رفضتْ طبعه أيضاً إلاّ بعد حذف (دراسته عن سامي مهدي ويوسف الصائغ).
ذات يوم حين فتحت له الباب وجلس على الأريكة المكسورة متقطع الأنفاس بعد صعود الشارع العالي المؤدي الى بيتنا في عمان ، فاجأني بالقول أنه قرر الرجوع الى بغداد حتى لو علقوه على أعمدة شارع الرشيد، وقبل أن أنطق بشيء من الدهشة راح يحدثني عن بيروقراطية بعض مؤسسات المنفى وعقليات أصحابها التي لا تختلف كثيراً أو قليلاً عن عقليات رجال السلطة فإذا كانوا هم هكذا قبل أن يستلموا السلطة فكيف إذا استلموها ثم أطلق جملة اقشعر لها قلبي وسأظل أحملها معي إلى القبر لكنني لا استطيع أن أبوح بها خشية التأويل.. أية سخرية مرّة عليك أن تطلقها في وجه الريح، وأي بلاء أن يعيش المثقف الملتزم الصادق مع نفسه وفنه وثقافته بين نظام لا يفهم معنى حرية الرأي وخارجين عنه لا يقدرون حق الاختلاف ..
ان عشرات أو مئات المثقفين الذين يحطون رحالهم في عمان - نافذتهم الوحيدة، يصطدمون بالجدار المغلق الذي لا يفضي الى شيء، يركضون هنا وهناك دون أن يجدوا ولو إصبعاً واحداً يمتد اليهم لينتشلهم ( أتكلم هنا بشكل عام بعيداً عن الاستثناءات) وأتذكر صديقي الفنان المسرحي "م.."(11) الذي وصل به الأمر الى حمل ابريق الشاي والكاسات الصغيرة ليبيع الشاي في ساحة الهاشمية (ولا منقصة في ذلك)، وسط استهزاء البعض الذين كانوا يجلسون في المقهى يسبون أدباء الداخل غير أنه لم يستطع المواصلة – كما أخبرني – بسبب الحملات التي كانت تشنها البلدية والشرطة على متجاوزي الإقامة)..
أحد الشعراء الذين خرجوا من الحرب سهواُ، كان يصارع الأمواج بذراعيه المجرحتين وسط كواسج السلطة التي أخذت تلعق دمه وهو يسيل، وحين لوّح لأصدقائه في الخارج تبرع أحدهم بمد يده ممتناً لينتشله ثم في لحظة سحب يده قائلاً للغريق وسط الأمواج: لقد سالت عنك فقالوا انك ابن المؤسسة الرسمية، وتركه مع عائلته يغوص في القاع .. رغم أنه لم يكن أبن المؤسسة ولا أبن عمها ولا أبن خالتها.. أما كان لهذا المثقف أن يكمل مشروع انقاذه النبيل وحين يجفف الغريق ثيابه على الساحل يعقد له محكمة هادئة ويسأله ليدافع عن نفسه.. أي دفاع عن النفس يمكن أن يقوله الإنسان وسط الأمواج والكواسج. وليته اكتفى بذلك التنصل بل شمّر ساعديه هذه المرة بهمة أكبر وجهد أعظم وراح يصب سهامه القاتلة على الغريق يميناً ويساراً، سراً وعلناً، وهو يصول ويجول.
ان أكثر ما نحتاجه هو الحوار الهاديء المشبع بالعقلانية والحضارة واحترام حرية الآخر في الاختلاف، فـ (اعتقاد الإنسان بأنه يمتلك الحقيقة هو مصدر كل قمع فهذا الاعتقاد يعتقل العقل عقل الذات وعقل الآخر - أدونيس)
وهذا المثقف - سامحه الله - لا يفرق حتى هذه اللحظة بين العمل والنظام فليس كل من عمل في المؤسسة الثقافية أو نشر كتاباً أو ألقى محاضرة هو أبن النظام. ان هذا التصور الأحادي الساذج سيجرنا جميعاً الى الخراب أو المجزرة.
كان يمكن أن يصاغ السؤال بمنطق أكثر موضوعية: ماذا عملتَ حين كنت في المؤسسة، وماذا كتبت حين كنت محرراً في هذه الصحيفة أو تلك المجلة، وما هو عنوان المحاضرة التي ألقيتها ومضمونها؟ لقد كانت مسرحيات سارتر تمثل على المسارح النازية وهي في الضد تماماً، وكان المتنبي يمدح كافوراً: " كفى بك داءً أن ترى الموت شافياً "، بينما هو يهجوه. أن التأريخ الذي يغربل الجميع كشف لنا كيف جعل المتنبي كافوراً اضحوكة الدنيا بينما كان ينطلق من مؤسسته، بل يذهب كاتدريه الى ابعد من ذلك وأجرأ فيقول: " يمكن للكتّاب أن يكونوا على وفاق مع أنظمتهم دون أن يكونوا بالضرورة خانعين أو تابعين أو أبواقاً لتلك الأنظمة فجوته وفرجيل وسيرفانتس لم يكن أي أحد منهم منشقاً سياسياً ". أذكر ذلك رغم تحفظي الشديد على قول كاتدريه انطلاقاً من اختلاف طبيعة النظام العراقي عن الانظمة التي عاش في ظلها جوته وفرجيل وسيرفاتس، لكنني اشير الى بعض المبدعين في الداخل الذين استطاعوا أن يظهروا أعمالهم الابداعية للنور رغم ظلام النظام وقسوته ورقابته الشديدة، أننا لا بد أن نحيي تلك الجرأة المدهشة بدلاً من لعنها أو ادانتها (اعتقد أن واجب الكاتب الثوري أن يكتب جيداً ذلك هو التزامه - ماركيز)
ان كل ما ذكرته من ألم وقسوة في الأمثلة والتجارب التي مر بها العراقيون بكافة شرائحهم في الداخل وفيما بعد في الخارج يستخلص أي جحيم كان يعيشه جيلنا، ولم يكن أبداً ثمة ملاذ أو مفر سوى الدخول في المعمعة والمجابهة بما لا يشوه نصك أو يدعك تفقد رأسك.. أو الصمت والعزلة، وذلك موت آخر.
أتحسس رأسي بيدي وأتعجب كيف خرج سالماً من بين أسنان السرفات والمقصات والحبال اللامرئية بينما أنا سارح في تأمل خطوات العابرين والعابرات أمام زجاج المقهى الصقيل، منتشياً بالحياة التي تمشي بهدوء على مقربة من رعبي ..
أحس بنقرات على كتفي، التفت فإذا بعباس بيضون يجلس أمامي بصخبه المعهود يسألني هل قرأت مقالتي عن عدد أسفار الخاص بالجيل الثمانيني فيمر في ذاكرتي فهرست الصعوبات التي واجهتني في لم شتات جيل كامل بكل تياراته وتناقضاته وكيف غافلنا المؤسسة ليصدر هذا العدد- الوثيقة. يمر بي فهرست الأسماء المشاركة والتي توزع ثلاث أرباعها في المنافي الآن.
قطرات الشاي على فمي وأتذكر شاي أمي المهيل في أمسيات الصيف على شاطيء الكوفة. أحس بالغصة تندفع نحو فمي، انهض بتكاسل ململماً أوراق أحلامي وأفكاري وأنسل وسط ضجيج السيارات الى مكتبة انطوان، تطالعني عشرات ومئات الكتب والمجلات التي لم نكن نراها أو نسمع باسمائها هناك، ان أجيالاً كاملة تتغذى اليوم على صحف ومجلات هزيلة، بعد أن حُجب عنها كل ما يصدر في الخارج، فلم تعد ترى شيئاً مما حولها، ورغم نشاط أجهزة الاستنساخ لدى بعض المكاتب التي كنا نحصل من خلالها سراً وبالعلاقات الشخصية وبأسعار باهظة على بعض الكتب الممنوعة والمجلات المهربة، إلاّ أنها لا تشكل إلا استثناءً ضئيلاً من محاولة كسر الاستلاب الثقافي العام. هل كان النظام يفكر طيلة سنوات حكمة الرهيبة بأنه في منعه دخول الكتب والمجلات التي تصدر في الخارج سوف ينجح في تجهيل المواطنين وحجب الحقيقية عن العيون وانه في مصادرة حرية الكتابة والكتاب والتلويح بحبال المشنقة سوف يضمن استسلامنا المطلق، أن العطش الحقيقي للمثقف العراقي جعلته يستخدم عشرات الطرق من أجل حصوله على الكتاب الذي يريد رغم الصعوبات والمخاطر أحياناً ..
هذه المعركة الثقافية اللامرئية بين المثقف والنظام، التي لم يكتب عنها لحد الآن، ستصحح الكثير من التصورات الخاطئة عن دور المثقف العراقي في مواجهة النظام وتصاعد صوته وسطوع ابداعه رغم ضجيج التصفيق الاعلامي وأضوائه، وإذا كنا نسمع هنا وهناك من قمع واضطهاد في تاريخ الكتابة فان ما يحدث في العراق يفوق الوصف، ورغم ان المثقف العراقي في رأي السلطة ونظرها لا يتعدى كونه حجراً في رقعة شطرنج تحركه كيفما تشاء ووقتما تشاء إلاّ أنها من جانب آخر تنظر له بعين الترهب وتحسب له ألف حساب على العكس مما يشاع، بل تحسب له أحياناً أكثر ما تحسب لجنرال عسكري ..
لماذا تطارد السلطة كاتباً ما؟ " قد يكون ذلك تعبيراً عن الضعف في مواجهة الأزمات الحقيقية التي تواجه البلد ولا دلالة له سوى اصرار الحكام على القمع والارهاب لكل صوت مخلص لا يهتف للحكام مهللاً مطبلاً مزمراً بل يحرص على قول كلمة حق في سبيل مستقبل أبهى لهذا الوطن المنكود" كما يصف ذلك كمال أبو ديب، لكنه من جانب اخر يمثل الخشية من هذا الصوت، اولاً ومحاولة الاستهانة به ثانياً. لقد حاول أدباء كثيرون وفيهم أدباء يحظون برعاية السلطة أن يوقفوا قرار وزير الدفاع آنذاك عدنان خير الله طلفاح في اعدام القاص العراقي حاكم محمد حسين صاحب مجموعة "مساحة بيضاء" والذي فر من جبهة الحرب مع ايران، إلاّ أن كل جهودهم ذهبت سدى وسُلمت السلطة جثة الأديب منخوبة بالرصاص وعلى سطح التابوت كتبوا "جبان" وقد التقيتُ أخاه في عمان عندما زارني الى جريدة "آخر خبر" الأردنية التي كنت أعمل فيها بعد خروجي من العراق. ليحدثني عن عرائض الاسترحام المملؤة بدموع الأدباء وتوسلاتهم والتي ألقى بها الوزير (رغم أن سكرتيره هو النقيب القاص علي خيون ) في سلة المهملات، دون أي اعتبار لأي أحد… وهذا ما حدث أيضاً مع الكاتب الصحفي ضرغام هاشم الذي كان سكرتيراً لتحرير مجلة حراس الوطن نهاية الثمانينات (حيث عملتُ معه ومع الفنان المبدع علي المندلاوي وسلام الشماع وآخرين في فترة خدمتنا الاحتياطية، كجنود صحفيين).. فلم يستطيع حميد سعيد الذي كان رئيساً لاتحاد الأدباء العرب والعراقيين ومعه الأدباء الآخرون أن يوقفوا غضب السلطة على صديقنا المسكين الذي صدق بالانفتاح بعد انتهاء الحرب مع ايران فكتب مقالاً يرد فيه على عبد الجبار محسن الذي كان وقتها سكرتيراً صحفياً للرئيس مستشهداً بالاغنية المعروفة "الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع"،.. فقفلوا له كل حياته...
والقائمة تطول أيضاً ..
أخرج من رفوف المكتبة العاجة بالكتب بمختلف الاتجاهات واتجه الى عين المريسة، حيث أجد نفسي بمواجهة البحر ثانية، أجلس على المصطبة الحجرية واضعاً ساقاً على ساق مستسلماً لرذاذ الحرية وأنا أحدّق في السيقان العارية على الرصيف والمراكب الماخرة عباب البحر (الأمواج تدور حول العالم، أتمنى لو أمضي معها - الشاعر الاسباني دييجو) لكن إلى أين؟
بيروت – منتصف 1996
(*) هذه الشهادة كتبت في بيروت، منتصف 1996 بناءً على دعوة الكاتبين: فاطمة المحسن وزهير الجزائري، لمجلة "أصوات"، والتي أُغلقتْ قبل نشرها المادة..
(*) نشرت بالاتفاق بين مجلة "تموز"- السويد ع17 خريف 2001 وبين مجلة "عشتار"- استراليا.
(*) نشرت في صفحة "الطريق" على الانترنيت 2002
- رُمزت الأسماء حينها بحروفها الأولى خشية عليهم من أذى النظام الدكتاتوري قبل سقوطه.
1 - محسن علوان صديق آخر شغوف بالقراءة.
2 - الشاعر نصيف الناصري.
3 - الروائي عبد الخالق الركابي.
4 - القاص محسن الرملي.
5 - الشاعر أحمد الشيخ.
6 - الناقد د. حسن ناظم.
7 - الشاعر عبد الرزاق الربيعي.
8 - الشاعر جليل خزعل.
9 - الفنان جواد الشكرجي.
10 - الناقد محمد مبارك.
11 - الفنان المسرحي محمد الجوراني.
|