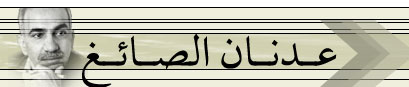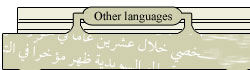|
شهادة عن الجيل الثمانيني في العراق
التراث والحرب والثمانيون
عدنان الصائغ
هل أدخل إلى التراث من باب الحداثة أم أدخل إلى الحداثة من باب التراث؟
لم يجد الجيل الثمانيني في العراق، الطريقَ أمامه سهلة للتوغل في مملكة التراث، المتداخلة المنافذ، والكثيرة المجاهيل، فالظروف التي عاشها جيلنا الشعري وهو يخرج من أتون حربين شرستين، جعلت الأرضية التي يقف عليها هشة، رجراجة، على عكس الأجيال التي سبقتنا (رواداً ـ ستينيين ـ سبعينيين) فكانت السكونية النسبية عاملاً أساسياً في ثبات الأرضية المعرفية لهم وبالتالي التجذر في تربة التراث أكثر منا.
لقد ولد جيلنا هلعاً، قلقاً، متوتراً، متوجساً، يرى الأشياء أمامه غير ثابتة ومشوشة. والأخطر من هذا إحساسه بأن كل ما مرّ به من مرجعيات معرفية بما فيها مرجعية التراث لا يجيب على أسئلته ولا يغطي مساحات الدمار والرماد والدم التي تركتها سرفات الحرب على أديم روحه.
فكيف يستطيع مثلاً تذوق: "أتاك الربيع الطلقُ يختالُ ضاحكاً.؟.
من الحسن حتى كاد أن يتبسما.."
وعلى شفتيه طعم القنابل المالحة، وهي تسيل دماً ودموعاً وخرائب.
وكيف يتسنى لشاعر ثمانيني أن يدرس نقائض جرير والفرزدق واختلاف الشراح حول شواهد سيبويه، وهو لم يكمل بعد دراسة نقائض عصره واستيعابها.. ولا يجد بين أزيز الطائرات والركض بين الملاجيء وقتاً كافياً لتثبيت شواهد موته.
إنني آمل أن يلتفت النقاد - وهم يطبقون نظرياتهم النقدية التراثية على نصوصنا - إلى دراسة الظرفين: الزماني والمكاني، الاستثنائيين اللذين عشناهما، وأن يتناولوا قصائدنا الساخنة، المرة، بوسائل ومناهج ساخنة أيضاً، وليست معدة سلفاً، فليس من المعقول تطبيق منهج ما على "أنشودة مطر" السياب أو "كوليرا" نازك الملائكة ثم قيام الناقد باستخدام المنهج ذاته والأدوات ذاتها على "عواءات" نصيف الناصري أو أرض باسم المرعبي المرّة، أو هذيانات عدنان الصائغ، أو حداد عبد الرزاق الربيعي على ما تبقى، أو مزامير دنيا ميخائيل في الغياب، أو ارتكابات محمد مظلوم في مرايا الشبهات.
لقد خلقت الحرب العالمية الاولى أعظم حركات التغيير والانقلاب الشعري في العالم بولادة المدرسة الدادائية ومن ثم السريالية وبالتالي خلقت أو أحدثت انعطافة كبيرة في الحركة النقدية، وقلبتها رأساً على عقب. في الوقت الذي ما زال فيه بعض نقادنا يحصون عدد الخروجات العروضية في القصيدة أو يحملون مساطرهم النقدية في وجوهنا.. بل أن بعضهم كان يتشمم رائحة التراث بين سطورنا وثيابنا، فإن لم يجدها اتهمنا بالتطرف والحداثة ونسف التراث.
لا أقول هذا نفياً لتهمة أو لاثباتها. ولكن وأنا أتحدث أمامكم الآن، أنظر إلى نفسي، وأنا الذي أفنيتُ أو أفنوا من عمري ثلاثة عشر عاماً من الثكنات البعيدة، كنتُ أغافل القنابل وعيون العريف لأخرج من تحت يطغي ما خبأتهُ من كتب، وأبدأ بالتهامها مثل فأر يائس، ولأن حاجتي الحقيقية الآتية للكتب التي تعبر عن نبضي وتتصاعد مع ايقاع نبض العصر، أجدها مثلاً في "خريف البطريرك" و"الحياة هي في مكان آخر" و"الساعة الخامسة والعشرون" و"لذة النص" و"تحت جدارية فائق حسن" و "في الشعرية" و"الرجع البعيد " و"قمر شيراز" و"الملكة السوداء" و"زيارة السيدة السومرية" و"احتفاء بالأشياء الواضحة الغامضة" والخ... فقد وجدتُ نفسي أكثر ميلاً وتطابقاً مع ما ذكرت فليس من المعقول أن أحمل في تنقلاتي بين الافواج والسرايا طيلة ثلاثة عشر عاماً، "تأريخ الطبري"، أو "لسان العرب" الممتد على مساحة 15 مجلداً، أو "يتيمة الدهر" للثعالبي، أو "أنوار الربيع" لأبن معصوم وهو يفترش على الرف أكثر من مساحة الخندق المخصص لمكوثي حياً على هذه الأرض.
إن بعضكم حتماً سيشير لي بالجحود والرفض وسيضع على النصوص أصابع الاتهام لأنها خارجة على التراث.. لكن الآخر الواعي سيدرك حتماً أن لكل عصر جيله ولغته وشكله الفني ومضامينه الفكرية وحروبه وكوارثه ومرجعياته ومنظوماته وحتى قواميسه..
ألمْ يضق صدر عنترة بكل ما هو مكرور وهو يقف على على عتبة خيام عبلة، قبل أن يدخل معلقته متسائلاً:
"هل غادر الشعراء من متردم".
ثم يأتي أبو نؤاس بعده بقرون كثيرة ساخراً من كل واقف على طللٍ درس، "ما ضرّ لو كان جلسْ"، متهماً عنترة والذين من قبله بالسلفية التراثية والتعصب الأعمى للموروث الطللي في القصيدة العربية القديمة حتى جاء صفي الدين الحلي بعده ــ بقرون أيضاً ــ ليسخر من جيل أبي نواس، متهماً لغتهم: الحيزبون والطخا والنخا والدردبيس....، بأنها "لغةٌ تنفر المسامع منها، وتشمئز النفوس".. ثم وقف السياب على قبر صفي الدين ــ بعده بقرون وقرون ــ ساخراً من تعقيدات شعر الفترة المظلمة وزخارفهم وفسيفساء لغتهم التي لم تعد تلائم مودرن عمارة القصيدة العربية المعاصرة منقلباً على الحلي وعلى جيله، لغةٌ ومضموناً وشكلاً.
وها نحن اليوم نقف أمام تمثال السياب، بقمصاننا المشجرة ذات الياقات القصيرة والخسارات الطويلة، لنتحدث عن انعطافة أخرى وتغيير أخر في بنية القصيدة الحديثة ومضامينها بما يواكب جنون عصرنا، وهول أحداثه وحداثته.
فأي خرق قمنا به أكثر مما قام به أجدادنا العظام للغتهم وعصرهم، أو قل أي أثم ارتكبناه، ونحن نساير الحتمية التأريخية، ألمْ يوصِ التراثيون قبلنا، قبل أكثر من ألف عام بأن نعلم أولادنا أخلاق وسجايا ومعارف عصرهم، لا عصرنا، فأنهم قد "خلقوا لزمانٍ غير زماننا".
إنني أقول هذا وأنا مدرك جيداً لقدسية التراث بل لأهميته وتفاعله مع العصر. فأنا ايضاً ومثلما حدثتكم عن حداثتي التي انفتحت على صور القنابل، فقد انفتحت طفولتي على بيئة النجف، مدينة التراث والشعر والقبب الذهبية، بكل ما تعنيه من رفوف كتب وتكايا، وحلقات أدبية، ومنابر حسينية، ومجالس حافلة، ومطارحات شعرية، وتقفيات.. جعلتني أبدو تراثياً ذا ذقن كلاسيكي في نظر المتطرفين من أبناء جيلي، ذوي الشحنات المستوردة، فقد التهمتُ كل ما وقع تحت يدي من كتب التراث وما رأيتُ من المنائر والمنابر والفسيفساء المزخرف الجميل وهو يتلون في دمنا أينما اتجهنا.
لكنني أفقتُ ذات يوم على أجراس محمد الماغوط فقلبت قراءاتي رأساً على عقب، فركبتُ مركب رامبو السكران متجهاً إلى قرى سنيين وحارات حمزاتوف وغابات لوركا وزنزانات ناظم حكمت وجيكور السياب ومنافي البياتي ومرايا أدونيس وحقول محمود درويش وحانات مايكوفسكي وعشب والت وايتممن، متفتحاً على مواقف النفري وخلود كلكامش وغربة المتنبي، وحين رأيت عيون الزا فكرتُ كيف يمكنني الاستفادة من تراثنا العربي بعقلية حداثوية جديدة مثلما فعل اراغون.. ومثلما فعل دانتي في كوميداه الالهية وبورخس في كتابه الرملي مثلاً.
عندما أتحدث عن جيلي لا أعفي نفسي أو أحداً عن كل ما يترتب علينا من خطل الإبتعاد النسبي عن تراثنا العربي والتشبث في ياقة الحداثة الغربية بأعتبارها المنقذ والدليل الذي سيأخذ بأيدينا إلى شواطئ العالم المفتوح على البحر والشمس والمستقبل، لقد كنا نمرّ على المعلقات وكتب الجاحظ وأبي حيان التوحيدي والمعري وكتاب الأغاني وطبقات الشعراء وتاريخ أبن الاثير وغير ذلك مروراً سريعاً كي نلحق برامبو وميشيل فوكو وسان جون بيرس وهايدكر ودريدا وجاكوبسن وتداروف وباختين.. أي نلحق العصر وهو يركض تحت أقدامنا في اتجاهات شتى. فما تقذف به مطابع العالم يومياً من كتاب ونظريات ومعارف يجعلنا نحن المتلهفين للخروج من قوقعة زماننا وظلمة مكاننا، أكثر تلهفاً لتلقفها وهضمها وبالتالي موكبة كل جديد من النصوص، فهي الأكثر تعبيراً عن حاجتنا الفعلية للمعرفة، أقول الحاجة الفعلية وليست الحاجة الارشيفية.
ونعترف أن في ذلك خسارة مرجعية ومعرفية كبيرة لنا، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل (وليساعدنا النقاد) إذ كان الزمن يجري في غير صالحنا وكانت الحروب والزنازين والحاجة قد سرت ثلاثة أرباع أعمالنا، وعلى هذا، فأنا لا أتقاطع مع الترث بوصفه مرجعاً معرفياً ماضوياً، يفتح أمامي آفاق المعرفة والمستقبل.
ولكنني أرفض أن يتحول التراث إلى تابوت يحنّطني، وكفن يحجب عني الحياة والشمس، مثلما أرفض أن تتحول الحداثة إلى قطيعةً نهائية مع كل موروث وتراث يقطع جذوري مع الماضي ويتركني قشةً تلهو بها رياح الموضات.
فأنا لا أستطيع أن أقتنع بثقافة شاعر من جيلي مثلاً يتحدث في المقهى عن أخر مؤلفات رولان بارت وميشيل فوكو، وهو لا يعرف شيئاً عن الجرجاني والباقلاني والاصفهاني.
وعلى هذا الأمر وجدتُ أن التطرف في كلا المرين يفضي بك - أردت أم لم ترد - الى الجانب الآخر، فالتطرف في الحداثة لا بد أن يقودك إلى السلفية، والتطرف في الكلاسيكية لا بد أن يقودك إلى التهويمية.. وهكذا فكلاهما يلتقيان في منطقة العماء. فلكي تتوازن عصا الابداع الحقيقي لا بد أن تمسكها من الوسط وإلا مالت بك إلى أحد الجوانب، وسقطت من يدك كما ستسقط العصا التي يمسكها الآخر من الطرف الآخر في المكان نفسه. لهذا أقول - وأفتراضاً على ما سبق - إن الشاعر الفلاني إذا ما استمر في تطرفه، سيلتقي عاجلاً أم آجلاً مع الحيص بيص مثلاً وأن بعض شعراء الثمانينيات والتسعينيات، إذ استمروا في الركض إلى أقصى التجريب، واللهثات، وراء الاشكال الشعرية الفارغة - سيلتقون يوماً ما - مع شعراء الفترة المظلمة، فهما وجهان مختلفان، ولكنهما يلتقيان في الطرف الآخر للتطرف.
إن قحطان المدفعي (.......) الذي ذهب بتطرفه الحداثوي مع أقصى رياح الاشكال التجريبية، انتهى به المطاف إلى ما انتهى به خضر الطائي (.......) وهو يمضي متشبثاً بتابوته السلفي الكلاسيكي الى مقبرة النسيان.
من يعرف الآن (أو يتذكر) قحطان المدفعي وخضر الطائي؟ من يقرأ لـ "تريستان تزارا" و"عبد الغفار الأخرس" غير موظفي الأرشيف والباحثين والاكاديميين والدارسين.
بينما ظل الشعراء المبدعون أكثر توازناً في خطاهم وهم يمضون في دروب التجديد، يحملون في دمهم عبق التراث وجنون الحداثة، يعيشون ويأكلون ويشربون ويتنفسون معنا وبيننا مخترقين حدود الأقاليم والأقانيم من عصر إلى عصر، ومن مكان إلى مكان..
فظل السياب أكثر بقاء وتجذراً في أرض الإبداع وأكثر تعبيراً عن لغة العصر من نظامي الشعر، وموظفيه الذين وقفوا في وجهه وحاربوه.
مثلما ظل أراغون وايلوار ضميري كل عصر، يقرأهما العالم في كل مكان.. أكثر من تريستان تزارا، الذي ظل تمثالاً شمعياً في متحف تأريخ الأدب.
(*) نشرت في مجلة "صوت الجيل" في عمان في بداية التسعيانات. ونشرت في صحيفة "القدس العربي" ع 1992 3/10/1995
|