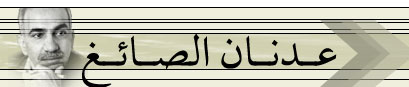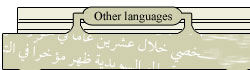في هذا المساء الملتبس، مساء المنفى والوطن معاً، أقف أمامكم بكامل فرحي وخساراتي. أحاول أن أستذكر معكم فصول سيرتي، سيرة الشاعر (أعذروني، أيها السادة أنني سمكة وحشية داخل زجاجة حبر- ألبرتو مورافيا)..
تفرسوا جيداً في ملامحي:
قبل 27 عاماً، وكان عمري 21 عاماً، واقفٌ في ساحة "العرضات" أتفرّس في وجه العقيد، آمر تجنيد الكوفة، الذي منحني الرقم 495545 ج م (جندي مكلف)، ببدلة خاكية، وبسطال ثقيل كالح، لأجد نفسي بعد سنوات، مرمياً على جبل ديركله، وبعد سنوات أكثر حلكة على سواتر الفاو، وبعد سنوات مرّة منكمشاً في موضع ترقّّصه القذائف على ايقاعاتها المجنونة ذات اليمين وذات الخبب، وبعد سنوات مترملة ملتصقاً إلى شاشة التلفريون، في الجنوب السويدي، أتتبع مسار القاذفات، وفي ذاكرتي تتراكض كل تلك السنوات النائحة:
(ويحك يا ننار، لقد هوت مقدسات أور، وذبح البرابرة شعبك. لقد تشرد القوم، وأصبحت أور خراباً" - من "مرثية أور" 2000 ق.م -)
أجمع تلك السنوات الثلاث عشرة التي قضيتها تحت صفيح الثكنات والخنادق، وتلك السنوات العشر من شتات المنافي والتشرد وأطرحها مما تبقى لي من أيام، فلا أرى أمامي في المرآة سوى: "شيخ يتأبّطُ عكّازَ قصائدهِ.. متجهاً نحو البحرِ/ يتمرآى في صفحتِهِ الزرقاءْ/ فيرى في أعماقِ الموجِ/ ولداً في العشرين/ يتطلّعُ مبهوراً/ في وجهِ المرآة…/ لا يدري الآنْ/ أيّهما كانْ..!؟"(1)
كأن قدري أن أعيش ثلاثة حروب، دفعة واحدة، لتلاحقني الرابعة إلى منفاي البعيد..
أرفع رأسي إلى السقف متسائلا لأرى قطرتين تنهمران على خدي المتجعد كأنهما دمعتين من السماء.. (إن هذه الأرض، وتلك السماء، مزقتا قلبي بضيقهما. فلا تفضح أمرنا أيها السراج - جلال الدين الرومي)
أحاول الآن أن أوقف الذاكرة على مشهد أو قصيدة، فتتداخل الصور والأحداث، الدم والمطر، النساء والشظايا، النصوص والأصدقاء، الشعر والإسطبل، الصحافة والمنفى.
فلا أدري من أين أبدأ؟
كأن قدري أن أعيش حياتي المتعثرة سلسلة مفارقات. وما الشعر إلاّ مفارقتها الأبهى والأصعب.. ذلك أنه هو الحياة في أقصى دهشتها وفنيتها ومفارقاتها، وهو لا يتمكن من ذلك إلا إذا استحال إلى نبض حيٍّ للإنسان, يعبر عن توقه وهواجسه وعذاباته وأحلامه السرية، متصاعداً بها إلى مصافِ الحس الإنساني - الإبداعي.. فالشاعر - كما أراه – جوّابَ الآفاق ومدونَ الألم ومستشرفَ الأمل وملتقطَ المفارقات، في مروره العابر والمجلجل على رصيف الحياة..
ففي تلك المعاناة والتجارب الحية، وفي مفارقات (الواقع) يكمن جوهر (الشعر) وسحره الحقيقي وتحديه ولذته وعذابه، وكل هذا يحتاج إلى مهارة غير عادية لصهره وتمثله في اللغة، حيث يصبح للتماهي بين الواقعي والغرائبي هذا السحر الأخّاذ الذي يشدّك إلى الاستكشاف والمعرفة والتغيير، وهنا تتجلى قوة الشعر وبهاؤه.. ولا يتأتى هذا من القراءة فقط، رغم أهميتها الكبيرة، بل بالانغمار والانغماس في الحياة وتجربتها الباهرة.. كأن من يتعذب كثيراً يتعلم كثيراً كما يذهب ايزوب، أو كأن ما يعذب حياتك يُعذب كذلك أسلوبك في الكتابة كما يرى فلوبير أيضاً..
أتوقف قليلاً عند بعض محطات سيرتي، فأراني:
طالباً تحمله جموع الطلبة إلى باب متوسطة الكوفة، احتفالاً بفوزه بالجائزة الأولى في مسابقة الشعر لثانويات كربلاء والنجف والكوفة.. لكنهم بعد أن يخرجوا من الباب سيتركونه لوحده وينسلون إلى بيوتهم..
طالباً مفصولاً من المعهد بسبب قصيدة تحتج على إدارة النادي رأوا فيها شبه تحريض على الدولة..
جندياً يتنقل بين المعسكرات والسواتر البعيدة. ويعيش لعامين في اسطبل مهجور للحيوانات..
جندياً يعمل محرراً صحفياً في جريدة القادسية ومجلة حراس الوطن والطليعة الأدبية..
شاعراً تلاحقه جريدتا "بابل" و"الزوراء" وتضعه على قائمة المرتدين..
شاعراً تلاحقه بعض النصال والاشاعات والشتائم..
شاعراً يتسكع في أصقاع السويد، متأبطاً منفاه ونشيده الملتاع وسخريته المرّة..
........
سأترك كل هذا الآن، وأحدثكم عن أغرب ما مرّ بي، سأحدثكم عن تلك المفارقة التي قلبت حياتي رأساً على عقب، سأحدثكم عن ذلك البغل المرقم..... (اللعنة!! ما أجحدني! وقد نسيت رقمه في زحمة تنقلاتي!).... أنه صديقي العظيم والطيب والباسل حقاً..
لا تستغربوا أو تضحكوا، أرجوكم.. فلولاه لم أكن موجوداً بينكم الآن..
ذات يوم من نهارات الحرب الهادئة نسبياً، ألقى فوجنا الثالث أحماله، قريبا من سفوح جبل "ديركله"، شمال العراق.. أغراني السفح المتماوج بينابيعه ونرجسه أن أحمل أوراقي تحت وطءِ قصيدة بدأت تدغدغ روحي المتربة بعد شهور من اليباس والشظايا. وجدتُ أقدامي تتحرك باتجاه السفح وتتوغلان بي بعيداً. وعلى مبعدة أمتار من أحراش عالية تحيط بنبع مترقرق سمعتُ أصوات الجنود والعريف تحذرني وتدعوني أن أعود فالأرض ما زالت بكراً بألغامها التي لم يجرِ مسحها أو انتزاعها بعد.. واصلت السير، غير ملتفتٍ لشيء سوى تموجات الماء بين الحصى والعشب..
بعد دقائق سمعتُ ورائي أصوات ركضٍ قوية، التفتُ لأجد ذلك البغل المسكين، فاراً مثلي من اسطبله باتجاه النبع.. تجاوزني ثم تخطاني بأقدامه المتراكضة.. وما هي إلا لحظات حتى سمعتُ دوياً مرعباً، وأراه فجأة وقد تحول أمامي إلى نافورة من دم ولحم وغبار، تصاعدت إلى علوٍ.. ووجدتني أسقط من هول الرعب والانفجار متدحرجاً مع الصخور، وبعضاً من النثار يغطي أحجار السفح وملابسي، وعلى مبعدة من المكان انفتحت أشداق الجنود وعيونهم برعب في انتظار انجلاء سحب الغبار ليعلموا من بنا الذي أنفجر به اللغم..
أنا؟ أم البغل؟
(إن تكون شاعراً في عالم كهذا، يعني أن تحاكي شكله المتفجر في الحروب - شيماس هيني)..
هذه المفارقة المهولة وغيرها، ما زالت – للآن - تخلخل حواسي وكياني كله، وتفرش نصوصي بأمطارها الحامضة.. وتذكرني أن حياتنا هي مجرد صدفة في صدفة، أو بعض مفارقة، أو هي "ظل يمشي" - كما وصفها شكسبير -..
كان عبث الموت يتداخل بعبث الحياة، والأرض بحيادها الشاسع تسخر منا بمرارة، وهي تبتلع المزيد من أشلاء قتلانا وقتلاهم في تلك الحروب المجانية، باذخة السخف والموت، والساخرة أيضاً من جشع جنرالاتنا وجنرالاتهم وهم يدفعوننا بقلب بارد إلى الرصاص والنار كأحطاب يابسة، ليزداد وقودها من أجل غنيمة أو وسام مجد زائل أو نزوة أو مصلحة غلفوها بالشعارات الوطنية والقومية والدينية، لتقف الأمهات طوابير في انتظار عودتنا: جنائز أو معوقين أو ناجين..
لقد سُميت حرب الخليج الأولى - الحرب العراقية الايرانية – وقتها - بالحرب المنسية، وقد سكت أو انشغل عنها الجميع وبقينا وحدنا هناك – نحن الجنود، أحطابها المهيئة للوقود - نلوب على السواتر البعيدة طيلة تلك السنوات الثماني (1980- 1988). أمامنا الموت والرصاص، وتحتنا رفات من سبقونا، وخلفنا لجان الإعدام، وفوقنا سماء من دخان وشظايا لا ندري عما ستنجلي.. لم نر صحفياً أو محطة تنقل خرابنا الحقيقي. أطراف سياسية كثيرة، دولية وعربية، وقادة ومفكرون ومثقفون وشعراء وفنانون كانوا يأتون للبلد ولم يكن يهتم بنا أحد، وقد غضوا طرفهم عما يجري هناك، بدوافع شتى: قومية واقتصادية ومذهبية وشعاراتية.. والخ، وكنا نموت ونتعفن وندفن بصمت..
كانت مواسير البنادق في بلدي أكثر من مواسير المياه الصالحة للشرب..
وكان ثمة لونان سائدان في الشوارع هما: الأسود والخاكي..
وكانت أيام الحرب (2) هي الأيام العادية وأيام السلم هي الاستثناء..
وكانت صور ولافتات الشهداء تنصب في زقاق أو محلة ثم لتطوى وتنصب غيرها، في مكان آخر، على مدار الأعوام الثمانية.. وقبل أن يتيبس التراب على رفات من سقطوا في الجبهات أو ينمو العشب على ذكراهم، وقبل أن يكتمل قدوم أسرانا من ايران، قام دكتاتورنا المتهور بغزو الكويت، لتندلع حرب الخليج الثانية، ثم ليلفنا حصار طويل ومرير على مدى ثلاثة عشر عاماً (المدينة المحاصرة تشبه الإنسان في أيامه الأخيرة - أراغون).... ثم لتندلع الحرب الثالثة، ويسقط الصنم من تمثاله في ساحة الفردوس ليرى العالم حشداً من المقابر الجماعية، تفتح أشداقها على امتداد الوطن، صوراً لجماجم وأكوام عظام وثياب ممزقة في أكياس يحملها آباء واجمون وأمهات شاحبات مخمشات الخدود..
وإذا كان الشاعر رامبو يرى أنه "يجب خلخلة الحواس. بعد هذا تستطيع أن ترى ما لا يرى"، فقد صبغت تلك الخلخلة الجنائزية مفردات حياتنا ونصوصنا، وأرتنا عوالم لم يكن لنا تخيلها أبداً حتى في أسفل طبقات جحيم دانتي أو رسالة الغفران للمعري أو روايات الحرب التي قرأناها هناك من "إلياذة" هوميروس، حتى "الحرب والسلم" لتولستوي، ، مروراً بـ"الساعة الخامسة والعشرون" لكونستانتان جيورجيو، بـ"كل شيء هاديء في الميدان الغربي" لأريك ماريا ريمارك، بـ"صمت البحر" لـ"فيركور".. والخ..
كان دافع القراءة والكتابة بالنسبة لي يشبه دافع الحياة أو دافع الحب أو دافع الشهيق والزفير، أنه - بكل بساطة – طبيعي ومعقد في آن، وكان لابد منه تحت أي ظرف كان..
في تلك الخنادق التي عشتها، وجدتني أكتبُ، وأقرأ وأقرأ الكثير من الكتب، كأن "الحياة هي دائماً في مكان آخر" كما ذهبت رواية ميلان كونديرا. وقد داهم خيمتنا يوماً أحد ضباط معسكرنا، وهالته كثرة الكتب المحشوة تحت فراشي ونوعيتها فأمر بمعاقبتي، ووضعي في ذلك الاسطبل المهجور (حوالي عامين 1984-1986) في تلك القرية الصغيرة النائية "شيخ أوصال"، قريباً من الحدود وقد هجرها بعض أهلها وحيواناتها تحت وابل القصف..
تجربة الكتابة هناك في آتون الحرب وبين تلك الألغام والأسلاك الشائكة جعلتني استشعر بالخطر من جانب، ومن جانب آخر بضرورة الكتابة وسطوع الحياة ببهائها الفريد أكثر من أي وقت مضى.. فاستلهم منها سحر التورية فعلاً للمقاومة والبقاء كأني بتمجيد الحياة والجمال والحب أسخر من سطوة الظلاميين وأهجو أعداء الجمال ومشعلي الحروب (القصيدة عمل ثوري - اكتوفيو باث)
ففي نصوص المرايا (3)، مثلاً كنتُ أهرب من الحرب إلى الحب، منتصراً على موتي ويأسي بها.. ولم يقتصر حبي للمرأة, جسداً وروحاً، بل أحببتها وجوداً وتمرداً ورفيقةَ رحلةٍ وكتابةٍ وجنونٍ.
كنت أُكثِرُ من الكتابة كأني أكاثر بها أيامي وأسلحتي، ولهذا أصدرت 6 مجاميع شعرية (4) خلل سنواتي في العراق (أنتَ تستعجل الكتابة، كما لو أنك متأخر في الحياة - رينه شار)، كنتُ أخشى أن تضيع أوراقي في صدفةٍ أو ريح، مثلما أخشى أن تضيع حياتي بلغم أو وشاية أو طلقة، فكان لا بد من تدوينها وحفظها بالكتابة.. وهكذا أصبح فعل الكتابة بالنسبة لي فعل وجود وشهوة وشهيق.. لائذاً به من هجير الزمان والدخان (أحياناً تتجلى السعادة في لحظة سفرنا داخل النص أو عندما يسافر النص الأدبي داخل حياتنا ليستوطن فيها ويتمكن منا فيجعلنا نعيد كتابة الآخر بعد لحظات التعايش بيننا وبين ما وراء الكلمات.. - رولان بارت)..
كأن النص سرد لحياة لامرئية، لكنها أكثر سطوعاً من حيواتنا المنسية هناك.
ألهذا كنت أتمسك به بديلاً، أو يوتوبيا في رحلة البحث عن ايثاكا، عن القصيدة..
في نص لي أقول:
"نسيتُ نفسي على طاولةِ مكتبتي
ومضيتُ
وحين فتحتُ خطوتي في الطريق
اكتشفتُ أنني لا شيء غير ظلٍّ لنصٍ
أراهُ يمشي أمامي بمشقةٍ
ويصافحُ الناسَ كأنه أنا" (5)....
في بداية الحرب، أو بدايات النشر، سأنسل من المعسكر في شاحنة طويلة كانت متجهة إلى بغداد، مندساً بين أكياس الرمل وصناديق العتاد، حاملاً مخطوطة ديواني الأول "انتظريني تحت نصب الحرية"..
كنت شارداً أتغرغر بحلم عشريني مسكر أنني إذا ما متُّ في أي لحظة، أو شظية، فأن ديواني هذا سيعيش بين أيدي القراء وتحت وسائد القارئات الجميلات، مستذكراً حسرة السياب الأزلية:
"ديواني شعري ملؤه غزل
بين العذارى بات ينتقل" (6)
وصلت إلى شارع الجمهورية حيث دار الشؤون الثقافية العامة وفيها كانت الموظفة البدينة بعينيها العسليتين تتأمل مخطوطتي وسحنتي الشاحبة ثم تنحدر إلى بسطالي المغطى بالطين، وهي تحاول جاهدة إخفاء ابتسامة إشفاق أو سخرية،.. لا أدري؟
تركتُ مخطوطة ديواني على طاولتها المكتظة وعدتُ أدراجي، لتقودني قدماي إلى شارع المتنبي وسوق السراي حيث الكتب والعابرون ورائحة الورق تثير شهيتي، منحدراً باتجاه مقهى البرلمان حيث صخب الأدباء ونقاشاتهم المتواصلة والمتعالية رغم بيانات الحرب وزعيق الأناشيد وطقطقات الدومينو، ووجدتني بين الخجل والتردد أدون أول نصٍّ لي هناك بلغة مباشرة واضحة وربما جارحة:
"ودلفتُ إلى مقهى الأدباءِ.. وحيداً، مرتبكاً، أتحاشى نظراتِ الشعراءِ الملتفين على بعضهمُ، وحواراتِ النقاد… وجدتُ لنفسي كرسياً مهترئاً.. أتردّدُ بعضَ الوقتِ، وأجلسُ منحشراً قربَ دمي المتوجّسِ، أرنو لوجوههمُ ملتذاً.. أتذكرُ أني أبصرتُ ملامحَ بعضهمُ تتصدرُ أعمدةَ الصحفِ اليوميةِ، والكتبَ الزاهيةَ الألوانِ… سعلتُ قليلاً من بردِ الطرقاتِ، وأقبيةِ الأعوامِ الرطْبةِ، والريحِ!… خشيتُ بأني سأعكّرُ صفوَ تأملهم بشحوبي وسعالي…
حاولتُ بأن أتلهى بتصفحِ ما بين يدي من صحفِ المقهى…
كانتْ نفسُ الأوجهِ تبرزُ من خللِ الأسطرِ، تحدجني ببرودٍ لمْ أفهمْهُ!…
جاءَ النادلُ… لمْ "يتواضعْ" أحدٌ أنْ يطلبَ لي شاياً!
فطلبتُ من النادلِ… أن يأتيني بالبحرِ، وزقزقةِ الغاباتِ المنسيةِ في كراساتِ طفولتنا، ورسائلِ حبي الأولى تحت وسادةِ بنتِ الجيرانِ، ونوحِ نواعيرِ أغانينا فوق ضفافِ الكوفةِ، والقمرِ الحالمِ، والدفلى، وأراجيحِ العيدِ، وركضِ الصبيةِ تحت رذاذِ المطرِ العذبِ، وأشعارِ الحبِّ المخبوءةِ في قمصانِ التلميذاتِ، ورائحةِ البردي!.....
هزَّ النادلُ كتفيهِ ذهولاً، ومضى يضحكُ من أحلامي المجنونةِ..
– لا بأسَ!… سأطلبُ شاياً!
كان المقهى يغرقُ في ثرثرةِ الروّادِ، وغيمِ سجائرهم،..
وأنا وحدي أغرقُ في غيمِ دمي الماطرِ فوق الأوراقِ، وأرصفةِ العالمِ،.. منشغلاً بقصيدةِ حبٍّ بائسةٍ بدأتْ تنقرُ نافذةَ القلبِ – بكلِّ هدوءٍ – وأحسُّ خطاها تتسلّلُ عبرَ دمي والأدغالِ المصفرّةِ..
قلتُ لعلَّ الفاتنةَ الدلِّ تشاركني طاولتي، والغربةَ!..
في خجلٍ.. أخرجتُ – من المعطفِ – أوراقي البيضاءَ كقلبي…
حدجتني الأعينُ!.. وابتدأتْ همساتُ النقادِ، الشعراء، تحاصرني…
لمْ أتمالكْ نفسي..! لملمتُ بقايا أوراقي، وخرجتُ إلى الشارعِ – مندفعاً – تحت نثيثِ الأمطارِ وريحِ الغربةِ والكلماتِ المجنونةِ.. أبحثُ عن طاولةٍ هادئةٍ في هذا العالمِ…
تكفي لقصيدةِ حبٍّ بائسةٍ،
وأغاني رجلٍ جائعْ" (7)
.......
لكنني وفي أول أمسية لي أيضاً في اتحاد الأدباء (7/11/1984) سأقرأ هذه القصيدة.
وكان المثير بالنسبة لي أن البعض من هؤلاء الأدباء سألني: من تقصد؟
ولم أكن أقصد أحداً حقاً!
(خذ كاميرا، أرادت أن تقول لي / وصور حياتك / أن تفقدها ذات يوم / ستبقى لك على الأقل نسخة - الشاعر روني سوميك)
.........
وذات يوم وأنا متمدد على يطغي الزنخ في ذلك الاسطبل (الذي صار عالمي وسجني) جاء أحد الجنود هارعاً وهو يمسك بجريدة متسخة وجدها في حاوية الأوساخ: أهذا أنت يا رجل؟
نظرت إلى الجريدة، كانت صورتي وسط مقالة طويلة كتبها الناقد المعروف عبد الجبار داوود البصري عن مجموعتي تلك "انتظريني تحت نصب الحرية"..
ياه.. طرت من الفرح، ثم اصطدمت بسقف الصفيح الوطيء. كانت هي أول مقالة أقرأها في حياتي عن أول ديوان لي...
لكن أين أنا الآن؟...
ودون أن أدري اتكأت على كوة الاسطبل وانهمرت ببكاء مرٍّ..
السنوات تمضي ببؤسها الطويل وأفراحها البسيطة المقتطعة عنوة من لحم السنوات المر، ويصدر ديواني الثاني "أغنيات على جسر الكوفة" مكللاً بمقدمة للشاعر الكبير عبد الوهاب البياتي، ثم ديواني الثالث "العصافير لا تحب الرصاص"، لأجد نفسي في عام 1986 جندياً منقولاً إلى جريدة القادسية ثم إلى مجلة حراس الوطن، لأعدَّ للقسم الثقافي أبواباً لم تكن مالوفة في مجلة عسكرية، وأجري سلسلة من حوارات ثقافية شهرية جريئة في طرح أسئلتها، لعدد من المبدعين أذكر منهم: عبد الرحمن طهمازي، محمد خضير، د. علي عباس علوان، فؤاد التكرلي، عيسى الياسري، مدني صالح، د.علي جواد الطاهر، سامي مهدي، عبد الرزاق عبد الواحد (قطع حوارنا محتداً، غاضباً، ثم عاد إليه)، حميد المطبعي، ديزي الأمير، عريان السيد خلف، فاضل ثامر، ياسين النصير، رشدي العامل والذي فاز حواري معه بالجائزة الأولى عام 1988 في مسابقة نقابة الصحفيين.. قبل أن يسيطر أبن الطاغية، الأهوج، عدي صدام حسين على شؤون الثقافة والفنون والصحافة حيث ستصفه إحدى الاستفتاءات التي أجراها زبانيته وصحيفته، نهاية التسعينات بأنه "أهم صحفيي القرن العشرين"!!...
كيف تسنى لي أن أخرج من تلك الأوحال والأسلاك والحروب، بحلمٍ غير معطوب، وقلم غير مسلوب، إلى آخر تلاوين السجع، وما يحمله من إيقاع كأنه الأنين ، وقد عشت المشهد برمته، فاتحاً عيني على اتساعهما، لأرى كل شيء آخذاً باستشراف الرائي الأول كلكامش، أبي الأول "الذي رأى كل شيء.. وخبر البلاد"، وبهوس ابن المقفع الذي كان يرى أن رؤية الأسد "تُجرّؤكَ" عليه، قبل أن ينتبه الرقيب العربي الأول إلى سحر التورية وفعلها الجريء في خطاب "كليلة ودمنة"، فيلقي به في تنور مسجور..
آخذاً باندفاعة المتنبي وشطحات النفري وعربدة أبي نؤاس وخشبة دعبل..
باشراقات رامبو، بزيتون لوركا، بعبث سافو، بسونيتات شكسبير، بعشب والت وايتمن، بتموجات سان جون بيرس، بتلويحات كافافي..
منساقاً، عنوة، للسير في حقول الألغام، تلك التي تعلمتُ منها الكثير في الحياة والكتابة على وجه الخصوص رغم ما خسرته من مكابدات وليالٍ ممضة تقلبتها على جمرات الأرق والقلق..
واليوم أجدني استرجع تلك المسالك المهولة التي أخذت الكثير من أصدقائي:
من أعتزل، أو أُغتيل، أو تشرّد، أو سقط..
سائراً مع القلة الذين واصلوا بالشظف والمكابدة ذلك الطريق الأبهى، ماسكين بالجمرة أو الشعلة إلى النهاية، كأنني أتنهد تلك المقولة: "آهٍ، من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق" (8)..
ثم أستدير إلى قبر علي الرماحي (9) وأغص بدمعي وأقول له: كيف اختصرت المسافة بين القصيدة والشهادة بهذه العجالة.. وظل دمك لوحده بيننا يكتب ويضيء..
أستدير إلى قبر حميد الزيدي (10)، وضرغام هاشم (11)، وعبد الصاحب البرقعاوي (12)، ومحمد عباس الدراجي (13)، وعزيز السيد جاسم (14)، ومحمد حسن الطريحي (15)، وحاكم محمد حسين (16) ، وحسن مطلك (17)..
وقائمة الذبح والأنين تطول..
وأراني، في تلك الأيام المنقبضة هناك، وحيداً ومنكمشاً "في العراءِ المسجّى على وجههِ" (18)، أقلّب مرتجفاً، "بريد القنابل" (19)، وأعجب كيف "خرجتُ من الحرب سهواً" (20)
..............
كيف تسنى لي أنا أبن الكوفة الغافية بظمئها الطويل على ضفاف الفرات أن أخرج من مخاوفي وأصرخ - ذات يوم من عام 1993 على مسرح الرشيد في بغداد - على لسان عبود، بطل مسرحيتي "الذي ظل في هذيانه يقظاً":
"شققني عطشي في بلاد المياه" (21)..
ثم أنسلُّ بين الجمهور المحتشد تاركاً زفراتي الأخيرة:
"وداعاً بلاد المجاعات والنفط" (22)
قبل أن أغادر القاعة أو الوطن بشهور قليلة.
كأني أستعيد حكاية عود الفارابي الذي أضحك الملك وحاشيته وأبكاهم ثم أنامهم جميعاً وأنسل من البلاط..
هل يملك الشعر هذه القدرة الساحرة، على تنويم رقيبه أيضاً؟
.................
في بواكيري الأولى عام 1976 سأذوق لوعة الفصل من الدراسة بسبب قصيدة كتبتها وتناقلها الطلاب، ويموت أبي - المعلول بالسل والديون والطيبة - على سريره في مستشفى الكوفة، متأثراً بالحادثة.. لأذوق بعدها مرارة التشرد والخوف والحرمان..
وفي عام 1979 سأذوق مرارة الفقد، بعد اعدام صديقي المدهش علي الرماحي بسبب قصائده التي تناقلتها ألسنة المنابر والناس..
هذه الصور، وغيرها، المحفورة بالألم والخوف حملتها معي لسنوات طويلة في دوامات الرعب.. كانت تتقافز أمامي، ومعها روحي اللائبة لأقل هزة وأقل "طرقة ليل". وما أكثرها في وطني..
"أقلّ قرعة بابٍ
أخفي قصائدي - مرتبكاً - في الأدراج
لكن كثيراً ما يكون القرع
صدىً لدورياتِ الشرطةِ التي تدورُ في شوارعِ رأسي
ورغم هذا فأنا أعرفُ بالتأكيد
انهم سيقرعون البابَ ذات يوم
وستمتدُ أصابعهم المدربةُ كالكلابِ البوليسيةِ إلى جواريرِ قلبي
لينتزعوا أوراقي و….. حياتي
ثم يرحلون بهدوء" (23)
وقد انطبعت تلك الأيام والصور المريرة في ذاكرتي، لأتعلم منها أول الدروس وأقساها: أن للكلمة مفعولها السحري، لكن لها أثمانها الباهظة..
ولأرى أمامي ثلاث طرق أو أربعاً.. (وأياً كنت يا طرقي فكوني نجاةً أو أذاةً أو هلاكاً) (24):
- أن أهرب من بلادي (ولأنني لم أكن – وقتها - أملك وسيلة أو سنداً، ألغيتها من قاموس رأسي)
- أن أسكت للأبد..
- أن أقامر برأسي..
- أن أستعين بفن الخطاب المستتر.. ووجدتُ في هذا الأخير أغراءً في المغامرة والتحدي والإبداع معاً.. خاصة وأن مقص الرقيب الحديدي لم يكمن يترك لنا أقل فسحة لنطل برؤوسنا الضاجة خارج ما هو مسموح به..
كانت الكتابة فيه تحتاج إلى مهارة وبراعة كبيرتين.. وكان الأسلوب التأويلي الذي تعتمده، مجترحاً من طبيعة الواقع والفن، شكلاً ومضموناً، يأخذ من اللغة بهاءها الآسر وسطوعها، ومن اشكاليات الواقع حذره وشكله وشكه وتمويهاته، (كما تكون الحياة كذلك يكون المبنى – كوليردج) ووجدته أكثر استيعاباً لقلقي وعصري، ووجدتني أكثر قدرة على تطويعه لتحميله ما أريد..
هذا التمويه الفني لجأ إليه بعض شعراء الداخل، كان عاملاً مهماً لتجاوز الخطوط الحمراء الكثيرة والواقع البوليسي الذي كان يخيم على كل شيء في الوطن، ليس في مجال الشعر فحسب بل في مختلف الفنون والآداب وشؤون الحياة الأخرى، فكنا نجد فيه متنفساً تعبيرياً وفنياً وحياتياً..
لكنه من جانب آخر، جر علينا ما جر من وشايات المخبرين والأدباء الفاشلين - في الداخل - (كنا نعرف الرقيب ونتحايل عليه، ولكن الجديد في الكتابة اليوم أننا لم نعد نعرف من يراقب من، وما هي المقاييس الجديدة في الكتابة - أحلام مستغانمي) (25)،
و - في المنفى - أخذ منه بعض المزايدين، على عذاباتنا، سطحه الظاهر ونسوا أعماقه التي تمور بالغضب والوجع والاحتجاج.. (أتركونا أحراراً عندما يتعلق الأمر بالكتابة - ميشيل فوكو)..
وبين أُولئك وهؤلاء، (رقباء الداخل) و(تجار الخارج)، كنا عصيين عليهم، خارجين على تفسيراتهم وتقسيماتهم الأدبية والايديولوجية، مستوحدين في القصيدة، ملتصقين بوجع الناس وهموم الوطن..
"الفاشيون
والشعراء المخصيون
يقفون..
على طرفي حبلٍ،
معقودٍ في عنقي
و يشدونْ" (26)
لكن يمكن القول هناك العديد من الأدباء والفنانين الصادقين والمبدعين كانوا لنا سنداً بهياً ومتيناً ساعدونا على تخطي تلك الأيام الممضة، ووجدنا في المنفى مثلهم الكثير، تعذبوا وتشردوا لأنهم كانوا مبدعين وصادقين مع فنهم وأنفسهم وقد وجدنا فيهم المرفأ والواحة..
أنا من جيل شعري في العراق سمي "جيل الثمانينات" أو "جيل الحرب"، أو "جيل الظل" (27)، جيل نشأ في بداية الكارثة، وكبر وشاخ فيها، عشنا الخراب والدم والقمع والحصار والغربة، منفيين في الوطن أو شهداء على لائحة الانتظار.
وفي خضم ذلك الواقع البائس واليائس، كنت أرى في النص الحر الجميل المبدع، جسراً ضوئياً إلى الإنسان والحرية والحب.. بل وفعلاً ثورياً وجمالياً أكثر مما يفعله بعض السياسيين والأحزاب والتجمعات..
ومن جانبٍ آخر كنت أرى فيه الرد الحقيقي على الفاشيين والظلاميين أو المزايدين والموهومين أو السماسرة.. (غاية الأدب هي أن لا يطلق الغبار بل الوعي. - وول سوينكا)، منتبهاً أيضاً لمقولة لوكاش: "قد تخطئ حركات وأحزاب ولكن على المثقف أن يرفع صوته عالياً بوجه هذا الخطأ"..
لقد عمل جنرالات الحروب وتجار السياسة والعقائد على تغييب الوعي ومن ثم غيبوا الإنسان ثم غيبوا الوطن.. وهذا الغياب المقصود هو الذي أطال بعمر الدكتاتورية وأتمنى أن لا يتكرر هذا الغياب ليطيل من عمر خرابنا واحتلالنا وشتاتنا..
لقد آن الأوان لنا جميعاً للمراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر - لا من سلطة الرقابة على النصوص وحدها بل - من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في وطننا وعالمنا..
آن الأوان لإشاعة مفاهيم الحرية والوعي والاختلاف وتفعيل النقاش وتنشيط الأسئلة القلقة حول كل ما مر ويمر بنا، وكل ما يحيطنا.. حول مشكلاتنا التاريخية والمعاصرة، حول موروثنا وحداثتنا وإبداعنا..
إن الإبداع الحر هو الأكثر تعبيراً والتزاماً بالإنسان من مفاهيم الالتزام التي دوخنا بها منظرو الاشتراكية والقومية والرأسمالية.. كما إن النص المبدع يحمل في نسيجه دائماً ديناميت التفجير والتغير..
وعلى هذا، لا يمكنني أن انظر إلى المنشورات الإعلامية والقصائد الحماسية الآنية على أنها أدب خالص مهما أخلص كاتبوها لقضاياهم. هناك فاصلٌ دائماً بين أدب الشعارات والإبداع..
فكثيراً ما تسعى السلطات أياً كانت وخاصة في بلادنا إلى تحويل الكاتب أو الفنان إلى مجرد بوق أو مهرج أو تابع، عليه أن يكون جاهزاً تحت الطلب, فحين تتخاصم مع دولة أو فكر تريده أن يشتم تلك الدولة أو ذاك الفكر، قارعاً معها طبول الحرب! وحين تتصالح تريده أن يمتدحها ويمجد السلام.. كذلك تسعى بعض المجتمعات الاستهلاكية لتحويله إلى مجرد سلعة..
انهم يحاولون توظيف الأدب لخدمة ايدولوجياتهم السياسية أو السلعية. وهنا نتلمس بوضوح خطورة الشاعر - أي شاعر - حين يتحول إلى ببغاء للشعارات والبيانات التي تُملى عليه.. ويطالب الآخرين أن يحذوا حذوه وإلا فأنهم عملاء أو خونة..
إن بعضهم يتعذب، يثور، ثم تروضه المؤسسة وينظم إلى قطيعها..
وبعضهم يخدرهم الخوف أو الوظيفة أو الشهرة، فلا يكاد يرى في مرآة ذاته أبعد من ذاته..
لكن الشاعر الحقيقي المتجذر بوجع الأرض والإنسان، حين يكون بركاناً لا يهدأ، فأن أي شيء لا يستطيع إيقافه.. أنهم يستطيعون أن يقتلوا الشاعر جسدياً أنهم يستطيعوا تشويهه أو سلب حياته،.. لكن نشيده لن يتوقف أبداً.. وأمثلة التاريخ أكثر من أن تعد: من الحلاج إلى لوركا، قديماً وحديثاً، شرقاً وغرباً..
إن علينا أن نحرر الأدب من الدكتاتوريات المتوارثة عليه وإطلاق سراحه ليعيش حراً كما كان..
وعلينا أن نقف ضد القمع والظلم أينما وجد وليس في بلادنا فقط, مثلما يغض البعض طرفهم عن الدكتاتوريات التي يعيشون في كنفها في البلاد الأخرى وينقدون دكتاتوريات بلدانهم أو بالعكس. الظلم لا يتجزأ..
وعلينا أن نقف ضد كل عملية استغفال للجمهور وضد كل من يسعى إلى دفعه إلى مطحنة الحروب باسم الدين والوطن والثورية.
الثقافة العربية مهددة من الداخل والخارج معاً، وهي معركة مستمرة ومتعددة تتنوع بين الاستبداد وحرية الفكر والتعبير والتعددية وسلطات التجهيل السائدة التي هي سلاح من أسلحة الأنظمة الحاكمة، وهكذا دواليك..
إن واجب الكاتب الثوري الأصيل أن يدافع عن استلاب العقل وغياب الحريات، فاذا لم تتكاتف معه كل القوى الشريفة والمتنورة التي تؤمن بقيم الجمال والحرية والحق لمواجهة ثقافة الظلام التي تشيعها الأنظمة الدكتاتورية وأتباعها من القوى الظلامية، فأن أجيالاً قادمة ستنهار وتنتكس وتعاني، وسيكون حكم التاريخ علينا جميعاً بأننا قد تخلينا عن مسؤوليتنا.
.. في يوم من أيام مهرجان الشعر العالمي في هولندا (1997)، كنت أتمشى تحت نثيث الندى الخفيف في تلك الشوارع الهادئة من روتردام وأنا عائد من إلقاء قصيدتي. جلست أمام طاولة ووضعت العاملة ما طلبت من طعام. سرحت بعيداً إلى أيام الخنادق وجبهات الرصاص. جاء عصفوران جميلان وبدءا ينقران بهدوء من طعامي ويتناغيان ويتعانقان بأمان. تركتهما يفعلان ذلك رغم جوعي وبدأت أرقبهما وأنا أسترجع مناقير الشظايا التي كانت تنقر طعامنا وأرواحنا وأصدقاءنا. فجأة أخرجت ورقتي ووجدتني أكتب:
"العراق الذي يبتعد
كلما اتسعت في المنافي خطاه
والعراقُ الذي يتئدْ
كلما انفتحتْ نصفُ نافذةٍ.. قلتُ: آهْ
والعراقُ الذي يرتعدْ
كلما مرَّ ظلٌّ
تخيلّتُ فوّهةً تترصدني، أو متاهْ
والعراقُ الذي نفتقدْ
نصفُ تاريخه أغانٍ وكحلٌ..
ونصفٌ طغاهْ" (28)
...
مندهشاً وملتاعاً - الآن - في الوقت نفسه..
كيف تسنى لهذا الوطن أن يعيش:
بين ملحمة كلكامش وصدام حسين
بين زقورات بابل وسجون الرضوانية
بين "أحنه مشينا للحرب" و"حييتُ سفحك عن بعدٍ فحييني"
بين "نصب الحرية" لجواد سليم، و"صور من المعركة"
بين أغاني ناظم الغزالي، وسياط علي حسن المجيد
بين قصائد حسين مردان، و"زبيبة والملك"
.............
أصدقائي في السويد لا يستطيعون أن يتفهموا بسهولة كيف تسنى لهذا الشاعر أن يخرج من بين تلك الشظايا والأوحال والأسلاك ويواصل الحياة والكتابة بتلك الاندفاعة المجنونة عن الحب والحياة "هل خطأٌ أن نحبَّ الحياة؟"..
مثلما لا أستطيع أنا أن أستوعب كيف لم تمر في سماء هذا البلد قذيفة مدفع منذ أكثر من مائتي عام، وكيف يمكن لشرطي المرور أن يوقف ملك السويد0 Gustav XVI Adolfويغرمه لأنه ساق سيارته أكثر من الحد المسموح به في الطريق العام، كما نشرت ذلك الصحف السويدية قبل فترة، ولا أعرف كيف يكرس شاعر اسكندنافي مثل بو كرين ينسن Bo Green Jensen حياته وشاعريته لكتابة 14 ديواناً شعرياً عن زهرة واحدة، هي وردة الجوري Rosen..
في لقاءاتنا على هامش أمسية شعرية، أو حوار أو مصادفة في مقهى أجد أن ليس اللغة أو لون البشرة هو ما نختلف به عنهم، ثمة شيء أكبر: الحرية في كل شيء، الإحساس التام بالاطمئنان، الثقة بالغد، طريقة التفكير وأسلوب الحوار والتعامل مع المرأة والدين والحكومة والقطط، والخ
سألتقي الشاعر السويدي الكبير توماس ترانسترومر في مهرجان جمعنا في قاعة المرايا لأسترجع قصيدته:
"جئتُ لألتقي ذلك الذي يرفع فانوسه لكي يرى نفسه فيَّ.."
كأني أرى في المرايا وجوه الأدباء الشاحبة في مقهى حسن عجمي حيث الدخان وأخبار الحرب والنقاشات الحداثوية وبعض آذان لفئران تسترق السمع....
كأني أرى ذلك الآخر - في النصف الآخر من العالم – يردد معي:
"وتقول لنفسك: سوف أرحل
لا أمكنة أخرى هناك
آه ألا ترى أنك يوم دمرت حياتك في هذا المكان
فقد دمرت حياتك في كل مكان على وجه الأرض" (29)
كأني أرى ذلك الآخر، - في النصف الآخر من التاريخ – حاملاً خشبته في دروب بغداد وهو ينشد:
"سأقضي ببيتٍ يحمد الناس أمره
ويكثر من أهل الرواية حامله
يموت رديء الشعر من قبل أهله
وجيده يبقى وأن مات قائله" (30)
كأني أرى حيوات أصدقائي تضيء في ذلك الليل البهيم، مشيرة إلى وميض نجمة في البعيد..
لكن أين أجدهم الآن: حسين حيدر الفحام (31)، علي عبد الحسين (23)، كاظم الخطيب (33)، مضر علوة (34)، حميد الزيدي، عبد الحي النفاخ (35)، و.. و...
[على أريكة معزولة في فندق القدس في عمان، أواخر أيام الروائي والكاتب جبرا ابراهيم جبرا، جلسنا معاً ورويت له حكاية مرعبة بطلتها روايته "البحث عن وليد مسعود" التي أستعارها حميد الزيدي من صديق أعدم ثم استعارها منه عبد الحي النفاخ قبل إعدام الزيدي واستعرتها من النفاخ قبل أن يجن وقد تركتها قبل سفري عند أحد الأصدقاء فارتجف جبرا رعباً" (36) (الأصعب ليس أن يموت المرء، بل أن يموت الذين حوله - كلهم – ويبقى هو حياً - تولستوي- من رواية "الحرب والسلم")]
.....
في تلك الأيام المرة، من سنوات الحرب الطويلة، أجد قلمي يتسلل في صحبة الاصدقاء،: الشاعران، عبد الرزاق الربيعي وفضل خلف جبر، والقاص اسماعيل عيسى بكر، والفنان التشكيلي كريم العامري، وأنا أدعوهم بهوس إلى جولة ليلية تسكعية بين حانات بغداد الصاخبة وملاهيها وفنادقها الفخمة، للقيام بعملية تحفيز للمخيلة وتمرين في الكتابة عن تلك الأجواء الخرافية التي كانت تتردد في أسماعنا معجونة بالمثير والكثير بالنسبة لنا - نحن الأدباء الصعاليك والجنود الذين لم نكن نرى أبعد من كراج النهضة أو العلاوي – (أمضيت حياتي في كتابة الشعر، أو الأصح في تعلم كتابة الشعر الشاعرة أميلي دنكسن – من حديث لها عن تجربتها في كتابة الشعر..)، ننطلق بالمصعد الزجاجي إلى أعلى طابق في الشيراتون لنرى بغداد كأننا سوف لن نراها أبداً.. ثم فجأة صرختُ بهستريا: اغمضوا عيونكم.. لننطلق إلى كراج النهضة، نفتحها على مشهد الجنود يتدافعون إلى الباصات باتجاه جبهات الموت، وحيث وداع الأباء ودموع الأمهات والزوجات. وأمام باب مفرزة الانضباطية العسكرية ثمة توابيت ممتدة إلى مسافة ليست بالقصيرة، ومغطاة بأعلام عراقية تنتظر من يحملها إلى ذويها المساكين..
ثم لنكمل المشهد، في اليوم التالي...... لا لن أستمر بالسرد... سأترك لصديقنا القاص اسماعيل عيسى بكر أن يسرد عليكم نهايتها الفنتازية المجنونة التي صورها في قصته: "ليلتان أو خمسة أصابع مالحة"، عام 1986 والتي أرسلها إلى أكثر من صحيفة ومجلة، لكنهم امتنعوا عن نشرها:
"حين خرجنا من الملهى, لم يكن لدينا ما نفعله سوى الحزن الذي راح كل منا يرسم خارطته كيفما يشاء بخطوط مختلفة, وألوان متناقضة, في القلب.. على الورق.. بالأصابع.. بالعيون.. في وطأة الرأس المخمور.. بالكلمات والدموع والقصائد. عندها رسم عدنان ببوله المخمور وطناً واسعاً على شكل دائرة مغلقة فأخذنا نرقص داخلها مهووسين بقصاصاتنا السرية رقصة أفريقية ماجنة على إيقاع مهتاج بألم ممض سحيق, نلهث أحلامنا المحمومة ونتبادل النظر في الوجوه مثل غرباء حوصروا فجأة وسط متاهة لا تفضي إلى أي مكان سوى الجحيم, كنا تماماً نرقص داخل جحيمنا. "يا أنتَ يا سيء.. يا من هناك.. يا متخلف.. وأنتَ تمهّل.. "فالعمر قصير كفستان مراهقة".. يصرخ عدنان, وأصيح أنا "كوني عاقر يا أم الشهداء" وتصايحنا جميعاً "تغيرت الآن بغداد يا أولاد الكلاب.." وحين نشف بول عدنان في ذلك الليل البارد غادرنا الوطن"...
والآن أين هم أصدقائي:
اسماعيل عيسى بكر، قاص، ظل في العراق لكن الموت لم يمهله فتوفي مبكراً بداء السكري في سنوات الحصار، وهو في عز توهجه الإبداعي.
فضل خلف جبر، هاجر مبكراً بعد انتهاء حرب الخليج الثانية إلى صنعاء ومنها إلى امريكا ليواصل حفرياته الشعرية وليتزوج هناك..
عبد الرزاق الربيعي، حمل حقيبته التي لا تحتوي على أكثر من فرشة أسنان وشرشف ومخطوطات لمقالات وقصائد شعر، ليعمل في الصحافة في عمان بربع راتب ثم يتجه إلى صنعاء، ويمكث لسنوات مدرساً، ثم يرحل إلى مسقط ليتزوج هناك ويستقر.
كريم العامري، فنان تشكيلي، انقطعت أخباره تماماً..
وأنا هنا، في هذا المنتأى البعيد، استرجع ما مرّ بي بفم فاغر وعينين مغرورقتين بالمواويل والدموع، محاطاً بهذه الثلوج التي لم تكن تخطر لي على بال.. (لندع الأفكار تنمو كأغصان الشجر، ولكن ماذا لو غطاها الثلج - الشاعر التشيكي أنطونين بارتوتشيل)
وأستذكر ريلكة في إحدى رسائله التي كتبها لشاعر شاب: "لا شيء فقير أمام المبدع، كما ليس ثمة أماكن فقيرة، لا دلالة لها، فحتى لو كنت في سجن تخنق جدرانه كل ضجيج العالم، أفلا تبقى لك دائماً طفولتك، هذه الثمينة، هذا الغنى الملكي، هذا الكنز من الذكريات والإنطباعات التي سالت على حوافها"..
..........
" استودع الله في بغداد لي قمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه
ودعته، وبودي لو يودعـــــــني صفو الحياة وأني لا أودعــــــه
بيتان من قصيدة لابن زريق البغدادي
ومساء آخر من ليل المنفى
وعلى الطاولة ورق وأغنية لم أعد أتذكر بقيتها تقول:
"مالي صحت يمة أحا جا وين اهلنه"
وتبدأ القصيدة...
براعمها تتفتح في روحي بكسل عذب تحت هذه الشمس الناعمة. تكبر، تستطيل أغصانها لتغدو غابة، أتذكر لحية الجندي القتيل على الساتر القريب ذات ظهيرة من سنوات الحرب، وأنا أراه من بعيد، من موضعي تحت الشمس اللاهبة، وقد أخذت لحيته الكثة تنمو وتنمو وتكبر حتى لتغدو غابة...
كنتُ قد نسيت تلك الصورة، في زحمة السنوات اللاهثة، ثم وجدتها تنبثق فجأة أمامي في سنوات حريتي الأولى في عمان (28/9/1993)، أمام رجل عراقي يتوسد حقيبته ولحيته الكثة في الساحة الهاشمية، مستسلماً لنوم عميق، تماماً كأنه ذلك الجندي القتيل المسجى على الساتر.. ووجدتني أجلس في مقهى على مبعدة من المشهد أسطر تلك القصيدة بتلقائية عجيبة.. وأنهض بعد أقل من ساعة..
"الجندي، الذي نسي أن يحلقَ ذقنَهُ، ذلكَ الصباح
فعاقبهُ العريف
الجندي القتيلُ، الذي نسوه في غبارِ الميدان
الجندي الحالمُ، بلحيتهِ الكثّة
التي أخذتْ تنمو، شيئاً، فشيئاً
حتى أصبحتْ ـ بعد عشرِ سنوات ـ
غابةً متشابكةَ الأغصانْ
تصدحُ فيها البلابلْ
ويلهو في أراجيحها الصبيانْ
ويتعانقُ تحت أفيائها العشاقْ
..........
الجندي.. الذي غدا متنـزهاً للمدينة
ماذا لو كان قد حلقَ ذقنَهُ، ذلك الصباح" (37)
وعلى العكس من هذه القصيدة، التي سميتها "في حديقة الجندي المجهول"، ظلت قصيدة "في الأرض الحرام" معي مدونة على الورقة بتخطيطاتها الأولية دون إكمالها لأكثر من ست سنوات (رغم قصرها) وهي تتحدث عن جندي قتيل، وجده جنود الرصد بعد انبلاج الفجر، أمام سواترهم المتقابلة والمتقاتلة، وهو مسجى في الأرض الحرام، وقد تناثرت ثيابه وحاجياته وبضعة ألعاب أشتراها لأطفاله. كان يبدو أنه ذاهب في اجازته الدورية... ولم يكن أحد من الطرفين يعرف لمن هذا القتيل؟
وقد نشرتها بعد خروجي من الوطن في ديواني "تحت سماء غريبة" عام 1994..
.......
طول العمل أو قصره ومثله زمن الكتابة، لا يعني الكثير بقدر ما يعني النص نفسه.
لقد وضعني المناخ الذي عشته في ذلك الاسطبل الغرائبي عام 1984 في جو قصيدة بدأتها ولم أكن أشأ أو أتوقع - حين أنهيتها في بيروت عام 1996 - بأنها ستكون بهذا الطول، أنا الميال غالباً إلى قصر القصيدة وتكثيفها إلى أقصى حد.. لكنني بعد هذه القصيدة، "نشيد أوروك" (38)، وجدتني في الكثير من ديوانيَّ: "تكوينات" و"تأبط منفى"، أعود إلى قصيدة الومضة من جديد.
إن المناخ العام والخاص للشاعر هو الذي يفرض موضوعة القصيدة وإيقاعها وطولها وشكلها. فتأخذ القصيدة غالباً مدياتها من هواجس الشاعر الداخلية والمناخ العام الذي يعيشه: سياسياً وثقافياً واجتماعياً والخ. وهذا كله – بالاضافة إلى المكونات والقراءات – هو ما يتحكم بنتاج الشاعر سواء قصد ذلك أم لم يقصد..
إن الحياة المبعثرة التي عشتها هناك، وبعضاً منها هنا، تسرب الكثير منها إلى سطوري، وحاولت أن ألتقط منها في قصيدتي تلك، "نشيد أوروك"، فالحياة نفسها قد تصلح مادة ثرة لعمل أدبي إذا أجاد الكاتب تسخيرها في نصوصه بفنية عالية، لهذا سماها ماركيز بالواقعية السحرية، فالواقعية في الفن - وفي الشعر تحديداً - ليست كاميرا فوتوغرافية تنقل الأشياء والتفاصيل بحياد بارد.. بل لا بد من إضفاء المسحة الشعرية عليها، لكي تبتعد عن اللغة التقريرية المباشرة التي استهلكها بعض الكتاب في روسيا وغيرها من بلدان المعسكر الاشتراكي بل وبعض كتاب المعسكر الغربي..
بعد "نشيد أوروك"، وفي أواخر أيامي في بيروت وأول أيام منفاي في جنوب القطب الشمالي، بدأتُ أشتغل على نص جديد مفتوح سميته (نرد النص)، ربما يُعد استكمالاً له، لكن بطريقة تناول جديدة ومختلفة.
..........
في الصيف الأول من وجودي في مدينة مالمو السويدية، دُعيتُ لإلقاء مجموعة من قصائدي في مهرجان أيام الشعر العالمية في مالمو، وكم دُهشت حين استحسن الجمهور قصيدة "في حديقة الجندي المجهول" التي كنتُ متردداً في قراءتها،.. وسبب ترددي إنني كنت أتخيل أنها قضية محلية محددة بواقع الحروب التي عشناها في بلادنا هناك، قد لا يفهمها السويديون الذين لم يعرفوا الحرب منذ أكثر من 200 عام..
الكثيرون لم يكونوا يعرفون أسمي، كنت أقرأ للمرة الأولى عندهم.. وكم دُهشتُ في اليوم التالي حين اطلعتُ على استفتاء لصحيفة HelsingborgsDagblad أجرته الكاتبة ياسيكا يورانسون قالت فيه:" كثيرون احبوا الشاعر العراقي لان صوره الشعرية جميلة جداً. قالت ماركيب اهلين ـ زائرة من المهرجان ـ لقد كان يتكلم بحيوية وشعره يعبر بصدق عن الرجل الذي أصبحت لحيته حديقة" (39) ..
ما أردتُ أن أقوله واستخلصه هنا أن المحلية في النص، التي قد يراها البعض أمراً محلياً عابراً أو عادياً، يمكنها التأثير أكثر بكثير من النصوص التي تحاول دغدغة العالمية وتقليدها.. كما أخلص أيضاً إلى أن الترجمة ليست عائقاً أبداً، لا أمام الشاعر ولا القاريء لوصول الفكرة أو الدهشة...
....
في أمسية شعرية في هولندا هذا العام، عام 2003 جمعتني مع الشعراء: سركون بولص، عبد الكريم كاصد، عدنان محسن، صادق الصائغ هاتف الجنابي (الذين ألتقيهم وأقرأ معهم لأول مرة. كم شاب الزمن في مفارقهم، وكم عانوا، وظلت روحهم خضراء)... أوقفتني سيدة عراقية لتريني قصاصة من نصوصي "مرايا" - التي كنتُ أنشرها وقتذاك في العراق - كانت قد حملتها معها في رحلاتها الطويلة إلى هنا، كأنها تقول لي: "أنني احتفظت بهذا النص لأنه يمثلني".. بقيتُ واقفاً مذهولاً أمامها غير مصدق ما أرى.. قلبتها بين يدي باصفرارها وكأني أقلب طفلي.. أردتُ أن أقفز إليها لأقبلها امتناناً واحتراماً وسعادة أو أقبل قصاصتها- قصاصتي في الأقل..
................
هذا القارئ الذي وصفه بودلير قائلاً: "أيها القارىء الخبيث، يا أخي، يا شبيهي". هذا القارئ الذي انشدّ إلى نصي، بقيت مخلصاً إليه،.. لم أخدعه بلغة خزعبلية وأقول له أنها الحداثة، أو بالخطب الشعائرية وأقول له أنها الوطنية والثورية... وفي ذلك كان سبب اختلافي وخصوماتي الأدبية مع بعض شعراء جيلي وغيرهم، الذين هرعوا إلى التعقيد والترميز، وراحوا يتشدقون بالحداثة والشعرية دون أن يفقهوا منها شيئاً، ودون أن يتمكنوا من أدواتهم الفنية أولاً.. وانساق قسم منهم إلى التقريرية والمباشرة، تحت أضواء الشعارات الخطابية، لتغطية شحوب مواهبهم، أو استجابة لتوصيات أحزابهم.
كيف يمكن أن تغير ذاكرتك التي تحمل أربعين عاماً من شواء الشمس والرمل والحروب والمكابدات والقهر، لتتكيّف مع هذا الصقيع الذي يلفك من جهاتك الأربع في هذه المدينة الثلجية النائية النائمة على كتف القطب الشمالي..
هذه الهواجس كانت تعيش معي قبل أن أصل مدينة لوليو في شمال أصقاع السويد هارباً من ذلك الجحيم الذي جرّ بلدي والمنطقة الى سلسلة من الكوارث، وأنا لا أصدّق أنني سأتأقلم مع هذا المناخ الثلجي الذي تصل برودته الى 32 تحت الصفر، والذي تصبح فيه حرية الفرد أعلى قيمة في الوجود كتابةً وحياةً وسلوكاً وتعبيراً ونظاماً والخ، والخ .. أنا القادم من وطنٍ يمكن لأقل كلمةٍ لا تعجب الحاكم أن تأخذك فوراً الى حبل المشنقة، وتغيبك عن الوجود في رمشة عين.
كيف يمكن إذن للكتابة أن تتكيف لهذا المناخ المفاجيء وتستوعبه: من أعلى درجات القمع، الى أعلى درجات الحرية.
من درجة حرارة تصل إلى 50 مئوية، إلى درجة برودة تصل الـ 32 تحت الصفر...
فإذا كان المنفى – أي منفى – يحمل بين طياته مناخاً جديداً لتجربة جديدة لكنها من جانب آخر تشكل امتداداً أو تغييراً طفيفاً على مستوى المناخ الذي يعيش فيه الكاتب بحيث لا يتعدى إلا بضع درجات في الحرارة أو... الحرية...
غير أن هذه التجربة المغايرة كلياً قلبت معادلتي رأساً على عقب، في الأقل، على المستويين: المكاني والزماني، وما يتفرع منهما من وصف وحداثة ومنظومة كتابية، وحرية تعبير، وأحلام وذكريات، ومخيلة.. أنني ما أن أمسك قلمي للكتابة عن غابات أشجار اليولكران العملاقة المغطاة بالثلوج مثلاً حتى تهجم علي كوابيس الحروب والأقبية وتنتزع كل جمال وروح من السطور.
ماذا يمكنني أن أفعل لهذه الذاكرة الأسفنجية المليئة بالدم والرمل والرماد.. كيف تستوعب ما حولها من ينابيع وبحيرات وهي مشبعة بأرثٍ من المستنقعات..
فالنتاج الرملي الذي أمتليء به سيصطدم لا محالة بهذه الجدران الثلجية لنص المدينة الجديد، ويتفتتان معاً على الورقة دون أن أستطيع مسك شيء..
وبين هاتين القوتين اللتين تشدانني، كنت أتساءل بهلع: هل سأبقى متأرجحاً بينهما؟ وإلى متى؟
وإذا ما ملتُ إلى طرف، فعلى أيهما سأقع؟
وخلال تلك اللحظات أو الأيام المتاُرجحة ماذا يمكنني أن أفعل أو أفكر أو أكتب؟
بمعنى آخر هل ستصبح الكتابة خلاصاً إزاء محنتي الكونية والوجودية، كما كانت خلل سنوات الحرب الماضية ملاذاً، أم ستكون هي اليوتوبيا الأبدية التي رأى فيها المفكر الفرنسي هنري ميشو عزاءً ما "إذا كان الوهم يفتقر إلى موقع فعلي فأنه يتفتح في فضاء رائع ومصقول يكشف عن مدن كبيرة وجوانب فسيحة وحدائق متقنة ويؤدي إلى بلدان بسيطة وسهلة حتى ولو كان بلوغها مستحيلاً.." وإذا كان يمكن تحقيق ذلك بفعل الكلمات وتأسيس عالمٍ آخر يقوم على أنقاض الماضي من خلال إقامة علاقات طقسية مع مفردات الحياة (النص) الجديدة، فأن ذلك الواقع سرعان ما يتلبس أصابع الكاتب وهو يمضي في مسارات لم تألفها ذاكرته من قبل لتصبح هي – أي الذاكرة – الشرط الضروري للمخيلة والإبداع كما يراها الشاعر السريالي ماكس جاكوب، أو يصح عليها وصف جوزف سكالي "لأنها مثل أبن آوى المتعطش للدم يستعيد في بحثه بين اشلاء الجيف ذكرى اللحم الطازج الحي"، حيث يجنح المبدع بالمخيلة أو يتوغل فيها إلى آفاق مفتوحة على المعرفة كنص وعلى الدهشة كحياة وعلى المتغيرات كطبيعة..
من جانب آخر يصبح التأريخ شبيه بقراءة كتاب كما يذهب إلى ذلك بورخس وهو يرى أن الكون عبارة عن مكتبة ضخمة..
فتصبح المدن إذن – استكمالاً لمخيلته وكما نراها نحن – مجموعة متنوعة من الكتب، كل كتاب تقلّبه بين يديك ستجد فيه سطوراً ضاجةً بالحياة، وأخرى بالحروب، وأخرى مبقعة بالأوبئة وأخرى يغطيها الثلج، والخ، والخ... حيث سيتلاشى الزمن رويداً رويداً ليتحول إلى فارزة أو نقطة أو حرف يمنحنا – نحن الكتاب بشكل خاص – ديمومة علاقاتنا بالوجود...
الساعة الآن تمام الثالثة ظهراً ..
بدأت الشمس الآن تميل إلى الغروب، ليلفني بعد قليل ظلام ليل طويل، أطول ليل في العالم..
أنظر إلى عقارب ساعتي ولا أدري أيهما أصدق: زمني (زمن الكتابة) أم (زمن المدينة).. لكن كرة الظلام التي أخذت تلفّ خيوطها حولي وتسحبني من أجفاني إلى الليل، لم تترك لي مجالاً للمقايسة أو التساؤل..
ها أنا أضع يدي على زر المصباح وأبدأ طقساً جديداً في الكتابة: الكتابة النهارية في الليل، أو الكتابة الليلية في النهار المتخيل - في الطرف الآخر من الكرة الأرضية -، أو الكتابة تحت أطول ليل في العالم واقعاً ومجازياً..
فأذا كان أبو علي القالي في أماليه (40) يذكر أبياتٍ في طول الليل منها:
ألا هل على الليل الطويل معينُ إذا نزحت دارٌ وحنّ حزينُ
أكابدُ هذا الليل حتى كأنما على نجمه ألا يغورُ يمينُ
أو يقرأ على أبي بكر لحنج بن حندج:
في ليلِ صولٍ (41) تناهى العرضُ والطولُ
كأنما ليله بالليلِ موصولُ
لا فارق الصبحُ كفي أن ظفرتُ به
وأن بدت غزة منه وتحجيلُ
ليلٌ تحيرّ ما ينحطُ في جهةٍ
كأنه فوق متن الأرض مشكول
فأن هذا الليل مجازيٌ وليس واقعياً، أملتهُ دواعي البلاغة العربية في المبالغة وفي وصف ليل العاشق الطويل وهو يقلب طرفيه فيه شوقاً وأرقاً وترقباً..
لكن ليل "لوليو" الذي أنا فيه، واقعي لا مجال للمبالغة فيه أملته الطبيعة الجغرافية لهذه المدينة التي تقع على رأس الكرة الأرضية فاستطال ليلها حقيقيةً عيانية وليست مجازية كالتي يذكرها الفرزدق في وصف علة طول الليل:
يقولون طال الليل والليل لم يطل ولكن من يبكي من الشوق يسهرُ
ولقد أحسن علي بن بسام في هذا المعنى منشداً:
لا اظلم الليل ولا أدعي أن نجوم الليل ليست تغورْ
ليلي كما شاءت فان لمْ تَجُدْ طال وأن جادتْ فليلي قصيرْ
والخ، والخ من وصف معاني طول الليل التي لم يتركها شاعرٌ إلا وفاض واستفاض بها واستطرد وأحدث.. وصولاً إلى قول أدونيس "ليس للشمس بيتٌ سوى ضوئها"، فأن بعدها وتزاحم الغيوم الثلجية ضلها عن بيتنا هنا فلم تعد تذهب إليه لا في النهار ولا في الليل، وهذه المفارقة يمكن أن تعطينا بعداً آخر في حداثة المعنى المغاير غير المعنى المجازي السالف الذكر، أي أنني بحاجة إلى مفردات ومخيلة غير ما ذكره أمرؤ القيس في "فيالك من ليلٍ كأن نجومه" (42) لأدلك على طول ليلي، ومن هنا، من هذا الواقع المغاير تتأسس حداثة الشاعر المعاصر في النص، ذلك أن الحداثة ليست مذهباً أو مدرسةً ثابتة المعالم والأوصاف والحدود بل هي سيرورة حياة نماشيها في حركتها وتغيراتها الدائمة كما أنها لا تتوقف على زمن معين دون سواه أو جماعة دون آخرين "فحينما يطرأ تغيير على الحياة التي نحياها فتتبدل نظرتنا إلى الأشياء يسارع الشعر إلى التعبير عن ذلك بطرائق خارجة على السلفي والمألوف، فالمضامين والأشكال تمشي جنباً إلى جنب لا في الشعر وحده بل في مختلف حقول النشاط الإنساني أيضاً" على حد قول يوسف الخال، ومن هنا تصبح لمفردة الليل مدلولات أخرى غير الطول والأرق الذي أشتكى منه العشاق والشعراء العرب وغيرهم على امتداد تأريخهم النصي بل يكون زمناً طبيعياً ممتداً للنهار على ظهر هذا القطب الذي سكنته، حياةً ونصاً ومنفىً وعلاقات وأحلاماً، وبالتالي لا اختلاف فيه إلا بدرجة ما أحمله أنا من مدلولٍ ماضويٍّ آخذٍ بالتآكل شيئاً فشيئاً..(43)
في أصقاع المنفى البارد، أفتح نافذتي وأتحسس أوراق شجر البيورك björk الذي يغطي الحديقة التي أمامي، كأنها أيامي التي تورق وتتساقط هنا، بتعاقب الفصول والأحلام والأحزان.. (الحروف العاليات هي الشؤون الذاتية الكائنة في غيب الغيبوبة كالشجرة في النواة - أبن عربي)
أتتبع العروق والأنساغ وصولاً إلى أبعد الغصون في تلك الشجرة الشاهقة بخضرتها، كأني أتتبع دورة الحبر في حياتي.. وما بينهما من تشابك وعويل، كأن العالم شجرة صور" كما يرى اندريه بريتون أو هو "إذاً، غابة من رموز" كما يذهب بودلير..
هذه الخميرة التي تصنع الورقة، وهذا النسغ الذي يغذيها كي تصنع الوردة..
هذه الخميرة التي تصنع الشاعر، وهذا النسغ الذي يرفده كي يخلق ويبدع القصيدة.. (إن لكل كاتب أصيل نبعاً واحداً يغذيه طوال حياته - البير كامو)
........
في أحد أيام الربيع، أدخل غابة الكتاب bokskogen في أحشاء الغابة السويدية الحالمة على رأس الكرة الأرضية ، أتتبع دورة الحياة (إنسان ــ تراب ــ شجرة).. (شجرة ــ عجينة في معمل ــ ورقة) للكتابة (فكرـــ إنسان).. ومن ثم (تراب ــ شجر) وهكذا دواليك..
دائراً مع نسغ الورقة وكأني أرى دورة حياة الكاتب نفسه.
"أتمشى وحيداً في غابة الكتاب
لم يكن في جيوبي
قلم ولا ورق ولا بطاقة انتساب
كأني حرف
والعصافير نقاط
والغصون سطور
والشجر المهسهس في الريح أوراقٌ
والغابة الكتاب.."
وفكرت هل يمكن أن تكون هذه الورقة التي أكتب عليها هي من أشجار هذه الغابة.
تقترب مني أحد الزواحف، أتذكر القلقشندي وهو يقول في صبح الأعشى نقلاً عن معن بن زائدة "إذا لم تكتب اليد فهي رجل".. ترى ماذا لو تحولت يداي إلى قدمين أخريين وأصبحتُ أدب على الأرض بأقدامي الأربع كأني أحد الزواحف. تباً لهذه الأفكار. أحرك يدي أرسم فيها بعض الحروف على التراب. مازالت قادرة على الكتابة. حمداً لله إنها ليست رجلاً..
أعدّل قامتي وأتمشى والطبيعة وحيدين هنا في هذا المنتآى بعيدين عن كل ما يدور خارج نطاق الغابة. فكرت أن أعقد قراني على شجرة مثلما فعل أبن عربي حين عقد قرانه ذات ليلة صافية على جميع نجوم السماء وحروف الهجاء.
غير أن الأسهم لا تتركني، كأن قدر الإنسان المعاصر أن يبقى محكوماً بأشغال الفكر الشاقة. ها أنا أمضي مع الأسهم في دورانها الآلي حول حضارات الأمم، أتتبعها. لأجد كم من السنين استهلكها الفكر ليصل الينا عبر رحلته الطويلة من الحجر إلى الورقة.. غير أن الورقة أخذت تتحول إلى رقائق الكترونية Hardisk
وتعال أيضاً: (حجر ــ ورق ــ ألكترون ــ ثم.............
لكن القوس يبقى مفتوحاً.
ألتقط غصن شجرة يابس وأرميه في البركة الصغيرة لقصر Torup لترسم دوائر مائية سرعان ما تتلاشى، ولا أثر
كأن كل ما لا يُكتب لا يكون له أثر
أتأمل أفكاري معكوسة على صفحة البحيرة الساكنة، ترى كم من الأمم والشعوب والفنون والآداب والمثقفين مروا على سطح بحيرة الحياة ولم يتركوا غير دوائر مائية زائلة.
كم من الكتاب اندثروا دون أن نسمع بهم، ربما لأنهم لم يتركوا لنا أثراً أو سطراً في كتاب.. وليتهم بدلاً من أن يظلوا منفوشين بغصونهم اليابسة أخذوا نصيحة لوركا على محمل الجد وهو يقول: "أيها الحطاب أقطع ظلي، أنقذني من عذاب أني بلا ثمر".
أنهم في يباسهم الدائم سيبقون أبداً - رغم تعالي أصوات هسيسهم في الريح - مجرد أحطاب . وكما وصفهم غليفيك: "يتركون لنا قصائد كثيرة ولم يجدوا الشعر بعد". إذ ليس كل من يكتب أو يترك شيئاً يبقى، وليس كل نقش خالد.
فقد تسهم عوامل الطبيعة والتعرية نفسها وتقلبات الحياة والحضارات والأذواق والمدارس الفنية أحياناً في ضياع الكثير من الآثار، غير أن لسلطة الابداع أثرها على الزمن والطبيعة والحياة والإنسان حين تنتقل من الحجر أو الورقة إلى الروح والفكر والأنفاس، وهذا ما يحفظ للمبدع بقاءه إلى الأبد سواء تغيرت الحضارات من الحجر إلى الألكترون أو من الألكترون إلى الحجر أو دارت الطبيعة دوراتها المتعاقبة.
وأذ أتذكر مقولة سارتر بأن الأبداع مشروط بالحرية، وخيبة أدونيس من أن الكتاب العربي يقرأ خارج لغته، أسرح بنظري بعيداً في الغابة فلا أرى سياجاً أو حارسا أو شرطياً أو قطعة تشير إلى "ممنوع" أو أخرى تشير إلى "حقل ألغام" كما في بلادنا.
غابة طليقة
في فضاء طليق
تستطيع أن تفعل فيها ما شئت..
كأن الشجر يتشرب الحرية أيضاً من الأرض ويحملها في أنساغه إلى الورقة! (44)..
الورقة التي هي أمامي
وأمامكم الآن..!!
....
.................
20-9- 2003 مالمو/ السويد
بعض الهوامش:
(1) من قصيدة "مرايا متعاكسة" - ديوان"تكوينات" المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت 1996 (2) (هناك دراسة أعدها أحد المعاهد السويدية تقول أن الإنسان الذي يعيش سنة حرب، يحتاج إلى عشر سنوات من النقاهة)!!.. فكم سنة نحتاج للنقاهة بعد هذه الحروب التي ابتلعت ثلاثة أرباع أعمارنا؟ (3) سلسة مقالات ونصوص شعرية كنت أكتبها تحت عنوان "مرايا" في عمود أسبوعي في جريدة "القادسية" (26/4/1988 – 18/7/1989 ) جمعتها فيما بعد في كتاب سميته "مرايا لشعرها الطويل" قدمه الشاعر عبد الوهاب البياتي وصدر عن دار الشؤون الثقافية – بغداد 1992. (4) المجاميع الشعرية التي صدرت لي في العراق هي: انتظريني تحت نصب الحرية - 1984/ أغنيات على جسر الكوفة - 1986/ العصافير لا تحب الرصاص - 1986/ سماء في خوذة - 1988/ مرايا لشعرها الطويل - 1992/ غيمة الصمغ- 1993 (5) من قصيدة بعنوان "نص" – من ديواني "تأبط منفى" - دار المنفى - السويد 2001 (6) ديوان السياب ج1- دار العودة (7) من قصيدة "في المقهى" مؤرخة بتاريخ 7/2/1984 بغداد – ديوان "أغنيات على جسر الكوفة" - بغداد 1986 (8) روي عن ضرار بن ضمرة الكناني في وصف علي بن أبي طالب: "إني رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، واقفاً في المحراب، قابضاً على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين ويقول:.. أه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق" (9) علي الرماحي: صديق الصبا والشعر، وشاعر عذب، اشتهرت بقصائده المحرضة في نهاية السبعينات، أعدمه النظام العراقي عام 1979 (10) حميد الزيدي: كاتب ومناضل أعدمه النظام منتصف الثمانينات (11) ضرغام هاشم: صحفي أعدمه النظام بداية التسعينات لكتابة رد على مقال في جريدة الثورة قيل أنه لصدام حسين (12) عبد الصاحب البرقعاوي: شاعر مرهف ومجدد، مات مهموماً ومعدماً منتصف التسعينات (13) محمد عباس الدراجي: شاعر وكاتب مات في حادثة سير غامضة قبل سقوط النظام بأشهر (14) عزيز السيد جاسم: مفكر معروف أعدم بداية التسعينات (15) محمد حسن الطريحي: شاعر شاب أعدم بداية الثمانينات (16) حاكم محمد حسين: قاص أعدم لهروبه من الجيش أثناء الحرب العراقية الايرانية (17) حسن مطلك: روائي صاحب رواية "دابادا" أعدم نهاية الثمانينات.. (18) ["ارتبكتُ أمام الرصاصةِ / كنّا معاً في العراءِ المسجّى على وجههِ / خائفين من الموتِ / جمّعتُ عمري في جعبتي,.. / ثم قسّمتهُ: بين طفلي.. / ومكتبتي.. / والخنادق / (للطفولة، يتمي.. / ولامرأتي، الشعرُ والفقرُ.. / للحربِ, هذا النـزيفُ الطويلُ… / وللذكرياتِ.. الرمادْ) / وماذا تبقى لكَ الآن من عمرٍ / كنتَ تحملهُ - قلقاً - وتهرولُ بين الملاجيءِ والأمنياتِ / تخافُ عليه شظايا الزمانِ / قالَ العريفُ: هو الموتُ لا يقبلُ الطرحَ والجمعَ / فاخترْ لرأسكَ ثقباً بحجمِ أمانيكَ / هذا زمانُ الثقوبْ…/ أو… / فأهربِ الآنَ.. / من موتكَ المستحيلْ / (- لا مهربٌ… / هي الأرضُ أضيقُ مما تصورتُ / … أضيقُ من كفِّ كهلٍ بخيلٍ… / فمَنْ ذا يدلُّ اليتيمَ على موضعٍ آمنٍ / وقد أظلمَ الأفقُ.. / وأسّودَ وجهُ الصباحْ" ] مقطع من قصيدة "سماء في خوذة" من ديوان "سماء في خوذة" ط1 - دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد 1988/ ط2 مكتبة الأسرة - القاهرة 1996 (19) ["أنتِ لا تفهمين إذنْ / رجلٌ في كتابْ / سوف يعبرُ مبنى الجريدةِ، شَعرُكِ هذا الصباح / فيشغلني عن دوارِ القصيدةْ / أتأملُ فوضاكِ من فتحةٍ في القميصِ / وفوضاي في الورقةْ / سيمرُّ بي العطرُ / يأخذني لتفاصيلِ جسمكِ / أو لتفاصيلِ حزني / مَنْ سيرتّبُ هذا الصباحَ القَلِقْ!؟ / الفناجينُ باردةٌ كالصداقاتِ / والحربُ تعلكُ أيامنا / وأنا في انتظارِ الندمْ / اقلبي الصفحةَ الآنَ / برجُكِ تشغلهُ الوفياتُ / وبرجيَ تملؤهُ الطائراتُ"] مقطع من قصيدة "بريد القنابل" من السابق (20) ["أنا خارجٌ من زمانِ الخياناتِ / نحوَ البكاءِ النبيلِ على {وطنٍ} أخضرٍ / حرثتهُ الخنازيرُ والسرفاتُ / أنا داخلٌ في مدارِ القصيدةِ / نصفَ طليقٍ / ونصفَ مصفّدْ / فهذا الزمانُ يعلّمنا / أن نصفّقَ للقاتلين / حينما يعبرون الرصيفَ إلى دمنا / وهذا الزمانُ يعلّمنا / أن نقصّرَ قاماتنا / .... كي تمرَّ الرياحُ على رسلها / أن نماشي القطيعَ إلى الكلأ الموسميِّ / ولكنني.......... / من خلال الحطامِ الذي خلّفتهُ المدافعُ / أرفعُ كفي معفّرةً بالترابِ المدمّى..... / أمامَ عيونِ الزمانِ / أعلّمهُ كيفَ نحفرُ أسماءَنا بالأظافرِ / كي تتوهجَ: لا"....... "على شفتي شجرٌ ذابلٌ، والفراتُ الذي مرَّ لمْ يروني. ورائي نباحُ الحروبِ العقيمةِ يطلقها الجنرالُ على لحمنا، فنراوغُ أسنانها والشظايا التي مشّطتْ شَعْرَ أطفالنا قبلَ أنْ يذهبوا للمدارسِ والوردِ. أركضُ، أركضُ، في غابةِ الموتِ، أجمعُ أحطابَ مَنْ رحلوا في خريفِ المعاركِ، مرتقباً مثل نجمٍ حزينٍ، وقد خلّفوني وحيداً هنا، لاقماً طرفَ دشداشتي وأراوغُ موتي بين القنابلِ والشهداءِ"] مقاطع من قصيدة "خرجتُ من الحرب سهواً" من ديوان "غيمة الصمغ" ط1 – بغداد 1993 ط2 - اتحاد الكتاب والأدباء العرب – دمشق 1994 (21-22) مقاطع من مسرحية "الذي ظل في هذيانه يقضاً" التي أعدها الفنان احسان التلال عن قصيدتي" هذيانات داخل جمجمة زرقاء لا علاقة لعدنان الصائغ بها"- "نشيد أوروك"، وأخرجها الفنان غانم حميد على مسرح الرشيد في بغداد 1993 (23) قصيدة "هواجس" - ديوان "تأبط منفى" - دار المنفى - السويد 2001 (24) ديوان المتنبي (25) من أوراق ملتقى عمان للكتاب 1998 (26) قصيدة "عقدة" - ديوان "تأبط منفى" - دار المنفى - السويد 2001 (27) هذا المصطلح أطلقه الناقد د. حاتم الصكر في دراسة له في مجلة "أسفار" ع 13 في 1992 (28) قصيدة "العراق" من ديوان "تأبط منفى" - دار المنفى - السويد 2001 (29) الشاعر اليوناني قسطنطين كافافي (30) الشاعر العباسي دعبل بن علي الخزاعي (31) حسين حيدر الفحام: صديق صبا، رسام (32) علي عبد الحسين: كاتب وصحفي (33) كاظم الخطيب: شاعر وكاتب وفنان مسرحي، مات مبكراً (34) مضر علوة: من شهداء الانتفاضة 1991 (35) عبد الحي النفاخ: صديق كاتب أصيب بالجنون في السجن (36) من دراسة بعنوان "البرق والغابة - قراءة في المشهد الشعري الجديد - الثمانينات والتسعينات – النجف نموذجاً" قدمتها قي الندوة العلمية التي أقامها مركز كربلاء في لندن، تحت عنوان (النجف الأشرف وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية) للفترة 17-18تموز(يوليو) 1999 وصدرت مع بحوث المشاركين في مجلدين عن منشورات Book Extra في بريطانيا عام 2000" (37) قصيدة "في حديقة الجندي المجهول" من ديوان "سماء في خوذة ط1- بغداد 1988 ط2 القاهرة 1996 (38) ديوان "نشيد أوروك" دار أمواج - بيروت 1996 (39) الصحيفة السويدية HelsingborgsDagblad في11/9/1997 (40) الأمالي لأبي علي القالي (41) صول: أسم مدينة (42) ديوان أمريء القيس (43) نشرت في صحيفة "القبس" الكويتية 22/11/1996/ من كتاب "في حديقة النص - مدارات التجربة الشعرية" تحت الطبع (44) نشرت في صحيفة "القبس" الكويتية 13/4/1999/ الكتاب السابق.