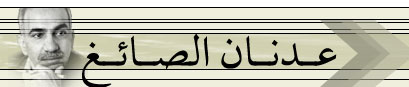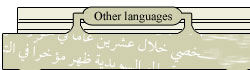|
ملامج من المشهد الشعري في العراق
د. علي جعفر العلاق
أيّهما يؤدي الى الآخر، ويغدو عنصراً من عناصر حيويته: الشعر أم الحياة؟ ان سؤالاً كهذا لا يبدو عديم الجدوى ونحن نتحدث عن الشعر العربي في القرن التاسع عشر. وقد تبدو وجاهة هذا السؤال أشد حين يتعلق الأمر بالشعر العراقي أواخر ذلك القرن الفاتر. لا شك أن الصلة بين الحياة والقصيدة صلة أخذ وعطاء؛ فالقصيدة باعتبارها تجربة لغوية خاصة لا تنهض باتقان وحيوية، دون أن تستند الى حياة مسكونة بما يجعل كتابة الشعر ممكنة: أعني تلك الحيوية الفائزة. ان الحياة الخصبة، كما يرى روزنتال، احدى مكونات الشعر: «ان خصب الحياة والطريقة التي نشعر بها والتي نتكلم بها جميعاً حين لا نكون واعين متعمدين، هذه الأمور هي مادة الشعر بالذات. والحياة، من جهة أخرى، لا تظل في منأى عن هزة الشعر وتأثيره السحري عليها؛ فللشعر لمسة مغيرة، تستدرج الواقعة الحياتية اليها بحنو قاسٍ، لتوقعها في شبكة القصيدة وما يعتمل في ثناياها من قوى الخلق. بعد ذلك لا تعود هذه الواقعة خارجية، بل تغدو حدثاً، يتعالى على الواقع، وينفلت من اساره، ليكون أعمق دلالة منه. وبذلك يضفي القول الشعري على الحياة لمسة من العمق لم تكن لها من قبل، ويكسبها رحابة وليونة آسرتين. وحين تخلو حياة ما من الشعر فانها تصبح أقل جدارة بأن تعاش. القرن التاسع عشر كان القرن التاسع عشر، في جزئه العراقي، مغايراً الى حد كبير للفترة التي عاشتها مصر مثلاً من الحقبة ذاتها. لم يكن هذا القرن ممتلئاً أو مثيراً، بل كان خاملاً يفتقر الى الأحداث الكبيرة والأسماء البارزة في الشعر أو الفكر أو السياسة. والمثير للانتباه حقاً، أن المقارنة بين واقع الشعر المصري والعراقي، في هذا القرن، تكشف عن مفارقة مريعة؛ ففي الوقت الذي كان فيه الشعر المصري ينهض من ليله الطويل على يد البارودي كان الشعر العراقي يشهد واقعاً موغلاً في عتمته وتخلفه لغة وايقاعاً وموضوعات. لقد كان هناك ارتباط عميق بين فتور هذا الشعر وبين الانحطاط الفكري والروحي الذي يعاني منه المجتمع العراقي كله آنذاك. وفي ظل واقع خامل كهذا لا يعود الشعر، الا «لوناً من ألوان الاحتراف والصنعة «4» ولا تعود القصيدة غير مهارة عروضية والمام باللغة وتصريفها لا غير. ولم يصل الوضع الشعري الى هذه الدرجة من التدني الا بعد فتور الشعور القومي واختفاء البواعث الدافعة الى الخلق والابتكار والتحليق، وليس مستغرباً تلك الاندفاعة الشعرية للبارودي لأنها لم تكن معزولة عن ذلك النهوض العام في الحياة المصرية ونبضها الجديد آنذاك. ان هذا الشاعر الاحيائي كان ابن الثورة العرابية وأحد المؤجّجين لسعيرها المدوي. لقد ظهر محمود سامي البارودي: «ليؤثر في الثورة بشخصيته وتكوينه وأحداث حياته وليتأثر بها، وليبعث -أيضاً- الشعر العربي ويرد اليه ماءه وراء الحياة التي أنضبتها عصور العجمة والركاكة وفساد الذوق» لم يشهد الشعر العراقي، في هذا القرن، أحداثاً كبيرة كالتي شهدتها مصر في الفترة ذاتها. لقد كان يكتب على هامش حياة بطيئة خاملة، وكان في معظمه، نصوصاً تقليدية تخلو من هموم الناس وملامح حياتهم الضيقة، وتنحاز، لا الى الناس، بل الى الحكام والولاة والوجهاء. وعلى المستوى النفسي، لابد للباحث في شعر هذه الحقبة أن يلتفت الى حاجة القصيدة الى الذات المزدهرة التي يغذيها اعتداد بالنفس أو نرجسية محببة أحياناً. كان الشاعر العراقي، آنذاك، ينحني أمام الوالي العثماني أو الموظف أو الوجيه. لقد مسح شعراء تلك الفترة، كما يقول د. علي عباس علوان «ما بقي من كرامة للشاعر العربي، بقصائدهم التي كانت تعج بمظاهر الاستجداء والتبذل. لم تكن هناك من كرامة داخلية تضيء النص، أو نزوغ عميق الى الجمال والحقيقة يحكم موقف الشاعر ويعزز رؤيته الى الحياة والبشر. كيف يمكن للشاعر حين ينهشه الضعف وتذله الحاجة والاحساس بالضعة أن يرقى بقصيدته الى ذرى من القوة والجمال؟ كيف يتاح له أن يجعل من نتاجه الشعري عرى لامعة تشده الى حياة أكثر رقياً؟ واذا كان البارودي «اعادة متقنة للماضي فان الشعر العراقي في القرن التاسع عشر لم يكن كذلك. لم يكن اقتراباً من الشعر القديم، أو صياغة جديدة لتموجاته التعبيرية أو الوجدانية، بل كان أغلبه اضطراباً بين » التقليد والضحالة. لقد شهد القرن التاسع عشر -وهو يشرف على نهايته- بعض الشعراء الذين شكلوا، الى هذا الحد أو ذاك، ايذاناً بقدوم جديد، ان قصائد عبد الغني جميل، مثلاً، مهدت الطريق لأصوات مختلفة: ارتفعت مع آخر خيوط ليل القرن التاسع عشر، فأعادت ردم الهوة السحيقة ما بين الفن والحياة، وأنهت عصر الزركشة والألاعيب، ووضعت حداً لضيق أفق الشاعر وعقم فنه الصناعي. النصف الأول من القرن العشرين على الرغم من أن النصف الأول من القرن العشرين قد شهد مجموعة من الأسماء الشعرية المعروفة الا أن أحداً منها لم يستطع، عدا الجواهري، أن يحقق الدويّ ذاته الذي حققه جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي. لقد كان هذان الشاعران تجلياً صارخاً لضغط الحياة على الشاعر واستجابته لها استجابة حارة عاجلة. لقد وجد الزهاوي والرصافي نفسيهما في مفتتح قرن جديد هجم على الشاعر العراقي دفعة واحدة كانت الأحداث -التي لم يشهد لها القرن الماضي مثيلاً- تهز المجتمع العراقي آنذاك، وتقتحم نصوص شعرائه وتعرضها، ربما للمرة الأولى، لريح عاتية: الانقلاب العثماني، اعلان الدستور، الحرب العالمية الأولى، ثورة العشرين، اقامة الحكم الوطني عام 1921. وبعد سنوات طويلة من قطيعته مع الحياة وانشغاله بضواحيها المهملة التفت الشعر العراقي، بعنف، الى الواقع: يتحرى تفاصيله ويقتفي ظواهره. غير أنه، في كل ذلك، كان يعلي من شأن الموضوعات والاهتمامات الفكرية والسياسية والاجتماعية. لم يكن شعر النصف الأول من القرن، في غالبيته، الا معالجات لا تقترض من الشعر الا مظاهره الخارجية التي لا تتصل، اتصالاً عميقاً، بجوهر الابداع الشعري. لذلك، كان شعر الزهاوي والرصافي والكثير من مجايليهما أفكاراً وموضوعات وهموماً تتصل بالناس: تنبثق منهم وتتجه اليهم. وكان الناس يقرأون شعرهما لا لما فيه من جمال الصياغة أو اللغة، بل لوجاهة تلك الأفكار وانحيازها الى الناس في كدحهم اليومي وحلمهم بحياة أفضل. انه شعر المحتوى النبيل، لا شعر الصياغة البهية. ان الزهاوي والرصافي لا ينظران الى الشعر باعتباره فناً أو طريقة خاصة في القول، بل مهمة ووظيفة لخدمة الناس وتوعيتهم، وهو كما يرى الرصافي، الهدي والنصيحة والمعالجة. لقد استعاض الزهاوي والرصافي عن شعرية القصيدة بأفكارها، واستبدلا جمالية النص بموضوعه وبذلك كانا، داعيين للاصلاح، وناشرين للأفكار الخيرة أكثر منهما شاعرين يفتحان باتجاه المتلقي طريقاً جديداً في التعبير. ولهذا كله افتقرت قصائدهما، وشعر هذه الفترة عامة، الى حيوية الشكل وقوة الروح. كانت السلطة الحاكمة وارتباطها بالأجنبي موضع هجاء دائم بالنسبة للشاعرين «17». ولم يكن هذا الهجاء ينبثق من جهد شعري مكتمل ومركب، بل يسلك طريقاً مباشراً ليس فيه شيء من بلل الشعر أو صفائه. اضافة الى ذلك، كرس الشاعران الكثير من قصائدهما للموضوعات الاجتماعية. وبالرغم من أن الشعراء المجايلين لهما قد اهتموا، أيضاً، بهذه الموضوعات الا أنهم لم يحققوا ما حققه الزهاوي والرصافي من انغمار في الشأن الاجتماعي. لقد كان الاهتمام بالقضايا العامة هاجس الكثير من شعراء القصيدة العمودية في العراق على اختلاف مراحلها، وتباين شعرائها مثل عبد المحسن الكاظمي، ومحمد رضا الشبيبي، ومحمد مهدي البصير، وعلي الشرقي، ومحمد بهجت الأثري، ومحمد علي اليعقوبي، وصالح الجعفري، وعبد الرزاق محيي الدين، خالد الشواف، محمد صالح بحر العلوم، باقر سماكة، وعلي خليل الوردي، ومصطفى جمال الدين. ومع ذلك يظل الرصافي وأكثر الشعراء العراقيين انغماراً في الشأن العام، وأشدهم جرأة ربما. لقد كانت قضايا المرأة من أخطر الموضوعات الاجتماعية التي عالجاها بشجاعة مشهودة. ان دفاعهما عن حق المرأة في التعلم، والعمل، والمشاركة في الحياة العامة من الأمور التي شغلت حيزاً كبيراً في شعرهما. لقد هاجما، بضراوة، الكثير من العادات التي تحط من كرامة المرأة وأنوثتها مثل: تعدد الزوجات، والزواج غير المتكافئ. كان شعر الزهاوي والرصافي، سجلاً لتجليات الواقع العراقي، وتقلباته ومظاهر البؤس فيه، وقد كان تصويرهما لهذه المظاهر نثرياً ومباشراً. ولذلك جعلا من قصائدهما فضاءات تتسع لكل شيء: السياسة، الأدب، المرأة، المخترعات العلمية. وكان الموضوع لديهما يتراءى لنا من خلال القصيدة مباشراً وصارخاً. أي أنهما لم يسعيا، في معظم شعرهما، الى اضفاء أية غلالة من تقنية أسلوبية أو ثراء لغوي على ما يعالجانه من موضوعات وأفكار شائعة. ولم يشهد شعر هذه الفترة، تقريباً، جهوداً جمالية أو شكلية للارتفاع بالقصيدة الى مستوى من الأداء المؤثر، لكن ما يحسب لشعراء هذه الفترة اقترابهم من لغة الحياة، وابتعادهم عن التكلف في الصياغة. وكان ذلك طبيعياً نظراً الى أن معظم الشعراء، في هذه الفترة، كانوا ميالين الى الاعلاء من شأن المعنى، والموضوعات والأفكار مما صرفهم، الى حد كبير، عن العناية بالأداء الشعري أو الاهتمام بالاجتهادات الشكلية. ان استجابة الزهاوي والرصافي لضغوط الواقع وتحولاته كانت تفتقر، رغم صدقها، الى ممارسة شعرية ترقى، ابداعياً، الى مستوى تلك التحولات وتجسدها تجسيداً فنياً عالياً. واذا كان الرصافي يمثل، كما يقول أدونيس تلفيقية تجمع بين الافتنان «بالنموذج التعبيري المادي»، وبالواقع المتغير في آن«فان الزهاوي يقع، وبدرجة أكثر ربما، ضمن هذا المأزق». محمّد مهدي الجواهري واذا كان الزهاوي والرصافي قد انعطفا بشعرهما صوب الحياة بكل ضجيجها الكالح، دون أن يضيفا على موضوعاتهما ماء الشعر، أو يصعدا بلغتهما الى ذرى من التوتر فان الجواهري استطاع، الى حد كبير، أن يردم هذه الفجوة، ويجسد بموهبته الشعرية الكبيرة، مستوى مختلفاً من التلاحم بين الواقع العراقي المتفجر، سياسياً واجتماعياً وفكرياً، وبين الشعر. أكثر ما يشد المتلقي الى شعر الجواهري تلك الذات العنيفة المتأججة. ان «أنا» الجواهري تتفجر، عبر قصائده، جياشة متعالية دون أن تسقط في نرجسية مقيتة تعزل الشاعر عن الناس وتمنعه من الانغمار في حياتهم الهادرة بالألم والترقب. ان ما يميز الجواهري عن الزهاوي والرصافي مثلاً، هو تهديمه للمسافة الفاصلة بينه وبين موضوعاته؛ فأنت لا تحس، خلال قراءتك لشعر الجواهري أن الموضوع الذي يعالجه يقع خارج ذاته. في معظم قصائده يفقد الموضوع الخارجي خارجيته، ولا يعود موضوعياً، أو مستدرجاً من مرجعية ما تقع خارج الذات، لأنه ليس بعيداً عن نفس الجواهري وضميره المتقد. ان الموضوع، لديه، يغدو ذاتياً حين يلتبس بغضب الشاعر وتوتره. ورغم ارتباطه، ارتباطاً عميقاً بالواقع العراقي والعربي، لم يكن الجواهري مسجلاً للأحداث أو مصلحاً اجتماعياً كالزهاوي والرصافي مثلاً، ولم يكن مثل محمد صالح بحر العلوم شاعراً لا يمتلك، أحياناً، غير صلابته وصدقه. بل كان نمطاً آخر من الشعر، ذا نبرة مدوية جارحة، لا يستعين على الموضوع الشعري بوجاهته ونبله، بل بجهد الصياغة المتقنة، وما تتركه اللغة الثرية الشائكة من تأثير في وجدان المتلقي يهيمن على هذا المقطع عنف لغوي ونفسي كاسح؛ فالشاعر يواجهنا بتدفق من الجمل العنيفة. والمقطع كله تخيم عليه طبقة من التجهم والظلمة والخراب. وقد أسهم في خلق هذا الجو الحاح الشاعر على الجمل الفعلية التي شكلت بدايات الأدبيات جميعها تقريباً. ولابد من الاشارة، هنا، الى أن تكرار الفعل «أطبق» اثنتي عشرة مرة أشاع جواً شديد التوتر في هذا المقطع المكون من سبعة أبيات فقط. يضاف الى ذلك أربعة أفعال أخرى، في الأبيات الثلاثة الأخيرة، «يُجبْ، شكا، يعرفوا، انحنت» وبذلك يرتفع عدد الأفعال الى خمسة عشر فعلاً. كما لعبت صيغة الحال التي استخدمها الشاعر دوراً مهماً في بناء هذا المقطع وتنمية توتره وكذلك الأمر بالنسبة لصيغ التضاد والتعارض المتمثلة ب«حماة دمارهم» و«بناة قبورهم» والتعارض الكامن بين لون السماء والرقاب المنحنية. وربما كان الجواهري أكثر مجايليه من الشعراء اتكاء على التراث واستدراجاً لمكنونه الفكري والحسي. ان الكثير من شعره يستند الى دفء داخلي يشيعه الايماء الى التراث القديم شعراً كان هذا التراث أم مرويات أم أحداثا أم حكمة، أم نصوصا دينية، لقد كان الالتفات الى التراث خطوة، وان كان مداها محدوداً، لاحكام صلة القصيدة المعاصرة بما يضمره الماضي من حيوية قادرة على الاستمرار. يمكن القول ان الجواهري، شاعراً وانساناً، يشكل حلقة متينة وضرورية تربط بين الشعر وتصدعات الواقع، وبين جلال الماضي ودموية هذا العصر. ان صوت الجواهري ممتلئ «بدوي التجربة والتاريخ، في آن واحد. وكان اصغاء هذا الشاعر الى تحولات الواقع بداية مهمة سيتم استثمارها على أيدي الشعراء الرواد وشعراء الستينيات الى مدياتها القصوى. وعياً وممارسة. وبرحيله عام 1997 يكون هذا الشاعر الفذ قد أغلق وراءه قرناً من الانجازات الشعرية المدوية. شعراء القصيدة الكلاسيكية ومن الانصاف القول ان المشهد الشعري العراقي لا يتشكل كلّه من شعراء التفعيلة وحدهم، أو شعراء قصيدة النثر فقط؛ فللقصيدة الكلاسيكية انجازاتها أيضاً. لقد أسهمت، وتسهم باستمرار، في التعبير عن فورة الحياة وتصدعاتها في المجتمع العراقي. ورافقت، وما تزال، أكثر تحولات هذا المجتمع شراسة وارباكاً. من جهة أخرى، فان المتتبع لانجازات شعراء القصيدة الكلاسيكية يجد، وباستثناءات قليلة أن نبرة الاحتفاء بالحياة، على وعورتها، أعلى من نبرة الاحتجاج عليها، أو القلق منها. ويتجلى ذلك في معظم ما يكتبه شعراء القصيدة العمودية مثل عبد الرزاق عبد الواحد، محمد حسين آل ياسين، نعمان ماهر الكنعاني، علي الياسري، لؤي حقي، رعد بندر، محمد جميل شلش. التأثيرات الرومانسية والغنائية لعب الشعراء والنقاد في مدرسة الديوان وجماعة أبولو، وشعراء المهجر أيضاً دوراً أساسياً في الاعلاء من شأن الوجدان والنزعة الذاتية في الشعر. واستطاعوا، الى حد كبير، زحزحة الكثير من الثوابت، الجمالية والفكرية، التي استندت اليها القصيدة الكلاسيكية. لم يعد الشعر مجرد وصف لحدث خارجي، ولم تعد القصيدة مجموعة من الأبيات التي تتراكم تراكماً، تعاقبياً، بل هي ارتباط نسيج العمل الشعري وتلاحمه. وكان شعر جبران خليل جبران، وخليل مطران، وعلي محمود طه، وابراهيم ناجي، وأبو القاسم الشابي، ونديم محمد، نسمة جديدة تخللت أدغال القصيدة العربية، لتلطف من خشونتها، وتنزل بلغتها الى ماء الحياة. ولذلك لم يعد الشاعر مراقباً لمشهد يصفه من الخارج، بل محوراً لحركة الأشياء. وهكذا صار لبعض القصائد العربية نصيبها من رفيف الذات ونزعة الغناء المجرح. وسرت، في النص الشعري، همهمة الروح الشاعرة، وسرت في مفاصل اللغة مياه جديدة. لقد شكل الانحياز الى الذات الفردية أفقاً من الطراوة الجديدة تحركت فيه القصيدة وهي تنضح بالحنين والقلق الخلاق، وبفعل هذا الحديث المكثف عن النفس صارت «الأنا» محوراً قائماً لدى شعراء الرومانسية العرب لم تجد تلك الرعشة الرومانسية، التي شاعت في الشعر العربي آنذاك، فضاء مماثلا في الشعر العراقي. لقد كان الواقع السياسي والثقافي والاجتماعي في العراق شديد الوعورة والتمزق. وكان الشاعر، في جل ما يكتب من شعر، يصغي الى الحياة العامة اصغاء خاصاً، ويفسح للهم السياسي والاجتماعي حيزاً كبيراً في قصيدته. كانت التأثيرات الرومانسية العربية تتشظى على صخرة الواقع العراقي؛ فالهاجس الوطني الذي جسدته الحركات السياسية، والانقلابات العسكرية، والأحزاب الوطنية، وآثار الحرب الكونية الأولى، وسيطرة بريطانيا على العراق، وأخيراً ما خلفته الحرب الكونية الثانية من آثار مروعة وضياع فلسطين. ان كل هذه العوامل أسهمت الى حد كبير في قمع الهاجس الرومانسي وتفتيت جذوته الفردية. يضاف الى ذلك كله سطوة القصيدة الكلاسيكية وميراثها العميق في الوجدان العراقي. وهكذا ضاع ذلك الدفء الذاتي الهامس وسط تفجرات الواقع التي جعلت الشاعر العراقي، في الغالب، جزءاً من صوت عام لا مجال فيه للتمايزات الفردية والأنين الذاتي الخافت. وقد كان نصيب الشاعر العراقي، آنذاك، من معرفة اللغات الأجنبية قليلاً، مما أدى الى أن تكون صلته بالرومانسية الغربية صلة بالواسطة. كان الشاعر العراقي «مقلداً للشعراء العرب في مصر والمهاجر أكثر من تقليده للشعراء الأوروبيين الرومانسيين». ان هذه الأسباب كلها لم تفسح المجال لتيار رومانسي مزدهر في القصيدة العراقية، لكنها لم تمنع ظهور أصوات اتسمت بالغنائية المترعة بالألم البهي دون أن تنغمر في رداء الرومانسية تماماً، أو تتجرع الكأس الرومانسية حتى آخرها بما فيها من يأس، وعزلة، وتمجيد لعذاب الذات. بدأت هذه الأصوات تغني على مقربة من نهر الرومانسية دون أن تغرق فيه. وكان شعراء هذه النبرة يكرسون معظم شعرهم للهم الخاص، والانشغال الذاتي الملتهب. لقد أخذ هذا النسغ الذاتي يتسلل الى القصيدة العراقية بدءاً من علي الشرقي الذي يعتبره بعض النقاد أول من حاول من هؤلاء الشعراء «زحزحة الموقف الكلاسيكي ومفارقته مروراً بأكرم الوتري، وحافظ جميل، وعاتكة وهبي الخزرجي، وهلال ناجي، وعبد الرزاق محي الدين، وعبد القادر رشيد الناصري، وحسين مردان وعبد الأمير الحصيري وعبد الرزاق فريد». ويختلف هؤلاء الشعراء في الهاجس الشخصي الذي يمثله كل واحد منهم، ويسعى الى تجسيده، لغة ومزاجاً قد نجد نقطة مشتركة تلتقي عندها قصائدهم، وتتماسك انشغالاتهم غير أنهم، بشكل عام، يتحفظون بحدود واضحة تميز تجربة كل منهم. ربما كان الشرقي والناصري أقرب هؤلاء الى الرومانسية، مع أن أياً منهما لم يكن شاعراً ذا رؤية رومانسية خالصة. لقد كان شعرهما متفاوتاً الى حد كبير ولم يصطبغ بنبرة رومانسية مهيمنة. كان الشرقي يشكل فسحة بين نهاية أفق وبداية أفق آخر؛ الكلاسيكية والرومانسية. وتمثل قصائده التي ما تزال تحفل ببقايا كلاسيكية غاربة انحيازاً للذات وأنينها الفردي. ولم يكن شعر الناصري تمثلاً متجانساً للرومانسية كما أن معظم شعره لا يعدو كونه تقليداً للأصوات الكبيرة في الشعر الرومانسي العربي مثل الياس أبي شبكة، علي محمود طه، ابراهيم ناجي «38» وقد كانت ثقافته المحدودة وحياته المرتبكة من أسباب ذلك التدني في وعيه الشعري ونماذجه الشعرية. أما عبد الأمير الحصيري فقد كان يمثل -شاعراً وانساناً- تجربة فريدة في الشعر العراقي، لقد كان قصيدته ذات البناء الكلاسيكي تكاد تتمزق تحت طوفان حياته البوهيمية المشردة، كما أن الكثير من شعره كان يفصح عن شاعرية تحتال على ضيق الشكل القديم برحابة الأسى وبراعة الصنعة. شعراء جيل الستينيات يشكل جيل الستينيات أكثر الموجات الشعرية اثارة وعمقاً في الشعر العراقي الحديث. ولم يكن بزوغ هذا الجيل طارئاً، بل كان حاجة فكرية وابداعية كبرى كان المجتمع العراقي يضج بها على المستويات كافة. ان شعراء هذا الجيل لم يكونوا مدفوعين بهاجس عروضي، أو هموم شكلية عابرة، بل كانوا يجسدون رؤية جديدة للشعر والحياة، للعصر وللتراث. لقد انبثق هذا الجيل الشعري وسط ركام محزن من الخيبات السياسية والانكسارات العامة، وطنياً وقومياً: خيبة الشاعر الستيني في حمله السياسي، هزيمة 67، الاهتزازات الكبرى في العالم فكرياً وسياسياً. كان ظهور جيل الستينيات زلزالاً واضحاً وسط تحولات عميقة في الوعي، وبناء الروح، وهاجس التمرد على أغلال ظلت موضع تقديس قروناً طويلة. لقد كان ابناً حميماً للتحولات والانكسارات الواسعة: الثورة الطلابية في فرنسا 68، تمردات اليسار العالمي، انهيار السطوة الستالينية. فكر سبينورا، وجيفارا، وطارق علي، وفرويد ويونغ. اضافة الى الوجودية التي وصلتنا عبر كتابات سارتر، سيمون دي بوفورا، البيركامو. من الواضح تماماً أن جيل الستينيات كان يمثل ردة فعل جمالية وفكرية على الأجيال الشعرية السابقة، ولاسيما جيل الرواد الذي كان يغلب -في أحيان كثيرة- مضامين القصيدة ودلالتها الاجتماعية أو السياسية على ثراء الشكل الشعري. لذلك كان شعر الستينيات، في نماذجه المتقدمة، تمرداً على سيادة الموضوع، وهيمنة الدلالة. كان شعر الستينيات، الى حد واضح، شعراً متقداً بالخيبة والشك والرفض. ولم يكن للشاعر الستيني يقين فكري أو سياسي يطمئن اليه، لقد كان شاعراً بلا يقين. كما أن يقينه الشعري قد تعرض الى هزة كبيرة. وهكذا جاء شعر الستينيات ليشكل قياساً الى اطمئنان شعراء الخمسينات الى خياراتهم الجمالية، بحثاً وقلقاً وتجريباً. ولم يكن التجريب الستيني شكلياً مجرداً، بل كان التجريب أكثر عمقاً وشمولاً: البحث عن أفق أغنى في الشعر والسياسة والفكر والعلاقات الانسانية. لقد كان التجريب الشعري، كما يقول سركون بولص، يقترن: «مع مجريات التجريب الاجتماعية والتاريخية في تلك الفترة، الحاصلة في صلب المجتمع لا على قشرته الخارجية» والهاجس التجريبي، لشعراء الستينيات، شديد التنوع؛ فهو: «لا يكف حتى يجد الشكل الأمثل للتعبير عن موقع الكاتب في عالمه وزمانه. فهو كرمز عملي يشير الى قلق أساسي عند الكاتب، الى ثراء روحي لا يتسرع في تبني الخيارات، يدفعه الى البحث عن بدائل لما هو سائد، وبالتالي الى التمرد على كل نمطية» انه البحث القلق، والمستريب من كل شيء، فمن العبث البحث عن حقيقة ثابتة ضمن الزمان والمكان ويرى الشاعر الستيني أن القصيدة ليست حديثاً «عن» موضوع ما، أو فكرة ما. بل هي رؤية يمتزج فيها النص والموقف، وتتماهى فيها اللغة بالدلالة والشكل بالمضمون. كما أن الدافع، لكتابة القصيدة، ما عاد، كما كان في معظم شعر الخمسينيات: الاصلاح أو الوعظ، أو التغني بلغة مباشرة. ان الدافع الأعمق للكتابة الشعرية هو «صبوة الروح للتماس مع الحقيقة التي تعذب كياننا». لقد انطلق الشاعر الستيني من هوس داخلي واحتفاء بالفرد وانكساراته الروحية والسياسية؛ لأن هذا الفرد هو الحقيقة الثابتة التي لا يكتب الشعر الا بوحي منها. لم يكن جيل الستينيات، رغم الكثير من الخصائص المشتركة، جيلاً دون تمايزات. وربما يمثل البيان الشعري نموذجاً لذلك التباين الصارخ. فالبيان، لغة ورؤى ومفاهيم، يظل أقرب الى فاضل العزاوي منه الى أي من الشعراء الثلاثة الآخرين الذين وقعوا عليه الى جانب العزاوي. ويمكن القول دونما مبالغة ان فاضل العزاوي كان أكثر شعراء الستينيات اثارة للجدل، خاصة في اندفاعتهم الأولى. كان صوتاً تجريبياً محرضاً ساهمت قصائده، مساهمة عميقة، في تشكيل مناخ القصيدة الستينية الى جانب أصوات تجريبية أخرى مثل سركون بولص، صادق الصائغ، جليل حيدر، جان دمو، صلاح فائق، مؤيد الراوي، عبد الرحمن مجيد الربيعي «في مرحلته الأولى الخاصة». الى جانب هذا النفس التجريبي القائم على التمرد والمغامرة وتعكير تجانس الشعر بالفوضى وماء الايقاع بوعورة النثر، كان هناك موجة أخرى في ذلك النهر الستيني الحي: حسب الشيخ جعفر، فوزي كريم، سامي مهدي، خالد علي مصطفى، عبد الرحمن طهمازي، ياسين طه حافظ، حميد سعيد، مالك المطلبي، محسن أطيمش، علي جعفر العلاق، شريف الربيعي، عمران القيسي، نبيل ياسين، آمال الزهاوي، خالد الحلي، حسين عبد اللطيف، مي مظفر، شاكر لعيبي، هاشم شفيق، خليل الأسدي. ان القصيدة، لدى هذا الاتجاه، لا تستمد نشاطها من هاجس التضاد، والتنافر بل من استيعاب للتراث القريب والبعيد وتمثل له، ومن رؤية شعرية تستمد لهبها الفاتن من العصر وقوة الماضي معاً. رؤية ترتبط بالحياة ارتباطاً ممضاً وترتفع بها الى مستوى الحلم وتوهج البصيرة. في هذا الاتجاه لا تكون القصيدة طفرة أو انقطاعاً، بل هي تطور عضوي: يستند الى المنجز الشعري دون أن يتطابق معه، ويبتعد عنه دون أن يلغيه والقصيدة، هنا شكلاً محضاً، أو لعباً مجانياً؛ فالشكل، لدى هذا التيار، أحد مقومات الرؤية وقوام عجينتها الحارقة. ولا تصبح القصيدة الا تجسيداً لعذاب النفس وضغط الحياة في شكل شعري تتحول فيه الأشياء والأفكار والموضوعات الى طينة تشع بالدفء والتجانس. ومن الضروري القول ان مفهوم الجيل، هنا، ليس مفهوماً زمنياً. ان جيل الستينيات ليس انتماء للتاريخ، أو الزمن في تعاقبه سنوات وأجيالاً، بل هو انتماء للرؤية الواحدة التي تجمع هذه المجموعة من الشعراء في نظرتهم الى الشعر واللغة والحياة. وبهذا المفهوم فان شاعراً كيوسف الصائغ، وهو شاعر خمسيني، لم يكتب شعراً حقيقياً الا في ظل المناخ الذي فجره شعراء الستينيات. كما أن شاعراً خمسينياً مهماً آخر مثل عبد الرزاق عبد الواحد، استثمر بعض الرؤى الستينية وما أشاعه شعراء الستينيات من مفاهيم جديدة حول القصيدة وعناصر البناء فيها. شعراء الربع الأخير من القرن العشرين لقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين موجة شعرية متصلة الحلقات، ومع أن من الصعب وضع حدود باترة بين حلقة وأخرى، فان الحيوية التي رافقت الكثير من شعراء هذه الحقبة لا تزال واضحة. ان شعراء كثيرين لمعت أسماؤهم بعد أن رفعت الموجة الستينية أذيالها، وما يزال الكثير من بلل تلك الموجة عالقاً بقصائد البعض من هؤلاء الشعراء، بينما يحاول بعض المتميزين منهم أن يحملوا تلك الانتباهة الشعرية التي أطلق شرارتها جيل الستينيات الى مديات أرقى. ومهما كانت التمايزات بين هذه الأجيال الشعرية فانها تشكل حيوية نهر الشعر في العراق، انها تموجات متتالية تنبثق من بعضها البعض لتمهد الطريق لاندفاع النهر وجيشانه الحميم: زاهر الجيزاني، هادي ياسين علي، عدنان الصائغ، خزعل الماجدي، فاروق يوسف، كمال سبتي، كاظم جهاد، علي الطائي، فاروق سلوم، كاظم حجاج، أمجد محمد سعيد، جواد الحطاب، معد الجبوري، رعد عبد القادر، كزار حنتوش، علي الشلاه، عيسى الياسري، عبد الكريم راضي جعفر، سلام كاظم، عبد الرزاق الربيعي، محمد مظلوم، عقيل علي، صلاح حسن، منعم الفقير، طالب عبد العزيز، ريم قيس كبة، فضل خلف، وآخرون. انهم على تفاوت نبرتهم وتباين أساليبهم، يمثلون تطوراً عضوياً في حركة القصيدة الحديثة في العراق. « يذكر ان هذه المادة جزء من بجث طويل للباحث.
(*) نشر في صحيفة "البيان" الثقافي - عدد 164 - 30/3/2003
|