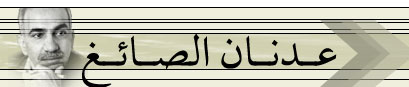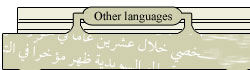تنطوي تجربة الشاعر عدنان الصائغ على نوع من المغايرة والاختلاف مع جيله الثمانيني، ذلك الجيل الذي يُعّد الأكثر خسارة على صعيدي الأدب والحياة. فهو من جهة يعاني من هيمنة جيلي الستينات والسبعينات، وما أسفرت عنه تجاربهم الحداثوية من أشكال ومضامين جديدة حاولت جهد إمكانها أن تستنطق الواقع وتضعه في موقع المساءلة الجدية. وأكثر من ذلك فإنها طرحت أسئلتها الخاصة بها متفادية الوقوع في فخ التبعية والوصاية وسطوة النص الأول. وهو من جهة ثانية الجيل الذي عاش حربين شرستين وحصار ظالم قلما نجد له نظيراً في قسوته ووحشيته في التاريخ الحديث. ولعلني لا أغالي إذا قلت بأن موهبة عدنان الصائغ قد تفتقت إلى أقصاها في ( خنادق البقاء على قيد الحياة ) وفي السواتر الأمامية، أو لربما كان مصباحاً من ( مصابيح الأرض الحرام ) الذين يمكن توصيفهم بأنهم عناصر إنذار مبكر يقرعون ناقوس الخطر قبل أن تفترسهم أفواه الموت النهمة. ومع ذلك فقد كان عدنان الصائغ يمعن في المجازفة فيقول: ( رغم رصاص القناص كنت أرفع رأسي لأرى أي زهور نبتت خلف الساتر ). لقد انتبه الكثير من النقاد والشعراء والقرّاء منذ وقت مبكر إلى شاعرية عدنان الصائغ التي لا تخطئها الذائقة الأصيلة المرهفة، بل وربما يكون الشاعر العراقي الوحيد من بين أبناء جيله الثمانيني الذي حظي بإعجاب منقطع النظير، بدءاً بالبياتي وسعدي يوسف وحسب الشيخ جعفر والحيدري وجبرا إبراهيم جبرا وشيركو بيكس وعبد الستار ناصر وعبد العزيز المقالح ويوسف الصائغ وعبد الرزاق عبد الواحد، مروراً بمدني صالح وعلي عبد الرضا وعبد الرحمن الربيعي وحاتم الصكر وفاضل ثامر ورشدي العامل ومحمد مبارك وعلي عباس علوان وخليل الشيخ وصباح الخراط زوين ومحمد علي شمس الدين وإبراهيم أحمد وطراد الكبيسي، وانتهاءً بسعدية مفرّح وعبد الرزاق الربيعي وكزار حنتوش ونازك الأعرجي ويوسف العاني وسامي عبد الحميد وكريم رشيد وعناية جابر وداود الفرحان وعمر شبانة ولارا العمري وستانفان أيرسكورد وياسيكا يورانسون وآنا ستوبي وعشرات الأسماء الأخرى التي لا يمكن حصرها في هذا المجال. إن هذا الإجماع النوعي على شعرية الصائغ يؤكد بالدليل القاطع على أن الشاعر له بصمة خاصة، وأن قصائده مغايرة للنمط السائد والمألوف، ولا أريد القول بأنها ( من نسيج وحدها ) لأنها ليست قصائد يتيمة أو مقطوعة الصلة ( تماماً ) بما سبقها من منجز شعري عربي. إن قصيدة الصائغ محتفية بكثافتها وتركيزها وتمترسها خلف إيماضات حادة واخزة تقذف بالمتلقي إلى برزح التوهج والانبهار. إن قصيدة الومضة أو القصيدة البرقية التي نالت جزءاً كبيراً من اهتمام الشاعر تستدعي استنفار المدركات الحسية، واستفزاز المخيلة إلى أقصاها من أجل اصطفاء أو اقتناص المفردات الشعرية التي تنسجم تماماً مع الأنساق الدلالية والبنى الداخلية للجمل الشعرية التي تكوّن المعمار الفني لمتن النص الذي لا يخضع لشروط ومقاييس الأشكال أو الهياكل ( النمطية ) التي لم تتمرد على القوالب الشعرية الجاهزة. لقد بدأ الصائغ مشروعه الشعري بقصيدة ( الومضة ) في مجموعته الشعرية الأولى ( انتظريني تحت نصب الحرية ) التي صدرت عام 1984. وعاد إليها في بعض قصائد ( تحت سماء غريبة ) و ( تكوينات ) و ( تأبط منفىً ). وقد قوبل ديوانه الأول بترحاب كبير من لدن النقاد الذين صدمتهم ( الأشكال والمضامين ) الجديدة، وزعزعت قناعاتهم السابقة، وأربكت توقعاتهم، ووضعتهم أمام الأمر الواقع الذي لا ينسجم مع الأنماط الشائعة أو المستهلكة. وكان الناقد عبد الجبار داود البصري هو أول من احتفى بديوان ( انتظريني. . ) الذي صدر عام 1984 ونبّه إلى شاعرية الصائغ الذي كان في حينها جندياً يعيش في ظروف مزرية ( لا تنسجم مع رقة الشاعر وشفافيته ) قبل أن ينتقل للعمل في صحيفة ( القادسية ) أولاً، ثم مجلة ( حراس الوطن ) التي ازدانت بلمساته الشاعرية بعد أن نفض عنها غبار المعارك، وأمدها بنسغ أدبي بحيث بات البعض يتحرق شوقاً لقراءة موضوعاتها الثقافية والفنية. لم يؤدلج الشاعر عدنان الصائغ قصائده قط ( على الرغم من قساوة الظرف السياسي الخانق الذي أطبق بأجنحته القمعية على شرائح واسعة من المجتمع العراقي ) لأن فنية النص الشعري كان شغله الشاغل. فهو لم يمجد الحرب، ولم يجمّل الصورة البشعة لمشعيلها، بل ربما كان أحد أبرز الشعراء ( المجازفين ) الذين أفصحوا عن هذياناتهم وكوابيسهم وهلوساتهم في نص شعري تحول لاحقاً إلى مسرحية جريئة استجارت بعنوان مراوغ هو ( هذيان الذاكرة المر ) والتي نالت نصيباً موازياً من النقد والدراسة والاهتمام بحيث عدّها البعض ( صرعة الموسم المسرحية ) لجرأتها، وكشفها للمحجوب والمستور والمسكوت عنه، وتعريتها للمساحة المختفية تحت اللسان، عن طريق التلميح تارة، والتصريح تارة أخرى، الأمر الذي أثار غضب المعنيين فمنعوها في العرض الثاني، ولم يطلقوا سراحها إلا بعد أن شذب الرقيب بعض العبارات والجمل التي كان يعتقد أنها تجاوزت الخطوط الحمر، وخرجت عن بيت الطاعة.
إن الظروف الاستثنائية الشاذة والملتبسة هي التي دفعت الجزء الأكبر من شعراء الثمانينات إلى الاتكاء على لغة عدمية حيناً، وباطنية حيناً آخر. وربما ذهب البعض الآخر إلى التعويل على التهويمات اللغوية التي تلتف حول نفسها وكأنها تدور في فراغ مطبق يعكس مفاهيم الضياع والغربة واللامعقول والتغريب والعبث واللاجدوى وما إلى ذلك. فاللغة أصبحت وسيلة انفصال أكثر منها وسيلة اتصال،بل تحولت في كثير من الأحيان إلى أداة تشويش وكأنها تتقصد القطيعة النهائية مع المتلقي. فليست هناك سياقات دالة متجانسة في الكناية أو المجاز أو الاستعارة وفي (التشبيه تحديداً ) فالدال لا يشير إلى المدلول، بل يتقاطع معه، ويتعارض إلى حد التضاد. الأمر الذي دفع ببعض النقاد إلى تفادي الكثير من تجارب الجيل الثمانيني بحجة إمعانهم في التغريب والتجريد والغموض المفتعل، ناهيك عن تعزيزهم لبعض المفاهيم الميتافيزيقة، ولجوئهم إلى لغة سرية، خفيّة، مواربة، مليئة بالطلاسم والتعاويذ والرموز والشفرات. إن هذا التوصيف قد ينطبق على تجارب العديد من الشعراء الثمانينيين، ولكن ثمة شعراء لم يسقطوا في ( خديعة التعبئة العسكرية ) ، ولم يروجوا للحرب أو يرقصوا في حضرة السلطان. و عدنان الصائغ هو واحد من هؤلاء الشعراء الذين ذهبوا إلى فتنة النص الشعري، وغواية أشكاله الفنية أكثر من ذهابه إلى مثابات التعبئة، وفضاءات التطبيل التي خلقتها سلطات القمع الثقافي بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى. لقد تناول عدنان الصائغ الحالات الإنسانية المرهفة التي تشكل في حقيقة الأمر إدانة للحرب، وتعرية لمفجّريها، وفضحاً لبشاعاتها ومجازرها التي شوهت مخيلات الناس وأرواحهم. فقبل أن يصدر ( سماء في خوذة ) عام 1988، كان قد اصدر ( أغنيات على جسر الكوفة ) و ( العصافير لا تحب الرصاص ) عام 1986. لقد أحدثت ( سماء في خوذة ) منعطفاً في تجربته الشعرية. فهي مجموعة جريئة تتميز ببسالتها في مساءلة الواقع الاستثنائي، والغوص في بواطنه السريّة وأعماقه الكثيفة. وقد كانت بمثابة القنبلة الموقوتة التي تفجرت لاحقاً، وأضاءت كل ما هو محذوف ومقصي ومصادر ومغيّب عن الأنظار. ومع ذلك فقد ظل مشروع التعرية الأكبر مؤجلاً بالنسبة للصائغ. فعندما غادر العراق غير مصدق بأنه قد نفذ بجلده من زنزانة القمع إلى فضاء الحرية فأصدر ( تحت سماء غريبة ) لينفس عن ذاكرته المكتظة بمشاهد الدماء، والمشبعة برائحة الحزن الأسود. كانت طبول الحرب تدمدم في رأسه وهو في عمان، بينما كان ينوء تحت ثقل الفاجعة التي هرست أعصابه وهو ينظر بذهول إلى فم الموت المرعب وهو يلتهم الأصدقاء واحداً تلو الآخر. فليس غريباً أن يكرّس ملحمة شعرية كاملة اسماها ( نشيد أوروك )، وهي ( اختصار لكل ما مرّ على هذه الأرض من حروب وحضارات وطغاة ). وعلى الرغم من حلقات اللغط الكثيرة التي طوقت تجربة الشاعر عدنان الصائغ من كل حدب وصوب، خصوصاً بعد فوزه بجائزتين متتاليتين هما جائزة هيلمان هاميت العالمية للإبداع وحرية التعبير عام 1996 في نيويورك، وجائزة الشعر العالمية في روتردام/ هولندا عام 1997، والتي ينبغي أن نعدهما مكسباً للشعر العراقي. والطريف في الأمر أن عدنان الصائغ يكاد يكون الشاعر العراقي الوحيد في المنافي الأوربية الذي ما يزال يكتب بشكل جدي ضد الدكتاتورية في العراق خاصة، والعالم بصورة عامة. ومع ذلك فإن البعض يصر على أدلجته، ومحاصرته باللعنة الأبدية. في حين أنه ليس أكثر من ( شاعر أدركته حرفة الأدب) فانقطع للكتابة عن الوطن والحب والحرب والذكريات والسنوات المتسربة من بين أصابعه الراعشة. ومن يقرأ ( مرايا لشعرها الطويل ) سيكتشف من خلال ( انكسارات حرف العين ) تحديداً أن الشاعر عدنان الصائغ متورط بهاجس الكتابة حد الجنون. ولا غرابة في أن يقول غير مرة: ( لا مناص لي من كتابة الشعر حد الفجيعة ) . فمن أين لهذا الشاعر المتيّم بالشوارع والأرصفة والمقاهي والحانات والمصاطب والحدائق والنساء والطيور والأصدقاء وزهور عباد الشمس وضياء القمر الجميل أن يجد بعض الوقت لأدلجة نصوصه المتمردة التي تأبى أن تتمسح بأذيال السلاطين.
لا يستطع أن أحد أن ينكر على عدنان الصائغ حلاوة المفردة الشعرية ، وطلاوة التشبيه، وعمق المجاز، وجمال الاستعارة في نصوصه الشعرية التي تحقق للقارئ لذة الاستمتاع بجمال الصور الشعرية المبتكرة التي تهزه من الأعماق، وتأخذه إلى أقانيم الدهشة والفرح. فهو ينتقي المفردة الشعرية البسيطة والمتداولة، ولكنه يضعها في السياق الصحيح، فتأخذ بعداً آخر ودلالة جديدة. ناهيك عن القاموس اللغوي الرشيق الذي يتوفر عليه الصائغ. فهو نادراً ما يستخدم مفردة فاقعة أو وعرة أو حوشية، لأن ملكته اللغوية تقوم بالأساس على دفق عفوي منساب متأتٍ من قراءات كثيرة استطاع من خلالها أن يروض اللغة ويستدرجها من أبراجها العاجية، ويلوي، في نهاية المطاف، عنقها لتستجيب للأفكار والموتيفات واللقطات اليومية العابرة. ولهذا فقد أطلق عليه بعض النقاد اسم شاعر القصيدة اليومية بامتياز. وهذا التوصيف يحسب لصالحه، لأن هذا النمط من القصائد يعد واحداً من أصعب أشكال الكتابة الحديثة التي تعتمد على التركيز والاقتصاد الشديدين بحيث قد يصل طول القصيدة إلى سطر واحد أو جملة واحدة لا غير، كما في القصائد أو التكوينات التالية: ( أقف أمام المرآة لكي أرى وحدتي )، ( ظلكِ غيرة نائمة )، ( حين لا ينحني الجسر لن يمر النهر )، ( كلما حلَّ عقدةً طال حبل المسافة بينهما ). لقد جرّب الصائغ كتابة أغلب الأشكال الشعرية الحديثة. وعلى الرغم من تمكنه من كتابة القصيدة العمودية التي نشر بعضاً من نماذجها المبتسرة في ديوانه الأول، إلاّ أنه سرعان ما غادر هذا الشكل التقليدي إلى قصيدة الشعر الحر أو المرسل أول الأمر، ثم إلى قصيدة النثر لاحقاً. فضلاً عن محاولاته المستمرة للإفادة من السرد القصصي، وتوظيفه بشكل معمق في القصائد البرقية والتكوينات تارة، وفي قصائده الطوال، وبالذات في ( نشيد أوروك ) تارة أخرى. إن الذي يتأمل قصائد عدنان الصائغ، ويطيل النظر إليها، سيجد من دون عناء أن الشاعر قد أفاد من مجمل الفنون القولية وغير القولية، وتمكن في النهاية من أن يكتب نصاً مفتوحاً تنعدم فيه الحواجز التي رسخها الأولون بين الأنواع الأدبية والفنية. بل أن ( نشيد أوروك ) لا يمكن تصنيفه كنص شعري يعتمد على السرد القصصي أو الروائي فقط، لأن تقنيته، فضلاً عن شكله وفحواه، تذهب أبعد من ذلك بكثير. فهو نص مفتوح ( يمتزج فيه التاريخ والأساطير والفلسفات والسحر والسير والتراث الفكري الإنساني والعقائد والجنس والأشخاص والأحداث ليشكل هذياناً مسعوراً أقرب إلى صرخة احتجاج أمام ما يحدث ) كما يمكن اعتباره من جهة ثانية بحثاً سايكولوجياً في الشخصية العراقية التي أصبحت حقلاً للهلوسات، ومرتعاً للهذيانات المستمرة بفعل الظروف الضاغطة التي أشرنا إليها قبل قليل. إن فحص المنجز الإبداعي للشاعر عدنان الصائغ يكشف لنا ولعه الدائم بالتجريب والمغامرة على صعيدي المبنى والمعنى. فقصيدة ( جنوح ) التي كتبها عام 1992 والمنشورة في ديوان ( تحت سماء غريبة ) لا تختلف في شكلها عن كتابة أي نص قصصي، في محاولة لتحطيم القوالب الشعرية الجاهزة التي تفرض وصايتها أو هيمنتها اللامبررة. وهذا الأمر يتكرر في العديد من نصوصه الشعرية. إن ما يميز لغة الصائغ عن مجايليه خاصة، والشعراء العرب عامة، هي شفافيته المفرطة، ورومانسيته التي تتفجر حتى في قصائده التي تتناول موضوعة الحروب والكوارث المفجعة. نخلص إلى القول إن عدنان الصائغ هو علامة فارقة في المشهد الشعري العراقي. وإن الاحتفاء بتجربته الشعرية هو جزء من الاحتفاء الكبير بالشعر العراقي الأصيل سواء في داخل الوطن أو في المنافي البعيدة.
(*) نشرت في مجلة "ضفاف" ع 9 شباط/ فبراير 2002 النمسا ( عدد خاص- الصائغ في مرايا الإبداع والنقد)