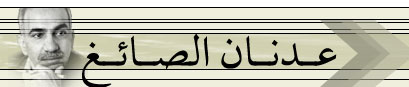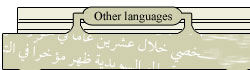|
مناف وقوائم وانتربول
لطيفة الشعلان
لو أتيح للنظام العراقي أن يرحل رموز الثقافة العراقية الحرة إلى العالم الآخر لما تردد ساعة، وسيكون قول الفاشست عن الشاعر الأندلسي لوركا حين أعدموه في ضواحي غرناطة رميا بالرصاص: (إنه أحدث بقلمه دماراً يفوق ذلك الدمار الذي أحدثه غيره بالسلاح) جاهزا للفاشيين في العراق، ليعلقوه في رقبة كل كاتب أو شاعر أو مثقف، لم يقبل المساومة ولا التدجين. هذا على الرغم من أن الشرفاء الذين ظلوا في العراق أو تاهوا في القارات. مثلهم مثل شاعر الأندلس، ان لم يعمروا، فلا يمكن كأضعف الإيمان أن يحدثوا دمارا من أي نوع، والواحد منهم يتمنى أن ينهض العراق ولو على أشلائه، مثلما أنشد لوركا:
"وددت لو أن دمي انسكب في الحقل
فتلين قسوة التربة وينبت فيها الأرج"
في الواقع العربي لا يوجد هناك نظام يعادي خيرة مواطنيه من مثقفين وأساتذة جامعات وأدباء وفنانين، ويطاردهم وكأنه يريد أن يفرغ البلد منهم، ليصفو للحرامية والمنافقين، مثلما يفعل النظام العراقي مع مواطنيه، الذين فروا بجلودهم وحناجرهم لاجئين، أما إلى ديار القريب أو ديار البعيد، حسب الحظوظ والتساهيل. مما شكل لدينا شتاتا عربيا جديدا، قوامه بضعة ملايين، الذي مع تفرده في دواعيه وظروفه، إلاّ أنه يتقاطع ولا فخر. مع الشتات الفلسطيني، في ويلات التشرد والمنافي، وشكل الغربة التي لا سبيل لأهلها إلى الأوطان، ولا طاقة بهم على الاستيطان، ربما.
والملاحقة الرسمية للعراقيين الموجودين في بلاد اللجوء، من مثقفين وكفاءات علمية, تتفتق كل حين عن وسائل جديدة, تثبت أن المثقف الحر هو بعبع النظام الذي يشك في ظله, والذي يمكن ببساطة أن تخضه على بعد المسافات ما بين العراق وبين المنافي, قصيدة لعدنان الصائغ أو قصة لهيفاء زنكنة أو معزوفة لنصير شمة.
وعلى هذا يمكن فهم القائمة التشهيرية التي ضمت أسماء أثنين وثلاثين مثقفاً عراقياً في الخارج, والتي نشرتها مؤخراً صحيفة "الزوراء" العراقية, وشبهتها مجلة "المسلة" الثقافية متهكمة, بالوشاية الأقرب إلى التقارير الأمنية والحزبية سيئة الصيت, التي طالما دفع العراقيون لها ثمناً من حياتهم.
هذه القائمة التعسة التي عنونها تعساؤها بـ (عدد من الأدباء الذين خرجوا بعد التسعينات من الوطن والذين يكتبون الآن في الجرائد والمجلات المعادية) جاءت وافية كافية, بأربع خانات: الأولى حوت أسم المثقف, والثانية سنة خروجه من العراق, والثالثة بلد إقامته, والرابعة صفته التي توزعت ما بين شاعر وناقد ورسام وممثل وروائي ومترجم وقاص وكاتب ومسرحي وكاتب أطفال.. أما بلدان الإقامة فمن الأردن وسوريا والسعودية إلى السويد والدنمارك وهولندا. ما نقص القائمة, خانة خامسة تجلو سبب الخروج من الجنة العراقية, هل خرج المثقف لأنه خائن وجاسوس أو لأنه يريد الاحتفاظ بالمنحة الربانية وحسب, أصابع يديه وأذنيه ولسانه.
يتصدر القائمة عدنان الصائغ, وواضع القائمة لم يصدرها به عبثاً, أليس عدنان الذي مر تحت سماوات بيروت وعمان ودمشق وصنعاء, حتى حط حقائب ثيابه وكرتونات أوراقه في سواد السويد عوضاً عن سواد العراق, هو القائل:
"سأتمددُ على أولِ رصيفٍ أراهُ في أوربا
رافعاً ساقيَّ أمامَ المارة
لأريهم فلقات المدارس والمعتقلات...
ليس ما أحمله في جيوبي جواز سفر..
وإنما تاريخ قهر
حيث خمسون عاماً ونحن نجترُّ العلفَ والخطابات وسجائر اللف
حيث نقفُ أمام المشانق ونصفق للحكام
خوفاً على ملفات أهلنا المحفوظة في أقبية الأمن
حيث الوطنُ يبدأ من خطاب الرئيس وينتهي بخطاب الرئيس"
ومن أجل عيون الرئيس وراحة بال الرئيس, لم يبق إلا إدخال الأنتربول على الخط, فلكي يثبت المسؤولون العراقيون شفافيتهم, ومحاربتهم للفساد, طلبوا من الأنتربول جلب عدد من النشطاء والمعارضين العراقيين في الخارج, ضمن اتهامات موثقة أو بالأحرى مطبوخة, على مواقد الرئاسة الهادئة, كاتهامات التزوير والاختلاس والشيكات التي بلا رصيد, ومن بين المطلوبين بهذه الطريقة الدولية, الأستاذ الجامعي وائل خماس وعشرات آخرون غيره.
وهذه لعمري طريقة جهنمية, يؤسسها نبوخذ نصر مستفيداً من النظام العالمي الذي يصيح منه ليل نهار, وفيها ستلاحق الأنظمة الاستبدادية على شاكلة النظام العراقي, الذي سرق الجمل بما حمل, بعض الأبناء العاقين الفارين من الجور والعسف, متهمة إياهم بسرقة البعر والدمن.
ومن ناحية ثانية, ومهما اختلفت نار عن نار, فان خروج المثقف العراقي لا يشبه إلا خروج المثقف الجزائري, الأول يخشى سيف النظام وفأسه, والآخر يخشى الفؤوس والسيوف غير النظامية, ولا مانع من النظامية كذلك, فالقاعدة الجزائرية تذهب إلى أن المثقف إذا مال إلى السلطة قتلته المعارضة, وإذا مال إلى المعارضة قتلته السلطة, وإذا بقي حيادياً قتله الاثنان معاً.
ولقد لخص الكاتب والصحافي الجزائري يحيى أبو زكريا حجم المأساة قائلاً, (أنا أكتب إذ أنا مقتول). وهو لا يتردد في الاعتراف بأنه لم يملك شجاعة من بقي في الجزائر, تحت رحمة الرصاص الطائش وشفرات الحلاقة, فخرج تحت ترغيب وإلحاح من والدته التي قالت له: إن أراك غريباً مشتتاً في بلاد الناس خير لي من أراك مذبوحاً من الوريد إلى الوريد.
وهذا الشتات في بلاد العباد حتى وإن حمى الوريد, فهو عند واسيني الأعرج يبطئ وتيرة الإبداع, فنراه يقول: إنه حين كان في الجزائر كانت شحنته الداخلية للكتابة قوية, لأنه كان يشعر أنه في سباق مستمر مع الموت, ليتم العمل الذي تحت يديه, قبل لأن تفاجئه رصاصة, أما باريس فهي تجعل واسيني أكثر بطئاً, وشحنته الداخلية أقل توهجاً.
يتفق معه بشكل أو بآخر, مواطنه الطاهر وطار, الذي قال يوماً: إنه لن يغادر الجزائر, لأنه فيها إنما هو في خضم دراما مهولة ومعقدة, قد تكون لازمة لمشروع روائي جديد.
لكن لا غبار البتة على وجهة النظر الأخرى, التي ترى أن من حق المبدع أن يبدع في أجواء من الراحة النفسية والحرية المعقولة, إن لم يجدها في وطنه, فمن حقه أن يفتش عنها في أوطان الآخرين. خاصة أن كثيراً من المثقفين العرب, الواحد منهم, كما تصوره فوزية رشيد يشبه طائراً حبيساً أو أسداً يعج بالقوة, ولكن قفصه السيركي يحاصر حيويته, فيستكين في زاوية منه ليتفرج الآخرون على مارد حبيس.
أما إلى أي حد يمكن في اعتقادي أن يكون المنفى الطوعي أو القسري محرضاً على الشغل الثقافي والأدبي, فهذا يعتمد على مقدار الأمن والحرية اللذين يختلف حجمهما وسعتهما باختلاف المنافي, وباختلاف احساسات المنفيين أنفسهم.. وفي أسوأ الأحوال ستظل باريس ولندن أفضل مليون مرة من الجزائر والعراق, وذلك الأخير قال عنه عدنان الصائغ:
"العراقُ الذي يبتعدْ
كلما اتسعتْ في المنافي خطاه
والعراق الذي يتئدْ
كلما انفتحتْ نصفُ نافذةٍ.. قلتُ آه
والعراق الذي يرتعد كلما مرَّ ظلٌّ...
تخيلتُ فوهة تترصدني أو متاهْ
والعراق الذي نفتقدْ
نصف تاريخه أغانٍ وكحلٌ..
ونصف طغاةْ".
(*) مجلة المجلة - لندن ع1060 في 4-10 حزيران 2000
|