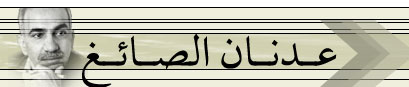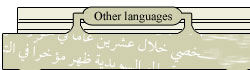عدنان الصائغ: لم أعد أخشى شيئاً وقد بلّلتني أمطار اللعنات..
أجرى الحوار: د. حسن السوداني
لا يكاد يُذكر جيل "الثمانينات" الشعري في العراق، إلاّ وقفز أسم "عدنان الصائغ" حاملاً رايته المثقبة بالريح والطلقات والدهشة. محاولاً رتق ثقوبها بكلمات ينسجها بعيداً عن عدمية الفكرة وباطنية اللغة. ساخراً من تلك التهويمات الملتفة حول نفسها كأفعى، تخيف القارئ، فيولي منها هرباً.
إنه يرسم صوراً من الغرائبية السحرية في أعين قرائه ومجايليه لقدرته على ترويض اللغة ولي عنقها برشاقة مصارع الثيران، وبدلاً من نحرها كما يفعل الآخرون.. تراه يضع أكاليل من الياسمين العبق على هامها الناصع، ناثراً ما تبقى من زهوره على مريديه ومبغضيه على حدٍ سواء.
ينحني حزيناً، كجسر الشهداء وهو يتأمل النهر بغرينه وأسرار الغرقى.. شاهداً حقيقياً يواكح الظلم بأصابع مدماة من فلقات الزمن الرديء..
بعد عقد من النفي القسري عن الوطن وأغانيه الكوفية ونصب الحرية وعصافيره الكارهة للرصاص وخوذته المثقبة ومرايا حبيبته وهذياناته المرة وغيومه الصمغية.. يتأبط منفاه، ليواصل في صقيع بلاده الاسكندنافية، نشيده الأوروكي الطويل.
إلتقيناه فكان لنا هذا الحوار:
هل النفس الاعتراضي الذي تحمله قصائدك من أول ديوان" انتظريني تحت نصب الحرية" وحتى "تأبط منفى" مردهُ صداقتك المبكرة للشاعر دعبل بن علي الخزاعي؟
- هذا الشاعر الذي حمل خشبة الصلب على كتفية، كان أول شاعر يستهويني ويستوقفني وأنا لم أكمل العاشرة من عمري.
ربما كانت الصدفة وحدها هي التي ألقته قي طريقي. إذ كنت كلما مررت أمام "بسطة" الكتب التي كان يفرشها رجل صامت ( جن فيما بعد !!). أقف متسمراً، أمامه ثم أقلّبه بين يديه وأحلم بشرائه وقراءته.
أو ربما كانت طفولتي الصعبة والحرمان الذي عشته، هما اللذان فتحا مداركي على التمرد، فوجدته متجسداً في هذا الشاعر الذي كان يجوبُ شوارع العصر العباسي، حاملاً قصيدته، صليباً على كتفيه، يبحث عمن يصلبه عيه وهو يوزع هجاءه المرير على قصور الخلفاء والوزراء والأكابر.
لقد وجدته مثالاً مذهلاً وسط جوقة الشعراء ودفوفهم. لكن عصرنا تغير، ولم يعد الشاعر المعارض قادراً على المشي في بلاده. فكيف به يحمل صليبه وقصيدته معاً.
عندما أقرأ لك مقالاً أو دراسة أو قصيدة طويلة وأحياناً قصيرة.. أجدك تكثر من الأسانيد الشعرية أو التاريخية أو السياسية أو الدينية.. كيف تفسر ذلك؟
- أرى أن القصيدة أو المقالة، في عصرنا الملتبس هذا، لابد أن تحمل إحالاتها، وتفرش مجساتها وتتواصل مع دائرة المعارف الإنسانية، لكي تكون قادرة على استيعاب موضوعة عصرها المثقل بالجديد والمتغير دائما.
إن كثيراً من أحداث التاريخ والدين والسياسة وأنت تقلبها اليوم بين يديك في رفوف مكتبتك، تجدها متماثلة مع الواقع الذي تعيشه بل تفسره أحياناً.
لهذا أرى أن على الكاتب أن يتسلح بالمعرفة والوعي بالإضافة إلى موهبته، حين يريد اقتحام حصن موضوع، فيعطيه حقه ويبدع فيه، مجترحاً فضاءات أبهى وأوسع.. فيرى القارئ انه أمام جهد نصي اختصر له الكثير. وليس أمام كلام إنشائي عابر.
طالما استوقفتني جملة لبورخس وهو يقول: "كلهم قرأوا أكثر مني لكنني عرفتُ ماذا أقرأ"...
وعلى هذا المنوال يمكنك أن تقول" عرفتُ ماذا أكتب، والخ. وباعتقادي أن عصرنا هذا بحاجة إلى لغة أوسع من نص الرواية أو القصيدة..
هل يمكن أن نطلق على قصيدتك الطويلة (نشيد أوروك) مصطلح الرواية الشعرية؟
- يمكنك ذلك، فهي تمتد على مساحة مئات الأوراق، وتكتنز الكثير من الأهوال والأحداث التي يمكن لها أن تشكل رواية أو شهادة مريرة حية لعصرنا هذا, عشتها في اصطبل للحيوانات عام 1984 في شمال العراق، حتى مغادرتي الوطن، ووصولي إلى بيروت عام 1996 حيث طبعت هناك.وقد سجلت فيها شهادتي الشعرية عن كل ما مر في بلدي منذ "سومر" حتى "عاصفة الصحراء"، مروراً بكل سنواتنا المسربلة بالكوارث والحروب والمنافي.، لتشكل نصاً شعرياً مفتوحاً يحتمل الرواية والتأريخ والموسيقى والمسرح والرسم، وغيرها من الفنون.
ما زلت أقرأ بين الحين والآخر مقالات أو بيانات تهاجمك بشدة ومصدرها بعض الجماعات أو شعراء جايلوك.. وعندما كنت في بغداد لمست شخصياً حجم الضغط الذي مارسته السلطة عليك وخاصة بعد عرض مسرحيتك الهذيان وصدور العدد رقم (11-12) من مجلة أسفار؟ ما الفرق إذن بين من هاجمك في الداخل ومن هاجمك هنا في المنفى؟
- الشعراء الذين جايلوني موضوعهم مختلف، وهو لا يتعدى المنافسة والغيرة لحصولي على عدة جوائز كانوا يطمحون للحصول عليها، وهو أمر يمكن للبعض أن يعده طبيعياً، حين يخضعه للطبيعة البشرية عند بعض الكتاب والشعراء.
لكن الأمر الآخر الذي لا يمكن تفسيره وفق أي معيار ثقافي أو سياسي هو التهميش أو الإتهام أو الضغط الذي يتعرض له المبدع حين لا يكون منضوياً تحت لواء حكومة أو حزب أو جماعة.. وهذا الأمر هو من أسوأ ما تعانيه أو تتعرض له الثقافة العراقية كلها بل والمواطن العراقي في الداخل والخارج ولكن على مستويات مختلفة.
إن شعار "أما أن تكون معي أو أنت ضدي" هو انعكاس للواقع المتردي ولضيق الأفق، الضيق الذي أشار إليه عنوان ديواني "سماء في خوذة" أثناء سنوات الحرب العراقية الإيرانية، حين كانوا يريدون اختصار السماء كلها بخوذة. وعليك أن تعيش وتفكر وتعشق وتكتب وتحلم تحتها. وقد كتب الصحفي المعروف داود الفرحان مقالاً في جريدة الجمهورية يقول فيها: "وديوانه الأخير "سماء في خوذة" ولد في عملية قيصرية صعبة وكاد أن لا يرى النور بسبب الصدق النازف دماً..".
في المنفى يصبح الأمر مختلفاً. لكننا نرى البعض يريد أن يختصرك أيضاً تحت قبعته أو لافتته أو شعاره.
لذلك عندما رفضت هذا المنطق الغبي هاجمني البعض، كلٌّ من جهته، محرضاً عليّ بعض الشعراء الفاشلين والمنضوين تحت لوائه. وهذا الأمر ليس جديداً، على مدار تاريخ الأدبي الإنساني، قديماً وحديثاً..
أما الفرق بين من هاجمني في الداخل بتقاريره الأمنية وبين من هاجمني في المنفى بشتائمه، فأنا لا أرى اختلافاً كبيراً بينهم في العقلية والقمع والمصادرة. أما تأثيرهم بالنسبة لي فهو كالفرق بين أن تلسعك بعوضة أو عقرب وأنت في الحجابات، على سواتر النار, وبين أن تلسعك وأنت تتمشى في حدائق روزنكورد في السويد. وعليك أن تقارن بين حدتهما أو ألمهما أو مخاطرهما.
انك وفقاً للتجنيس الشعري – شاعر ثمانيني – وأنا أعتقد ان هذا الجيل الشعري يمتاز بالكثير من المواقف المتناقضة والقلقة وأحياناً المنافقة.. فبعضهم حاول ان ينزع جلده وآخر له أكثر من وجه.. وآخر يتحدث أكثر مما يكتب كيف تعلق على هذا؟
- سأترك المواقف والذوات المنافقة، فمشهدنا الثقافي والسياسي، بشكل عام – وللأسف – يعج بالكثير. وهنا تكمن محنتنا المركبة على جميع المستويات. سأترك هذا الأمر وأتحدث عن التناقضات والاختلافات لأسميه تنوعاً سمفونياً وقرع طبول، مختلطين في وقت واحد، هو نتاج طبيعي لأصابع العازف- الجنرال الذي وضع جيلنا جلداً مشدوداً في طبل الحرب الكبير، جنوداً وشعراء ومعوقين وظل يقرع أناشيده الحماسية وشعاراته ( لكن علينا أن لا ننسى - في زحمة الطبول - أن هناك ثمة أوتاراً منفلتة أو ألحاناً متفردة، تسربت - من شقوق الوجع - في غفلة من عيون رقبائه ورجاله، وما أكثرهم) لهذا غالباً ما نلاحظ، هنا أو هناك، أن أكثر المتورطين في آلة العزف هم أكثر عياطاً في المشهد. ولهذا أيضاً، كثيراً ما نجد خلطاً في المواقف والنصوص. لكن الزمن والنقد وحدهما سيغربلان المشهد برمته. وعلى هذا، رهاني دائماً.
كيف تقيّم صدور العدد الأخير من مجلة ضفاف – الاحتفائي – بك ومساهمة أكثر من أربعين كاتباً فيها؟
- هو سلة ورد جميلة نثرتها علي مجلة "ضفاف" في هذا الزمن المجدب الذي لم يعد يتوقع فيه الكاتب العربي والعراقي بالتحديد أن يجد أمامه سوى سلال السهام والمرايا المهشمة. لقد حملت لنا مجلة "ضفاف" من ضفاف الدانوب ومن نخيل الفرات، هذا العبق النادر احتفاءً بجيلنا الثمانيني" الذي خرج من الحرب سهواً" كما قلتُ في إحدى قصائدي..
ألا تخشى أن - يضموك – إلى قائمة المغضوب عليهم بعد نشرك قصيدة (المحذوف من رسالة الغفران) التي ضمها ديوانك الأخير "تأبط منفى"؟
- لم أعد أخشى شيئاً وقد بللتني أمطار اللعنات، هنا وهناك، وتنقعت ثيابي وروحي وأشعاري. القصيدة كانت تساؤل بريء مفتوح أمام سماحة وجبروت السماء، حين وجدت آذان الجميع ونوافذهم، مغلقة أمامنا: - لماذا حدث لنا كل هذا؟
هذا التساؤل يحمله اليوم ملايين العراقيين المقموعين في الداخل، أو المشردين في أصقاع المنافي، بحثاً عن وطن آمن وخبز آمن. وما الأديان السماوية كلها إلا إيمان وأمان ومحبة.
هذا من جانب، ومن جانب آخر تحمل القصيدة أسئلة وجودية وفكرية، سبق للفكر العربي القديم أن طرح أكثر منها جرأة. لكن فكرنا المعاصر – يا للمرارة - لم يعد يتحمل مثل هذه الطرح. خانعاً ومستكيناً تحت سياط القائمين على الأمر. لذلك حاولت أن أشاكسه ببعض الأسئلة. وما الشعر - من جانب آخر - إذا لم يحمل في نبضه روح المشاكسة والتحدي والتمرد.