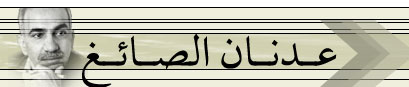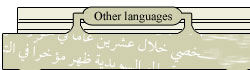في أواسط الثمانينات أثرت جدلاً واسعاً أيضاً داخل العراق؟
- صحيح هذا، لكنه يختلف عما حدث هنا . وهو – ياللطرافة والفجيعة - كان معكوساً تماماً ففي الداخل كان بعض الشعراء الفاشلين والمخبرين يروجون أن قصائدي معادية وأن أفكاري سوداوية لا ترى "بيارق النصر التي تلوح على جبين القائد الملهم"، والخ. وسبب غيظهم مني ببساطة هو اهتمام النقاد والأدباء والقراء الذي كنت أحظى به..
ذلك الجدل كان محفزاً لي على المواصلة والتحدي وقد مرَّ بمراحل عديدة بدأ منذ أن نشر الناقد يوسف نمر ذياب مقاله: "صباح الخير أيها الشاعر" عن أول قصيدة نُشرتْ لي في صحيفة الجمهورية 25/12/1982 وسبب الجدل أو الضجة التي أثارها المقال أن رئيس تحرير الصحيفة، الشاعر سامي مهدي رفض نشره بدعوى انها عن شاعر مبتدئ ينشر قصيدته لأول مرة ولم يعرفه أحد في الوسط الثقافي، فكيف يتم الاحتفاء به من قبل ناقد كبير، وأصر يوسف على مقاله، وأصر سامي على موقفه. وعلى أثر ذلك ترك يوسف وظيفته في الجمهورية وكان له عمود ثابت فيها وانتقل الى صحيفة الثورة ونشره هناك، وقد أثارت الحادثة والمقال جدلاً واسعاً في الوسط الثقافي حينها.
الأمر الثاني حدث حين كتب مدني صالح مقالته: "أنه أشعر العرب الذين جاؤوا إلى الشعر بعد نزار قباني والسياب والبياتي" إثر صدور ديواني الثاني "أغنيات على جسر الكوفة" 1986 بتقديم الشاعر الكبير عبد الوهاب البياتي.
وقد توالت عليها – أي مقالة مدني – الردود لعدد كبير من الأدباء والنقاد والمثقفين والصحف، فراح يناقشهم واحداً واحداً على صفحات المجلات والصحف والحوارات الأدبية.
وتناول تجربتي عدد من النقاد المعروفين في العراق أذكر منهم: حاتم الصكر، د. علي عباس علوان، ياسين النصير، د. عبد الرضا علي، عبد الجبار داود البصري، فاضل ثامر، عبد الجبار عباس، محمد الجزائري، طراد الكبيسي، محمد صابر عبيد، وغيرهم.. وتلك الكتابات النقدية حملتني مسؤولية المواصلة أكثر وأكثر..
والأمر الثالث تلك المقالة المثيرة التي كتبها الشاعر المرحوم رشدي العامل بمناسبة صدور ديواني "العصافير لا تحب الرصاص" في صحيفة القادسية 17/ 8 / 1987 تحت عنوان "شاعر لا يملك الإدعاء"..
وبعدها مباشرة اختفى الديوان من المكتبات وقيد الوسط الثقافي المرتعب الأدلة ضد مجهول كما يُقال! ثم ما حدث لديواني الآخر "ســــماء في خوذة " وقد كتب داود الفرحان عموده الاسبوعي في صحيفة الجمهورية متحدثاً عن الصعوبات التي واجـهها الديوان قبل طبعه:
["لفتت انتباهي إلى شعره زميلتنا ابتسام عبد الله التي كانت تتحدث بحماس طفولي عن الفتنة في قصائده والصدق في مشاعره.. وديوانه الأخير سماء في خوذة ولد في عملية قيصرية صعبة وكاد ان لا يرى النور بسبب الصدق النازف دماً في بعض قصائده" - صحيفة الجهورية – بغداد 1988]
لكن بعد فترة تم سحبه أيضاً من الأسواق...
وقد تناول الكاتب خالد محمد المصري هذا الديوان في اطروحته للتخرج من جامعة اليرموك الأردنية تحت اشراف الدكتور خليل الشيخ أستاذ الأدب العربي الحديث، مشيراً إلى تلك القضية:
[".. فقصيدة الصائغ انسانية المغزى، ترتكز بنيتها الأساسية على النقاط والجزئيات. وعلى الرغم من أن ديوانه سماء في خوذة قد صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد سنة 1988 إلاّ أنه سحب من الأسواق بعد فترة وجيزة من توزيعه وان دل هذا على شيء فأنه يدل على أن الديوان صوّر جوانب مهمة تستحق الوقوف والمعاينة.."]
وأخيراً اللغط الذي أثارته مسرحية "الذي ظل في هذيانه يقظاً" في مهرجان المسرح العربي في بغداد مطلع 1993 وإيقاف عرضها وما حدث بعد ذلك...
أما القضية الأخرى الذي أثارت البعض فهي الجوائز التي نلتها وهي: جائزة الشعر الكبرى عام 1992 عن قصيدتي " خرجت من الحرب سهواً" ، والجائزة الأولى في شهادات الحرب عام 1991 عن كتابتي "يوميات تحت القصف"، والأولى في الكتابة الحرة عام 1989، والأولى في الحوار الصحفي عام 1988 عن حواري مع الشاعر رشدي العامل تحت عنوان "قصيدة تمشي على عكازين" في مجلة حراس الوطن 12/12/1987.
وكل الذي كتبته في مقالاتي وقصائدي وفي المسابقات التي اشتركت
فيها شعراً ونثراً ليس فيها مدحاً أو تمجيدأ لـ "القائد" أو النظام..
وأمامك, وأمام التأريخ ما كتبته، قلّبه سطراً سطراً وكلمة كلمة.
(وإذ أذكر هذه الجوائز، فليس إلا من باب توضيح طبيعة كتابتي في تلك المسابقات التي شاركتُ فيها لظروف شتى، مرغماً وراغباً ومتحدياً) وقد تتعجب أكثر وأكثر إذا علمت أن أدباء كثيرين معروفين اشتركوا في هذه المسابقات بأطنان المديح، وسأسمح لنفسي القول ليس من باب التفاخر لكن من باب توصيف الحال: لقد سلطت السلطة الضوء على شعراء كثيرين ووهميين ومداحين، ومع ذلك أن تفوز عليهم بالشعر الصافي، والكتابة الصادقة، والحوار الجاد فهو الفوز الأبهى والمشاكسة الأجدى والتحدي بعينه الذي أزعج الكثيرين هناك من أدباء السلطة والفاشلين. وأبهج الأصدقاء والمبدعين والمتابعين الذين وجدوا فيه نوعاً من التحدي أو التشفي.
ذلك أن مجرد ظهور أية كتابة خالصة تعني عملية تحدٍ في زمن الاستبداد والطبول. وهو برهان عملي وعفوي على أن التعبير بصدق عن آلام الناس وآمالهم، والتمسك بجوهر الإبداع والتسامي به عن كل شيء هو الذي يحصنك ضد السقوط ويخرس ألسنة الأفاعي، تماماً كما فعل عود الفارابي حين نوم جميع المستمعين في مجلس الخليفة وخرج منسلاً بهدوء. هذه الحكاية التي أذهلتني وحفظتها منذ الصغر رسمت لي طريقاً سحرياً أدين له بالكثير، قادني إلى فن الخطاب المستتر ولغته الباهرة الأنيقة الموحية
[يقول الشاعر محمد صالح عبد الرضا عن تجربة الشاعر ولغته: ".. ويمكن أن نسميه حارس مرمى الاناقة الشعرية" - -صحيفة الجمهورية بغداد 1993
وتقول الكاتبة الصحفية مثال غازي: "يطل الشاعر بقصيدته على الذات لينشر على صفيح صوته الساخن معانات العصر" - مجلة الطلبة والشباب 3/7/1990 بغداد-
ويقول الناقد قيس كاظم الجنابي: ".. ويظل معبّراً عن تماس الشاعر بالبيئة وعن صلته بأحاسيسنا وشهقات انفاسنا في لحظة الارتعاش والخوف وهذه مسيرة مثقلة بالهواجس والرعب عبرت عنها تجربة الشاعر التي تناولت موضوعة الحرب ـ جريدة القادسية ـ بغداد 1990]
ولست وحدي من فعل ذلك فهناك الكثير والكثير من المبدعين العراقيين الأنقياء حد البهاء والدهشة، سلكوا هذا الطريق ومازالوا بنجاح وذكاء.. وأشير هنا إلى مقالة القاص عبد الستار ناصر، في رده على كتاب عبود، تحت عنوان "في مراجعة ثقافة العنف في العراق" - مجلة المسلة ع 3 أبريل 2002:
["لا أعتقد أيضاً بصحة ما جاء بشأن الشاعر عدنان الصائغ فما كان يوماً من رموز السلطة ولا بوقاً لها، ولا بد من تكرار كلمة المؤلف نفسه حين يقول " إننا لفرط ما أصابنا من اضطهاد أصبحنا نلهو في أوقات الفراغ بتعذيب بعضنا البعض" فقد كنت شخصياً على مقربة من عدنان الصائغ وكنا نتلذذ بشراكتنا – السرية – في شتم أجدادهم وانتظار اليوم الذي نتخلص فيه من رعونتهم ووحشيتهم.. أما عن حصوله على جائزة في أيام الحرب ثم على جائزة أخرى في المنفى، فهي حكاية ليس من الصعب تفسيرها، وبالتالي سوف تصب في خدمته كشاعر مهم له نبرته الخاصة وليس العكس"]
تعرضت دواوينك ومسرحيتك الشهيرة (الذي بقي في هذيانه يقظاً) للمضايقة والمصادرة وسبب ذلك تهديداً لحياتك، اضطررت بسببها للهجرة، كيف تصف لنا تلك الظروف ؟
- أروي لك حادثة
قبل نهاية الثمانينات كانت لنا أمسية شعرية مشتركة في كربلاء: هادي ياسين علي، عبد الرزاق الربيعي، وأنا.. حين انتهيت من قراءة قصيدة لي بعنوان "جائع" (ص79 من ديواني "سماء في خوذة").
نهض أحد الجالسن في القاعة وفاجأني بسؤال لم يخطر لي ببال
كيف أتحدث عن الجوع في زمن القائد المنتصر.. الخ الجنجلوتية..
أربكني سؤاله حقاً
واحترتُ بماذا أجيبه..
وقد انتبه الشاعر هادي ياسين لتلكؤي فبادر قائلاً:
- ليسمح لي صديقي الصائغ بالاجابة
وعندما ابديت موافقتي، قال له:
ان الجوع حالة انسانية يا أخي يمكن أن يحس بها كل انسان حتى القادة والرؤوساء والملوك.. تنفستُ الصعداء وظللنا بعد الأمسية، طيلة الليل، نضحك ونعلق على السؤال والجواب والقادة والرؤوساء والملوك..
هل يتصور أحد ما أن كتابات كهذه وغيرها لي ولآخرين، كانت تمر بسهولة، في بلد مثل العراق؟
فبالإضافة الى الواقع البوليسي الكاتم للأنفاس والرقابات الرسمية المتعددة، يصبح الكاتب نفسه في أحيان كثيرة رقيب نفسه، وأحياناً الزوجة والعائلة والأصدقاء. وتلك برأي أصعب مهمة يواجهها الكاتب في العراق.
لقد وصفتُ تلك الحالة في قصيدة قصيرة،
لكنني لم أستطع نشرها وقتذاك:
["في وطني
يجمعني الخوف
ُ ويقسمني:
رجلاً يكتبُ
والآخرَ خلفَ ستائرِ نافذتي،
يرقبني"
- من ديوان "تأبط منفى" 2001– السويد]
.. وأذكر أن الكاتب الصحفي ضرغام هاشم الذي كان سكرتيراً لتحرير مجلة حراس الوطن، كان يقول أن مقالاتي تحتاج منه لمراجعتها مرتين، قبل نشرها في المجلة، حرصاً منه عليَّ، لأنها "قد توقعك أو توقعني في ورطة".
كان يخاف عليّ كثيراً "من شطحات" قلمي كما يسميها
(لكن قلمه شط به حين كتب رده النبيل والجريء على مقالات جريدة الثورة الشهيرة بعد حرب الخليج عن سكان الأهوار، فأعتقل وأعدم)
يا لمرارة المفارقة
ورعبها!
وكنت قد سمعت هذا التحذير مرات كثيرة، أحياناً بدافع الحرص والخوف وأحياناً لجس النبض وأحياناً للتخويف وللإيقاع.
وقد تعرضت الكثير من كتاباتي وقصائدي للتغيير أو التأجيل أو الحذف. ورغم هذا فهناك الكثير منها كان يفلت في حمى اليأس والمشاكسة والتحدي والجنون.. أذكر مثلاً: مقالتي المعنونة "عن معرض الكتاب وسيارة النجدة ومايكوفسكي". ومقالتي: "عن المسدس الذي أصبح شاعراً" والتي غيّر رئيس التحرير أمير الحلو عنوانهاقبل نشرها فأصبحت "بالون". وقد نشرتها أيضاً في كتابي "مرايا لشعرها الطويل" ورغم ذلك فقد أثارت الكثير.
بل وحتى نصوص الحب في "المرايا" لم تنجو من المقصات
[في حوار مع الصائغ لصحيفة "الإعلام" العراقية - نهاية الثمانينات - يسأله المحاوران حسن جمعة ونعمة عبد الرزاق عن قصيدته الطويلة الهذيانات، لماذا لم تظهر؟ فيجيبهما: "الأسباب كثيرة أولها.. المسافة الزمنية بين أحداث الحرب وأحداث القصيدة التي مازالت متداخلة ومتقدة أما ثانياً وثالثاً ورابعاً فهي طبيعة القصيدة التي قد لا تنجو من مقص الرقيب إذا ما فكرت في نشرها في الوقت الحاضر". وحين يطلبان كلمة أخيرة في آخر الحوار، يقول: "صرختي: إن لا إبداع بلا حرية".]
هناك نصوصاً أخرى كتبتها في الداخل ولم أقدمها للنشر أصلاً. وهناك مقاطع كثيرة حذفها الرقيب من دواويني المنشورة وأعدت نشرها في المنفى في دواويني الجديدة.
وهناك نصوص فقدت مني للأبد.
في الصفحة الأخيرة من ديواني "غيمة الصمغ" عام 1993 فقرة تقول:
"له تحت الطبع":
1- تكوينات (نصوص)
2-هذيانات داخل جمجمة زرقاء لا علاقة لعدنان الصائغ بها (قصيدة طويلة)
3- أوراق مفقودة من ملف ميثم التمار (نص طويل)
4- يوميات الرصاص المر (نصوص نثرية)
والأن:
التكوينات طبعتها في بيروت عام 1996، وطبعت الهذيانات أيضاً في العام نفسه..
أما "يوميات الرصاص المر" و"أوراق مفقودة من ملف ميثم التمار" فقد فقدا مني
ولم أجدهما حتى اليوم.
بعد أن انجلى الغبار الذي أثاره البعض إثر نيلك جائزة الشعر العالمية في هولندا عام 1997. ما حقيقة ما حدث من جدل وصراع؟
- لم يكن جدلاً أو صراعاً شعرياً، بل إرهاب وسيلٌ مشبوه من البيانات والشتائم والافتراءات تخلو من الشرف أحياناً، وتراشقٌ مكثفٌ بالفاكسات (قبل انتشار الانترنيت)، أنهال كلّهُ علي دفعة واحدة.
حدث ذلك بعد فوزي بجائزة الشعر العالمية في هولندا مباشرة!
لماذا هذه التهم؟ وأين كانت؟ ومن كان وراء تلفيقها واطلاقها؟
الآن حين أتذكر ما حدث؟ أتعجب كيف انخبصت الساحة الثقافية والسياسية بالبيانات، وكيف انطلى الأمر على البعض. دون أن يكلف أحد نفسه أو تكلف جمعية نفسها أو جماعة أو تيار ثقافي أو سياسي أو قوة وطنية، في البحث أو التفكير أو حتى سؤالي عن حقيقة الأمر؟ ومن كان وراءه؟ ولماذا حدث كل ذلك؟ ومن دبج البيانات ووزعها؟
لاحظ معي: قد يقول قائل أن ما حدث لي كان بسبب ما أشيع عن كوني شاعراً أقترب أو قُرّب من خطاب النظام ومؤسسات الثقافية؟
(سأترك مجادلته الآن بخلل هذا الطرح وخطله وقد بينته سابقاً) وأقول له: طيب، أنا خرجت عام 1993 ونشرت صحف المعارضة عن خروجي. وأصدرت ديواني " تحت سماء غريبة" في لندن عام 1994 بتقديم الشاعر المعروف سعدي يوسف، ونشرت الصحف الكثير عنه أيضاً، ثم انتقلتُ الى بيروت وأصدرتُ نشيد أوروك، والخ.. فلماذا إذن لم يثر أحد مثل هذا الأمر إلا في عام 1997. وأسأله: لو خرج الآن أي شاعر مقرب أو مقترب – كما يدعون – من النظام أو مؤسساته، وأخترْ من تشاء.. هل تحتاج فترة أربع سنوات لتكتشف أنه كان مع النظام؟.. أم أنك سوف تعرفه بنفس الساعة أو اليوم أو الشهر أو السنة أو الدقيقة؟
قد يستمر القائل بالقول: أن ما حدث كان بسبب الجائزة العالمية، غيرةً أو حسداً أو عدم اقتناع.
وأعود للقول: طيب، ولكنني نلتُ قبلها جائزة عالمية أخرى عام 1996 في نيويورك، هي جائزة هيلمان هاميت للإبداع وحرية الكلمة، وقد نشرتها أغلب صحف ومجلات المعارضة العراقية، وأغلب الوكالات والصحف في البلدان العربية والغربية، وأجريت معي العديد من المقابلات، ولم أقرأ رأياً أو قولاً ضد نيلي الجائزة، ولم تصلني إلا كلمات الود والتهاني والتشجيع، من الكثير من الأدباء العراقيين والعرب.
ترى لماذا لم يثر أحدٌ بياناً واحداً ضدي إذا كنت كذلك!؟
لماذا انخبصت الدنيا عليّ عام 1997 بالتحديد، بعد حصولي على جائزة الشعر في هولندا!؟
وما الذي تراه أنت وقد انكشفت الآن جميع الخيوط أو أغلبها؟
- تصور أن "سبع جمعيات" اسلامية وتقدمية ورجعية ويسارية ويمينية وشمالية وجنوبية.. و.. و.. اتحدت – ولأول مرة في تأريخها- على مهاجمتي ببيان طويل عريض، رغم عجزها في التوحد ليوم واحد من أجـل إصدار بيان موحد للتضامن مع العراقيين اللاجئين الذين
غرقوا في بحر إيجة وقتذاك.
بل أن إحدى المجلات المعروفة وكانت قد أخذت مني قصائد ونشرتها ثم حين وصلتها البيانات وكان العدد جاهزاً وعلى وشك التوزيع، عمدت إلى قص قصائدي ودس قصاصة اعتذار للقراء لنشرها تلك النصوص، وقد نشرت صحيفة "الحياة" إشارة استغرابية لتلك القضية في عددها يوم 8/10/1997 منوّهة إلى غياب الصفحتين 85 و 86 من المجلة، وإلى القصاصة المدسوسة التي تقول: "أثناء غياب رئيس التحرير نشرت سهواً من ملف المرفوضات، قصائد لعدنان الصائغ تحت عنوان "تكوينات"، لذا اقتضى التنويه والاعتذار لقراء المجلة وأصدقائها"..
وقد علمت أن رئيس التحرير سارع إلى قص القصائد، بعد أن وصله البيان سيء الصيت، مباشرة. فبعثت له برسالة طويلة ومهذبة، قلت في مقدمتها: (أثارت قصيدتي المنشورة لديكم في العدد والتي تم أنتزاعها من المجلة تساؤلاً لدى الأخرين وشجوناً كثيرة في نفسي ولم أكن لأعترض لو كان الامر قد جرى في داخل العراق فقد تعودنا عليه.. ولم يعد بالأمر الغريب هناك أن تُقص قصائد أو أعناق لمجرد الظن أو الوشاية أو التهمة. لكن الغريب والخطير أن يحدث هذا خارج أسوار الدكتاتورية التي نحلم جميعاً بأن نكون خارجها بالفعل وأن نستنشق ولو لمرة واحدة في حياتنا هواء الحرية وأن نكفَّ عن الأعدام بالتهمة.
وكان من العدل والمنطق والحق والانصاف أن تستمع لشهادتي لمعرفة أن كنتُ ظالماً أم مظلوماً قبل أن تختلف أو تتفق معي ومن المعروف قديماً كما تعرف أنه لا يجوز الحكم لصالح من أشتكى لك فقء أحدى عينيه فلربما جاءك خصمه وقد فُقئت كلتا عينيه)...الخ، موضحاً له في الرسالة الكثير من النقاط المهمة والحقائق وأسباب تلك الافتراءات التي تعرضت لها.
لكني لم أتلق جواباً..
وراحت إحدى الصحف تحجب أسـمي حتى لو ورد ضمن خبر أمسية مشتركة مع شعراء وأدباء آخرين.
وعمدت إحدى الجمعيات إلى تمزيق إعلانات الأمسية التي أرادت أن تقيمها لي. وغير ذلك الكثير.
وكل هؤلاء وغيرهم انقادوا للأسف رغم عراقة تأريخ بعضهم لهذه البيانات دون تدقيق أو دون وعي ودون ضمير أخلاقي ووطني.
بل دون أن يعرفوا ما القصة؟ وماهي هذه الجمعيات صاحبة البيان ومن هي الأسماء التي تقف خلفها؟ وهل هي حقيفية أم لا؟
لقد كانت هذه الجمعيات الوهمية ستاراً لبعضٍ من الأدباء الفاشلين
والسيئين وبعض المشبوهين. وقد رددت عليهم بمقالة تحت عنوان "الجمعيات المرحة.. وذباب الاشاعات" نشرتها صحيفة المجرشة 1/10/1997 وبعض الصحف، وقد عرّيتُ فيها أفتراءاتهم المشبوهة واحدة واحدة، وأشرتُ إلى ما عانينا من تقاريرهم وكتاباتهم الانتهازية ومن تصرفاتهم المشينة هناك داخل الوطن وما نعانيه من سمومهم هنا، دون أن أتلقى رداً على مقالتي تلك أو تكذيباً أو...
لقد تلوثوا بأنفسهم هناك، وأرادوا تلويث الجميع هنا. ليتستروا على تصرفاتهم ونصوصهم ومواقفهم
[يمكن الإشارة الى أن من بين أبرز الذين أثاروا البيانات وروجوا تلك الإشاعات هم من عملوا ومدحوا النظام بقصائدهم الجنجلوتية ورقصوا بكلماتهم في أعياد "ميلاده الميمون" على صفحات الجرائد، مطالبين "أن تتنفس قصائدنا أريج الميلاد". كما عبر أحدهم واصفاً شمس الرئيس "صدام حسين" في قصيدة مهداة له، بأنها ساطعة وشموسنا رماد. والآخر يصفه الأصدقاء في الداخل بأنه "شاعر المراثي" كما ذكر أحد الشعراء العراقيين المقيم في دمشق، فقد رثى وزير الدفاع عدنان خير الله طلفاح ورثى ميشيل عفلق ورثى "صبحة" أم صدام حسين، والآخر أشار له السكرتير الشخصي لعدي خلال عشرين عاماً في حوار نشرته صحيفتا "الحياة" و"بغداد" 9/10/1998 واصفاً أياه بأنه كان أحد المساعدين لعدي. والآخر عمل في صحيفة بابل لسنوات طويلة وغير ذلك. وأشير أيضاً إلى أن أحد الذين كانوا يوزعون البيانات هنا في مدينة مالمو السويدية ظهر مؤخراً في التلفزيون العراقي يعانق رموز النظام في ندوة المغتربين..]
هؤلاء هم خصومي!!
فتخيل المشهد!!)
ولن أذكر أسماءهم!
إن غاية ما يحلمون به أن يكون لهم مجرد أسم متداول، حتى ولو بشتيمة أو فضيحة!!!
إنهم بلا مواهب حقيقية.. ولا أقول شيئاً آخر..
وقد أشرت إليهم في قصيدة لي بعنوان "إليهم فقط":
["كمْ أضاعوا من وقتٍ وورقٍ وأرصفةٍ/ أولئك الذين شتموني في المهرجاناتِ/ والمراحيضِ/ والصحفِ/ أولئك الذين لاحقوني بتقاريرهم السريةِ/ من حانةٍ إلى قصيدةٍ/ ومن وطنٍ إلى منفى/ أولئك/ كمْ أرثي لهم الآن/ حياتَهم الخاويةَ/ إلى حدِّ أنهم لمْ يتركوا منها شيئاً/ سواي"..
- من ديوان" تأبط منفى" 2001/ السويد –]
وإذ ألفت الإنتباه إلى هذه التفاصيل، فلكي ترى حقيقة صراع بعضهم معي بوضوح وما وراؤه ولكي لا يتعرض أديب أو انسان آخر لما تعرضت له. هذا الصراع البسيط، كيف استغتل وتحول إلى حملة شعواء أثناء المهرجان. شارك فيها طرفان ذكرتهما في قصيدة قصيرة لي:
["الفاشيون
والشعراء المخصيون
يقفون..
على طرفي حبلٍ،
معقودٍ
في عنقي
ويشدون"
- المصدر السابق-]
لستُ الأول من تعرض لمثل هذا الأمر ولن أكون الأخير..
لكن ينبغي علينا كمثقفين الوقوف بوجه هذه الممارسات الرخيصة لكي لا تستمر الاساءة إلى الآخرين.
إن هناك دوائر وشعباً كثيرة في مديريات أمن السلطة ظهرت بكثافة أثناء الحرب العراقية الإيرانية وبعدها، وقبلها بالتأكيد، يعرفها أغلب العراقيين. وهي دوائر سوداء لبث الاشاعات والتشويشات والنكت في قطاعات الشعب وغير ذلك، لتمرير ما تريد تمريره ويبدو أن بعض أجهزتها قد انتشرت في ساحات أخرى كالثقافة والفكر فبدأت في المسخ والتشويه للأسماء والمواقف
وقد حدث هذا الشيء مع أسماء مهمة ونظيفة كثيرة في هذا المجال أو ذاك.
وخذ ما جرى للشهيد محمد صادق الصدر من تشويه جعل حتى المراجع الدينية تركب الموجة التي روج لها النظام الذي عانت منه طويلاً دون أن تدقق أو تتفحص تلك الاشاعات ومواقف الرجل وأفكاره، والخ وهناك حادثة وقعت لكاتب مسرحي معروف أثارت مسرحيته التي عرضها في الأردن منتصف التسعينات هتماماً واسعاً من قبل العراقيين والأردنيين لجرأتها وحساسية الموضوع الذي تطرحه: رجل ينتظر رجال الليل، فيتخيل كل صوت أو حركة هي أصوات طرقاتهم على بابه . يبقى الليل كله، يسكر، ويهذي، وينتظر و..و... (في اليوم التالي، ورداً على الصدى الذي حققته جرأة المسرحية، انتشرت اشاعة صغيرة بدأت تكبر وتكبر فأجهزت على المسرحية. ومفادها أن عدي هو الذي أعطاهم الضوء الأخضر لتقديمها بهذا الشكل. وحين التقيت أحد الفنانين العاملين فيها، كاد أن يلطم على رأسه وهو يشرح معاناتهم الكبيرة حتى حصول الموافقة على سفرهم والمشاركة في المهرجان.
وشاعر آخر بعد أن أثير الاهتمام حوله في مهرجان جرش واعلان مجلة "ابداع " المصرية ع6 يونيو 1995 تضامنها وكذلك العديد من الأدباء العرب بسبب منع كتابه الأخير في العراق والتهديات التي تلقاها بسبب مواقفه وكتاباته المناهظة للنظام، دعت السفارة العراقية في عمان مجموعة من الأدباء العرب وبينما هم يتحدثون في غرفة الملحق الثقافي رنَّ جرس التليفون فرفع السماعة أحد الموظفين ثم خاطب الملحق قائلا: أن الشاعر "..." على الخط. أخذ الملحق يتحدث بحميمية، وبصوت خفيض ومهموس أحياناً، موحياً للحاضرين بأنه يتكلم مع الشاعر. وحين انتهت المكالمة تعجب الحاضرون: أليس هذا الشاعر معارضاً لكم؟ لم يجبهم وإنما اكتفى برسم ابتسامة غامضة، كانت كافية لبث الكثير من التقولات والاشاعات..
هذا الشاعر كان أنا!!
وأتذكر أنه حينما أعتقل الصديق الكاتب ضرغام هاشم عام 1991 دعتنا إحدى الصديقات الصحفيات للتجمع والوقوف أمام مبنى نقابة الصحفيين بانتظام وتقديم عريضة التماس رقيقة للاستفسار "المهذب" عن صديقنا الصحفي (وكانت النقابة قد شكلت لجنة أسمتها "لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين"). بعد أقل من ساعة انسللنا بهدوء مهذب أيضاً مع عريضتنا المهذبة. كيف حدث ذلك؟ لقد جاء أحدهم "ناصحاً" مشيراً لصديقتنا أن تنسحب بهدوء وتسحب معها هؤلاء "الزعاطيط"، وإلاّ فسيتم مهاجمة شقتها من قبل شرطة الآداب لإلقاء القبض عليها بتهمة الدعارة، ليتم عرضها مع أثنين من "زبائنها" على شاشة التلفزيون هذا المساء، أما هؤلاء " الزعاطيط المخابيل" – أي نحن - فلكل حسابه"، وكنا قد رأينا حسابهم بعد الانتفاضة.
من جانب آخر أتساءل هنا!
وسيبقى هذا التساؤل قائماً ومؤلماً وملتهباً:
إن نصوصي ومواقفي وسيرتي وأفكاري يعرفها الكثير من الأدباء والفنانين والمثقفين، الذين قاسموني فتات الخبز والكتابة والهلع، سواءً في الوطن أو المنفى..
لماذا لم يتصد أحد لهذه الافتراءات التي أريد بها الاساءة لي ولواقع الثقافة العراقية في الداخل؟ لماذا سكتوا؟..هل هم يجهلون ذلك؟ أم هو الخوف؟ أم الخواء الذي نعيشه؟ أم هو الإرهاب الخفي الذي يمارسه بعض الأدباء والسياسيين العاطلين عن العمل لاسكات الجميع وصرف أنظارهم عما يجري؟
أصفن الآن وأتساءل بحزن:
لماذا سكت "البعض" من أبناء جيلي، الذين عايشوني نبضاً نبضاً ودمعة دمعة، وقصيدة قصيدة؟
هل ضنوا بقول كلمة حق وسط عجاجة الغبار والسهام؟
هل خافوا أن يمسهم بعض ذلك الرذاذ؟
أين ضمير الكاتب اذن؟
لقد عمل معي وشارك في نشاطات المنتدى ومجلته، العشرات من الادباء، وأغلبهم خارج الوطن الآن.. وقد قدمنا بالاضافة إلى ذلك الكثير من النشاطات والأماسي الأدبية. في محاولة لتحقيق انجازات ثقافية لافتة وصافية وسط الضجيج، رغم الامكانيات الشحيحة.
لكن الغريب والمؤلم هو سكوت الكثيرين ممن يعرفون طبيعة المنتدى واختلافه الجذري والاداري والثقافي عن وضع منتدى لؤي حقي الخاص، الذي كان تابعاً للرئاسة والذي كان يؤجر الطائرات ويقيم المهرجانات الضخمة. بينما لم يكن منتدانا يملك أجرة دعوة شاعر واستضافته بعد أن قطعت الوزارة عنا حتى الإمكانيات البسيطة.
والغريب والمؤسف أيضاً أن البعض ممن رشح نفسه لرئاسة المنتدى. وممن كان يتدافع أو يتصارع وزملائه على رئاسة لجنة أو تقديم أمسية أو نشر مادة له أو عنه في المجلة. لكن حين هاجم أحدهم المنتدى واصفاً إياه - على صفحات جريدة الوفاق - بأنه ورشة لغسل الأدمغة تابعة لطارق عزيز، لاذوا بصمتهم واختبأوا في جحورهم، وهم يعرفون جيداً وقبل غيرهم أن لا علاقة للمنتدى بطارق عزيز ولا عدي ولا بورش الغسل والتشحيم، بل العكس كانت أماسي المنتدى في أحيان كثيرة تشاكس وتثير.
وأستغرب أكثر: لماذا أنساق البعض إلى تلك الحملة الشعواء وركب
الموجة؟ من أجل ماذا؟ أمن أجل الجائزة؟ يا لصغر النفوس! ويا!! ويا لسذاجة المآل!!!
إن ما كتبه النقاد والشعراء عن تجربتي عرباً وعراقيين وأجانب، وقبل ذلك محبة الناس والأصدقاء والقراء، وقبل ذلك: لذة الشعر.. تفوق وتفوق وتفوق كل جوائز الدنيا.
وأعود لأتساءل من جديد وبمرارة:
من فعل كل ذلك؟ ولماذا؟
بعض "الأصدقاء"!؟
(ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بُدُّ)
– كما يقول المتنبي-
الحسد!؟
(ماذا لقيت من الدنيا وأعجبني أني بما أنا شاكٍ منه محسودُ)
- على حد تعبيره أيضاً -
الغيرة!؟..
(إني وأن لمتُ حاسِديّ فما أُنكر أني عقوبةٌ لهمُ)
- على حد قوله المتشفي أيضاً -
التناقس!؟ الأحقاد؟.. العجز؟ الغرور؟.. والخ، والخ..
أنا أفهم كل هذه الصراعات والطموحات والحساسيات الأدبية، وأقدرها. ولن أزعل منها، مهما كانت حدتها. وقد ذكرتُ في أكثر من حوار: "لست الشاعر الأول ولا الأخير في بلد عدد شعرائه يضاهي عدد نخيله"..
كان يمكنهم القول ما شاؤوا في شعري وفي استحقاقي الجائزة أوعدمه ولن أزعل، فلكلٍ رأيه وتصوره وذائقته النقدية والجمالية. لكن الأسلوب الذي مارسه البعض ضدي كان لا ثقافياً ولا وطنياً ولا إنسانياً ، سامحهم الله وقلبي..
واذا كنتُ قد أخذتُ ذلك التنافس والغيرة بحسن نية، فكيف يمكنني أن أفهم من راح يكيل التهم مستغلاً الدخان والغبار وقد ظنه يدوم طويلاً ليمرر أو يبرر أخطاءه أمام البعض أو يصفي حسابات مضحكة مع البعض، لا ناقة لي فيها ولا جمل.
وكيف يمكنني أن أفهم كيف اشتبكت الأوراق واختلطت بشكل عجيب وسريع ومدروس ومدسوس وعفوي و.. و.. وكيف انتشرت ووصلت أكداس البيانات التي وزعوها إلى مختلف بلدان العالم وأصقاع المنافي والجمعيات والصحف والأسواق والمساجد والبارات والكراجات. نعم. حتى الكراجات.
أتركُ السؤال مفتوحاً على مصراعيه لكل الاحتمالات، والإجابات، غير أنني لا يمكن إلا أن أشير إلى تزامن حملة البيانات المشبوهة مع توقيت رسالتي الخاصة التي وجهتها الى البروفسور أ.ج. فان فيرستاي رئيس منظمة الشعر العالمية أثناء حضوري المهرجان في هولندا عام 1997 والتي تحدثتُ فيها عما يجري للمثقفين العراقيين داخل العراق وما يتعرضون له من قمع وإذلال وتصفيات ومصادرة حريات. وكانت تضم أسماءً وتواريخَ وأحداث، وكذلك عن وضع الأدباء والمثقفين في المنفى وما يتعرضون له من ملاحقات مستمرة بسبب كتاباتهم. وقد نشرت إحدى صحف المعارضة مضمون تلك الرسالة فأثار ذلك غضب النظام العراقي وأعوانه، فجند أبواقه ومرتزقته لملاحقتي والإساءة لي وكذلك للتشويش على المهرجان، معتمداً أيضاً على بعض الأدباء الفاشلين الذين أعمى الحقد والحسد والفشل قلوبهم وعيونهم وأفكارهم، فهالهم وأغاضهم أن يفوز شاعر جديد قَدِمَ من العراق تواً بجائزتين عالميتين، وأن يعد البعض نشيده أطول قصيدة وأطول هجاء للدكتاتورية. وهم في مقاهي المنفى منذ سنين طويلة يتلهون باصطياد ذباب الإشاعات..
الآن وبعد انجلاء الغبار عن تلك الحقائق وقد أدرك الكثير منهم سذاجة وتفاهة ولؤم الفخ الذي انجروا اليه ووقعوا فيه، راحوا يكتبون لي رسائل محبة واعتذارات خجولة. وتشجيع..
وقد فتحت لهم نوافذ قلبي جميعها
مؤمناً أن الصداقة والنص والوطن والحياة والذكريات هي أسمى وأبقى من الصغائر التي يعيش فيها وعليها الصغار دائماً، في كل مكان وفي كل مراحل تأريخ الحياة والإبداع.
إن ما مر لن ينسيني أبداً المواقف الرائعة للكثير من الأصدقاء والأدباء والمثقفين والمناضلين والقراء، محيياً بإكبار واعتزاز جميع تلك الأصوات الشريفة والأقلام المبدعة العراقية والعربية والعالمية... ولن أنسى ما حييت تفهمهم العالي ومحبتهم الغالية التي هي زادي وسندي في هذا الطريق الصعب.
أمام هذا الذي ذكرت، ما الذي أثاروه في بياناتهم التي صدرت ضدك في الخارج؟
- كانت أكثر من أن تُعد وتحصى (وكلها موثقة عندي) وهي تريك محاولات النظام وقوى الظلام في ارهاب المثقفين لغرض اسكاتهم.. لكنني لم، ولن ولن ولن أسكت..
وقد تحديتهم جميعاً - منذ عام 1997 - على صفحات الجرائد وفي الندوات والأماسي الثقافية الكثيرة التي أُقيمت لي، أن يثبتوا حرفاً واحدة من تلك التلفيقات والاشاعات الغبية المبتذلة البائسة.
وهذه الافتراءات متنوعة بشكل غريب ومدروس ومثير، ولو جُمعت لكانت تصلح أن تكون كتاباً هائلاً عن الإرهاب الفكري وفنون التشويه والاشاعات يمكن أن تقتل قبيلة من الشعراء، وليس شاعراً واحداً..
فمثلاً أشاعوا أنني كنت جنرالاً في الجيش العراقي، ثم ضابطاً كبيراً في دائرة التوجيه السياسي (وقد أطلق فنان الكاركتير علي المندولاي – وكنا جنوداً نعمل في مجلة حراس الوطن - ضحكته المجلجلة قائلاً: لقد جعلوا من الصائغ جنرالاً وهو جندي احتياط، فماذا سيقولون عني لو حصلت على جائزة عالمية وقد كنتُ نائب عريف!!!!)، ثم أن منتدى الأدباء الشباب في الفترة التي أدرته كانت مهمته غسل أدمغة الأدباء، وأنه كان تابعاً لمكتب طارق عزيز الذي كنت أتعشى وأتمشى معه، وأنني كنتُ مداحاً للرئيس في كل دواويني وكتاباتي، وأنني كنت أسير في شوارع بغداد حاملاً مسدساً، وأنني كنت أسكن قصور صدام الخاصة جداً (واستمرأ اللعبة أحد الشعراء العرب فكتب في إحدى الصحف الخليجية 4/9/1997 أنني كنت أسكن في قصر منيف لحزب الله في بيروت. وعندما غادرته إلى أوربا شتمتهم، وأنني خدعت أحد الأحزاب فاشتروا مني نسخاً من كتابي" نشيد أوروك" وأمدوني بالمال وعينوني محرراً صحافياً لديهم).
وقالوا في بياناتهم أنني أنادي بالتطبيع مع العدو الصهيوني (وقد أجرى معي القاص والروائي محمود سعيد حواراً في أحدى الصحف الخليجية، عام 1997 على ضوء بعض ما سمعه وقد شتمت فيه التطبيع والمطبعين وكل الاسرائيليين).
ثم أن ديل شتويل - مقرر حقوق الانسان في الامم المتحدة والمسؤول عن الملف العراقي الذي يضم 16 ألف إنسان مفقود في أقبية النظام ـ قد جاء الى عمان عام 1996 ليلتقي بي وبأثنين من الأدباء العراقيين فقط، ثم ليرشحني للجائزة (كنت حينها في بيروت!! ولم ألتقِ به ولم أره حتى هذه اللحظة.
تصوّرْ! منظمة دولية مهمة تقطع البحار والوديان والأقطار لتلتقي باثنين فقط وتقفل راجعة!!).
وأن لجنة الجائزة عملت لي تمثالاً في إحدى ساحات هولندا لأني شتمت القرآن الكريم!!! والخ.. والخ..
وأنا كما قلت سابقاً وكما يعرف الكثيرون لم أسكن في قصر أو بيت أو حتي في مطبخ أو حمام لحزب الله أو لصدام أو لغيره، ولم يمدني أحد بدرهم. ولم أحمل في كل حياتي مسدساً أو رشاشاً أو قاذفة.
ولم أمدح حاكماً أو حكومة أو حزباً بسطر واحد، ولم أعمل في خدمة النظام يوماً واحداً ولم أكن منتمياً لأي حزب. ولم أكن طيلة فترتي الخدمة العسكرية الالزامية سوى جندي بائس بكل معنى الكلمة..
ولم أتمشى أو أتعشى أو أتغدى أو ألتقي أو أجلس – حتى ولا دقيقة واحدة - مع طارق عزيز ولا مع أي مسؤول آخر غيره.
أقول ذلك قاطعاً السبيل لمن سيأتي بعد سنوات ليقول أنني كنت أتمشى مع مزبان أو وطبان أو مشعان أو روكان أو بطيحان!!
وقام بعضهم بتحريض الشاعر اللبناني الصديق عباس بيضون، فانساق مع اللعبة للأسف دون أن يدري ما القصة. وكتب مقالة في "صحيفة السفير" 22/8/1997 مستنداً به على بيانهم المشبوه.
وقد رددت عليه برسالة مفتوحة نشرت في "السفير" 26/9/1997 حيث يعمل، قلت فيها: "قلْ ما تشاء في شعري وفي استحقاقي للجائزة من عدمه ولن أحزن أو أعتب أو أزعل. فذلك رأيك، ولكن أن تطعن في وطنيتي ومبادئي فذلك ما لن أسكت عنه أبداً.. وما بيننا قراء الأمة وشعراؤها من المحيط الى الخليج شهوداً وحكاماً ومتفرجين". ثم وضحتُ له وللقراء كل المغالطات وسبب تلك الحملة والبيان ومن كان وراءه. بعد سنوات التقينا في كوبنهاكن 2001 وفي بيروت 2002 وكشف لي متأسفاً عما نقله له بعض الأصدقاء من افتراءات وانتهى الأمر.. والخ..
[بعد 6 سنوات من تلك الحكاية، قامت مجلة "عيون" التي يصدرها خالد المعالي في ألمانيا بإعادة نشر مقالة بيضون السالفة الذكر، في عددها الجديد دون تبيان سبب هذه الفعلة، ودون ذكر أو نشر رد الصائغ، وقد رد الشاعر بيضون بمسؤولية وأخلاق ووعي عالٍ على هذه الحادثة الغريبة والمريبة في مقال له نُشر في صحيفة السفير 2003/02/21 يقول فيه: مجلة عيون أعادت نشر مقالة لي بعنوان قضية "عدنان الصائغ" ظهرت في "السفير" من ست سنوات كاملة غير منقوصة. وأنا بادئ بدء أصرح بأنه لم يستأذني او يستشرني في نشرها أحد، ولو فعلوا لما أذنت ولا قبلت قطعا. أصرح بأن نشرها توريط لي في موقف لا أريده ولا أرتضيه لنفسي. ليس بيني وبين عدنان الصائغ حرب ولا خصومة ولا حزازة، وقد قلت كلمة فيه منذ 6 سنوات رد عليها فنشرت رده وانتهى الأمر عند هذا الحد. ولنقل انني شديد الأسف لما حصل وكان أجدى بمن فعلوه أن يفعلوه على حسابهم لا على حسابي، وأن لا يزجوا باسمي في مسألة لا يتحملها ضميري. في عملية لا أدري ماهيتها وفحواها. أعلم فقط أن الذي أيقظ "عيون" على مقالة ذهب خبرها وأوانها وتراكمت عليها 6 سنوات كاملة ليس سليم الغرض ولا النية".. "من المحزن أن يكون هذا مآل مقالي المسكين. العفو كل العفو والعذر كل العذر لما جنته يداي عن غير قصد ولما طاش إليه مقالي التعيس المنسي من دون نية ولا غرض". – الناشر –]
كتبت في العراق مقالاً أثار ردوداً كثيرة أسميته "احذروا الادباء الفاشلين" وأعدت نشره في أحدى المجلات الصادرة في الخارج مع اضافات جديدة، مالذي قصدت به؟..
- علمتني التجارب أن لا مشكلة لك أبداً مع المثقف المبدع المبدئي والكبير نتاجاً وشخصاً وسلوكاً وعلاقات ومواقف. هنا أو هناك. وفي كل مراحل التأريخ والشعوب والأحزاب والجمعيات والصحف والثقافات والايديولوجيات والعلاقات. المشكلة كلها تنحصر في هؤلاء الفاشلين، القصار في نتاجاتهم ونفوسهم ومواقفهم. هؤلاء الذين عانينا كثيراً منهم في الداخل ووجدناهم أمامنا أيضاً في الخارج، هم أكثر زعيقاً وادعاءات كالعربات الفارغة، ولا ضير ما دام الأمر لا يتعدى الضجيج ، لكن الخطورة حين يتحولون الى أدوات تمارس الارهاب الفكري على المثقفين، بوسائل شتى لا تقل عن ممارسات السلطة نفسها، منها المصادرة والتشويش والتشويه وغير ذلك. وهم لا يقرأون ولا يكتبون ولا يعملون مكرسين كل وقتهم لمحاربة الابداع. متشدقين بالتنظيرات والادعاءات والبطولات الفارغة.
ما أريد قوله هناً: كفى نهشاً في جسد العراق المثخن بجراحاته، وكفى الإساءة الى مبدعيه وناسه. فبعد ثلاثين عاماً من العيش تحت بسطال الدكتاتورية. وبعد مئات الصرخات والثورات والانتفاضات المجهضة ماذا تريدون من أدباء الداخل أكثر مما هم فيه؟
وحدوا وكثفوا جهودكم لإنقاذهم ومساعدتهم بدلاً من الشتائم والتشدق البطر في المنافي: هذا كتب وذاك صفق وتلك غنت وذا مثل وذي رسمت!
وأقول أيضاً: عيشوا بدلا منهم هناك، وأروهم بطولاتكم.
لقد أرادت السلطة أن يكون العراق زياً موحداً، لكنها لم تستطع والغريب أنني لاحظت أن أغلب الذين لبسوا هذا الزي أو رضوا به قديماً وحديثاً بهذا الشكل أو ذاك هم أكثر المطالبين بإحراق المبدعين العراقيين وإحراق الثقافة وأكثرهم سعياً لتشويه الجميع.
من جانب آخر، وبعيدا عن هؤلاء، أشير إلى تلك الازدواجية التي يحملها البعض هنا. لقد رأيت بعض الأدباء في بلدان الحرية والقوانين، يعيب على محمد خضير وعدنان الصائغ و عبد الخالق الركابي وغيرهم من أدباء الداخل بأنهم لم يدينوا الحرب والدكتاتورية بشكل واضح وصريح! وهو لا يستطيع رفع صوت احتجاجه علناً أمام رئيس جمعية في المنفى.
ورأيت بعضهم ينتقد هذا الأديب أو الفنان لأنه عمل في مؤسسات الدولة (التي يعيش تحت سلطتها مجبراً)، بينما هو في البلدان الأخرى ( وبكامل حريته) يتمسح بأذيال هذا الديناصور أو ذاك، هذه المؤسسة أو تلك.
ورأيت بعضاً ممن خبص الدنيا خبصاً بنضاله وصموده ومواقفه من المؤسسة والدكتاتورية ولكن، سنراه يجند نفسه وقلمه بوقاً داوياً لنظام قمعي آخر في بلد آخر، أو يبيع تأريخه ونصوصه وحزبه لتلك المؤسسة المشبوهة لأنها تدفع أكثر.. (فإذا كان لبعض الذين مدحوا النظام في الداخل قليل من العذر والمبررات، تحت ظروف القمع الوحشي. فأي عذر لمن خرج من الكابوس إلى فضاءات الحرية الرحبة وراح يشعل بخور المديح والإذعان لدكتاتور البلد الآخر مدبجاً له قصائد المديح ومقالات التسبيح)
ورأيتُ بعضاً من دعاة التحرر ومقارعة الإمبريالية ظلوا ينظّرون ســـنوات وما أن فتحت لهم الإمبريالية ذراعيها ومحفظتها حتى
ارتموا في أحضانها ورأيناهم يهرولون إليها. (هذه النفوس الشاحبة لا تنسينا المبادئ الصلبة والدماء المقدسة التي سكبت هنا وهناك من أجل المبادئ والكلمة الحرة، فلم يزحزح أصحابها المال ولا السياط قيد أنملة).
الادعاءات عجيبة وغريبة ومتنوعة، وما أكثرها في زمن المتاجرات.
تعال انظر أيضاً: بعضهم كان ينشر في بريد القراء أو ترفض مقالاته أو تعدّل لأخطائها النحوية والأسلوبية لا لشيء آخر، لكنه حين وصل إلى المنفى، راح يدعي أنه كان يرفض النشر في الصحف الرسمية، وأنهم كانوا يغيّرون أو يمنعون كتاباته، والأمثلة كثيرة (لا أتجاهل أو أنسى السياسة الثقافية وممارساتها القمعية لكن حالة صاحبنا لا علاقة لها أبداً بذلك).
وبعضهم لم يكن اسماً معروفاً في العراق ولم ينشر شيئاً ذات قيمة، ولم يقم سوى أمسية أو أمسيتين بائستين لكنه حين وصل المنفى راح يصرّح بأنه كان يرفض المشاركة في مهرجانات اتحادات الأدباء والمربد رغم التوسلات والتهديدات والدعوات المتكررة له.
(أجد من المهم القول بأن هناك بعضاً من الأدباء المبدعين كانوا زاهدين فعلاً بالنشر والمهرجانات. لا يشاركون فيها).. والخ
لكن بعضهم كان يدعي الزهد لكنه لم يترك فرصة إلا وزحف اليها زحفاً.
وغير ذلك الكثير من البالونات الكاذبة التي لا يلجأ إليها من كان واثقاً من نفسه ونصه وموقفه.
ما أسهل وأكذب الادعاء هنا.
وما أصعب وأصدق الموقف هناك.
لقد سيطر هاجس الخوف والتبرير على أغلب الخارجين الجدد من الوطن بعد التسعينات وحتى الآن. وأصبح أحدهم رغم سلامة موقفه وكتاباته يخاف ويخفي حتى قصائده وأرشيفه وذكرياته الحبيبة العادية في سوق السراي وحانات أبي نؤاس واتحاد ومنتدى الأدباء ومقهى حسن عجمي، لأن بعض تجار المعارضة يرى فيها ربطاً بالنظام.
لقد أرعبوا الجميع يا صديقي
تعال لنسأل: لِمَ هذا الخوف؟ مادمت لم تعمل ما يخالف ضميرك..
أنت كتبتَ ونشرتَ قصيدة أو قصة أو مقالة في جريدة الجمهورية أو القادسية أو مجلة الأقلام. لماذا تخفيها؟ هل هناك صحيفة مستقلة أو معارضة أو غير حكومية في البلد يمكنك أن تتجه إليها؟ هل كان لك خيار آخر؟ طيب. لماذا التوجس إذن؟ شاعر آخر يقول أنا كنت مصححاً في جريدة. طيب. وإذا كنت محرراً؟ ماذا يحدث؟ وآخر قالوا أنه شُوهد في مسيرة طلابية. هل مشى بملء إرادته؟.. وآخر،
وآخر فاز بجائزة – في المنفى - خبّأ رأسه متلفتاً يمينا ويساراً..
لقد رحلت السبعينات ورحل معها المثقفون ورحلت الأحزاب بكل ثقلها ورحلت القوى الأخرى، وتحول الوطن إلى ساحة للموت والحزب الواحد والقائد الأوحد، فما الذي يفعله الذين جاءوا في الثمانينات والتسعينات، وليس لهم ناقة ولا حزب….
لنفرق ويجب أن نفرق بين الكتابة السلطوية والكتابة الحرة، بين الكتابات المطلسمة التي لا تقول شيئاً وبين الكتابات التي تقول وتثير وتشاكس وتجرح، بين مثقف السلطة والمثقف المستقل، محرراً أو مصححاً، أديباّ أو فناناً. لنفرق بين الموظف العام وبين شرطي الأمن.
ومن ثم لنفرق هنا أيضاً بين الكتابة على سطح الواقع الملتهب أو على خد الحرية الناعم. فالبعض ممن خرج مبكراً من الوطن نسي أو تناسى ذلك. وفي حمى شتم الدكتاتورية راح يشتم كل أدباء الداخل. وهذه مسؤولية من خرج من مثقفينا من العراق ليوضحوا ويكتبوا.. كي لا يتم خلط الأوراق..
أن "بلداً محتلاً - كما يصفه أحد الشعراء الكبار - وشعباً مخطوفاً"، ومحاصراً ومقموعاً، كيف نتعامل معه؟. أنا الجالس الآن في السويد رغم كل معاناة الغربة والكآبة هل يحق لي أن أشير بمسطرتي على بعد آلاف الأميال إلى محمد خضير لأنه لم يدن الحرب أو إلى عيسى مهدي الصقر لأنه لم يشتم مسببيها أو عبد الزهرة زكي لأنه ظل يكتب حتى هذه الساعة في صحف السلطة أو رعد عبد القادر لأنه ألقى قصائده في اتحاد الأدباء أو لأنه أصبح رئيساً أو سكرتيراً لتحرير مجلة الطليعة الأدبية..
إنه الرعب والأنانية والموت إذن! أو أنه الغباء الثقافي والسياسي!!..
(إذا كنا نستطيع أن نعمل ونكتب بكامل حريتنا داخل الوطن فلماذا هي إذن سلطة دكتاتورية، ولماذا إذن تغربنا عن الوطن!؟)..
يا أصدقائي كونوا منصفين.. بلا جعجة ولا بطولات فارغة ولا مزايدات ولا مصالح.. هناك، قد يعتدون على عائلتك أيضاً، لا لسبب إلا لأنها عائلتك. البطولة الهادئة والحقيقية أن تقف على رجليك حراً شريفاً ولا تتزحزح.. أن تكون أنت أنت لا تغيرك الرياح والمناصب والمكاسب..أن يكون قلمك معبراً بابداع ونزاهة وصدق. ولك أن تأخذ من تلك المقولة المأثورة دلالتها في أزمنة الانحطاط: "القابض على دينه كالقابض على جمر" اقتراباً أو تطابقاً مع القابض على ابداعه ومبادئه..
وماذا عن كتاب "ثقافة العنف في العراق"؟
- لقد اطلعتُ مؤخراً على كتاب الكاتب سلام عبود "ثقافة العنف في العراق" ورأيت فيه جهداً مبذولاً، وقبل أن أبدي ملاحظاتي السريعة هنا، أجد من الانصاف القول أن هناك العديد من الجمل أنصفني بها الرجل.. وأنصف آخرين من الكتاب..
لكن هذا لا يمنعني من القول أن هناك الكثير من الأسماء الرائعة حقاً، نصوصاً ومواقف وذوات شفافة، لم تكن تستحق هذا الجلد والقسوة أبداً، زجها صديقنا عبود - سامحه الله - في كتابه، وخلطها مع أسماء أدباء السلطة والعنف..
وقام بصفها جميعاً - في كتابه - بالتساوي وكأنها صف واحد.
هذا الخلط – سواء قصد ذلك أم لم يقصد - أساء للحركة الثقافة العراقية برمتها.
وأجد من البديهيات القول أن هناك أسماء ذكر بعضها - وغفل عن ذكر بعضها الآخر- تستحق هذه القسوة في النقد فقد مارست قهراً على الأدباء وشوهت المشهد الثقافي العراقي بممارساتها وطروحاتها ونصوصها الموغلة بالدم والعنف والفاشية، ولا مأخذ لنا أبداً على ما ذكره بحقهم.
لكن تبقى المآخذ الأخرى على كتابه كثيرة - وليعذرني - ومنها أن ثمة نظرة قاصرة أو ناقصة في رؤية بعض النصوص، وتحليل خطابها المستتر، من خلال جحيم ورعب الواقع الذي كُتبت فيه - لا من خلال صقيع المنفى وحريته حيث يعيش هنا بأمان بعيداً عن كوابيس الرعب والموت - هناك "في الزمن الظالم" الذي لم نستطع الهرب منه كما فعل هو وأقرانه، حيث "يكون التعبير الفني - كما يصفه الكاتب نفسه في أبلغ وصف - ضرباً من ملاعبة الأفاعي السامة".
وإذ خصص لتجربتي الشعرية مساحة واسعة من كتابه، إلا أنني رأيته – للأسف - لم يشغلها إلا ببضعة أسطر مقتطعة من نصوصي بشكل أقرب للتشويه، صافحاً النظر عن أكثر من ثلاثة أرباعها التي ربما لم يكن قد قرأها. وحتى هذه المختارات التي انتقاها لم ينشغل بتحليلها والتوغل داخلها والتمعن بها، مكتفياً بالسطح فقط، سطحها المخادع الذي كان لابد منه لتسريب هذا الغضب العاج بين حنايا القصائد. وكنت أتمنى أن يلامس شيئاً منه، ليعطي حكمه ونتائجه بانصاف.
وكان لصديقي عبود أن يتجنب الكثير من مثل هذه المزالق لو قرأ نصوصنا بلا نيات مسبقة.. لو تأنى.. لو تفحص لو دقق لو استشار صديقاً مخلصاً له.. لو أعطاه لناقد أو أديب مطلع يراجعه له كما يعمل الكثير من الكتاب المعروفين والمرموقين وليس في ذلك انتقاصاً أو عيباً
وكان يمكن لكتابه أن يكون جهداً موفقاً لو أنه تعامل مع حيوات النص بمسؤولية وحرص وحياد، وتخلى عن مهنة استنطاق النصوص بأي وسيلة كانت، حتى ولو علقها من أقدامها بمروحة السقف كما يحدث في أي مديرية أمن في بلاد الخراب التي عذبتْ وشرّدتْ نصفَ أبنائها، وعذراً للتشيبه، لكن صدقاً هكذا أحسست وأنا أتصفح كتابه لأجد أحد نصوصي معلقاً من قدميه بمروحة سقف مكتبه يريده أن يعترف وفق ما يريد منه أن يعترف،
هذا ما حدث لنصي "مرايا الوهم".
وسأروي لكم كيف حدث ذلك:
كان نصي العاشق المسكين يتسكع حزيناً ومخموراً ويائساً في أحد شوارع بغداد ذات يوم من عام 1985 يبوح بعذابات روحه وقد عاد بعد غياب ليرى المدينة قد تغيرت وحبيبته أنكرت عهدها والمقاهي نسيته. وكان يعتقد أو يتوهم أن النساء سيحفظن عهده وحبيبته ستغسل الشوارع بالدموع وراءه وأن الحمائم ستهجر الحديقة حين ترى مقعده فارغا.. و.. و..
غير أن المحقق وقد قبض على النص لا يقتنع بهذا "الهذر" الرومانسي، فهو لم يعتد هذه المشاعر ولا بد أن يربطها بأمن الدولة و.. و..
ولهذا لابد لنصي أن يعترف.. نعم أن يعترف.. وأن يتكلم بما يريد منه المحقق - الناقد أن يتكلم، ولو تقطعت أطرافه من التعليق أو السياط..!! لا تستغربوا!!!
سأذكر النص "مرايا الوهم" ص19-21 من ديواني" العصافير لا تحب الرصاص – بغداد 1986،
ثم أذكر تحليل صديقي المحقق - الناقد ص10–11 من كتابه " ثقافة العنف في العراق" كولونيا – ألمانيا 2002
وسأترككم تحكمون أو تتفرجون على أغرب وسيلة للاعتراف في تأريخ "مديريات أمن النقد العراقي المعاصر"..
أورد القصيدة هنا كاملةً:
"توهمتُ أنَّ النساءَ سيحفظنَ ودي/ وانَّ المدينةَ - تلك الضياع الكبير -/ ستذكرُ وجهي/ إذا ما تغرّبتُ عن ليلِ حاناتها - ذاتَ يومٍ -/ وأن المقاهي ستسألُ صحبي/ لماذا تأخّرَ/ عن شايهِ والجرائدِ؟/ في أيِّ بارٍ تشظّى…؟/ بأيِّ الزحامِ أضاعَ أمانيهِ والخطواتِ؟/ على أيِّ مصطبةٍ داهمتهُ طيورُ النعاسِ المفاجيءِ/ فأنسلَّ من بين أحلامهِ والجنونِ…/ ونامْ/ توهمتُ أنَّ الجرائدَ – يا للحماقةْ -/ سترثي رحيلي المبكّرَ…/ إنَّ عيونَ التي/ قايضتني الندى، باللظى/ والقصيدةَ، بالبنطلونِ القصيرِ/ ستغسلُ أخطاءَها بالدموعِ، ورائي../ توهمتُ أنَّ الحمامَ الذي كان ينقرُ نافذتي، في الصباحِ/ سيهجرُ أعشاشَهُ، في الحديقةْ/ إذا ما رأى مقعدي فارغاً../ والكتابَ الذي فوق طاولتي/ مطبقاً, صامتاً / والأزاهيرَ كالحةً لا ترفُّ/ توهمتُ…/ يا ليتني ما صحوتُ من الوهمِ, يوماً/ فأبصرُ كلَّ المرايا مكسّرةً/ والمساءاتِ فارغةً، في المدينةِ، حدَّ التوحشِ/ لكنني…/ بعد عشرين عاماً مضينَ (.. وماذا تبقى؟) سأمضي مع الوهمِ…/ حتى النهايةْ..." - آب 1985 بغداد -
والآن لنرى كيف جاء تحليله ونقده؟
يقول:
(لقد أرغمتْ الحرب لطولها وقسوتها، الجميع على تحسس موضع الخطر فيها، فهي كما قال جواد الحطاب لم تكن مجرد نزهة رومانسية وحتى الشعراء الأكثر توفيقاً في المجال المهني كعدنان الصائغ، الذي طالما ذيل كتبه متباهياً بمكانته الأدبية وبما حققه مهنياً خلال فترة وجيزة، وهو دون شك يستحق ذلك، حيث "عمل محرراً ثقافياً في جريدة القادسية وكذلك في الطليعة الأدبية والجمهورية ومجلة الكتاب ومسؤولاً للقسم الثقافي في حراس الوطن ورئيساً لتحرير مجلة أسفار ورئيساً لمنتدى الأدباء الشباب"، كل هذا الزهو المهني لم يجعله بمنجاة من ورطة الوهم، ولم يحجب عن روحه الاحساس بالانكسار "توهمتُ… يا ليتني ما صحوتُ من الوهمِ, يوماً/ فأبصرُ كلَّ المرايا مكسّرةً/ والمساءاتِ فارغةً، في المدينةِ، حدَّ التوحشِ".. بيد أن الصائغ مثل كثيرين من أسرى الداخل لم يكن قادراً على مغادرة هذا الوهم)
يالهي، أي لوي مارسه الناقد عبود لنصي هذا كي يلائم طروحاته. وكيف راح يفسره على هواه مختلقاً له معانٍ وتفسيرات غريبة..
وليت صديقي عبود التفتَ - على الأقل- إلى تأريخ كتابة النص المثبت لديه في الديوان لرآه بأم عينيه "آب 1985 بغداد" وفي ذلك التأريخ كنتُ جندياً مرمياً في سواتر الحرب الجهنمية. لم أعمل حتى مصححاً في أي جريدة بعد!! ولا أملكُ زهواً مهنياً ولا بطيخاً
وما امتلكتُ هذا الزهو وما ادعيته بكل حياتي.
كيف يمكن أن أثق بهكذا تحليل لنص عن الحب والهجر ونسيان المدينة والمرايا والأحبة والحمام للعاشق المخذول بعد أن تنكرت له حبيبته وقايظت قصيدته الملتهبة، ببنطالها القصير.
لقد عدتُ - وكنت وقتها جندياً - من جبهة الحرب، إلى المدينة لأجد كل شيء مخرباً. وأردت أن أعبر عن خلجات روحي فلم أجد أمامي - في زمن الرقابة الحديدية والرصاص - سوى الرمز..
هذه هي القصيدة كاملة وهذه هي دلالاتها. فكيف قلب السيد عبود المعنى؟ كيف توهمه أو حرّفه؟ كيف حلّله؟ كيف ابتكر له تفسيراً عجيباً غريبا؟ً تفسيراً ملتبساً لا أدري كيف تفتق عنه ذهنه حقاً..!؟ إذ يرى النص إنكساراً لوهم "الزهو المهني" الذي حققته الشاعر.
ولو قلب هذا الديوان، ولو قلب دواويني الأخرى كلها بين يديه لرآها انكساراً يجر انكساراً..
أين "بيت القصيد"- كما يقول النقاد العرب القدامى - من تحليلاته وتخيلاته؟ وأين مكان هذه القصيدة من ثقافة العنف..!؟
أكانت رغبة منه أن يظهر كتابه سميكاً بأي تحليل أو حشو كان؟.. أم ماذا؟
كان بأمكانه لو أتعب نفسه قليلاً أن يغرف من نصوص المديح والزهو والعنف لدى بعض الأدباء ما يملأ به مئات المجلدات. فلماذا تركها وأمسك بخناقي؟ ما الغاية من ذلك؟
وموضوعة العنف والحرب والمديح - في العراق - لا تحتاج إلى هذا اللوي والالتواء والحشر والاستنطاق بالقوة للنصوص.
هناك براميل ومخازن وأطنان من نصوص العنف في العراق (انظرْ لمتابعة هيفاء زنكنة لبعض ذلك النتاج أو زهير الجزائري وغيرهم، مثلاً) ولو كلف صديقي الطيب عبود نفسه، لو بذل مجهوداً حقيقياً لو قلب الصحف الرسمية لشهر واحد. شهر واحد فقط. وليس عاماً أو عقداً أو عقدين، لخرج بأربع كتب ضخمة وليس بكتاب..
لكنه بدلاً من ذلك راح يخلط حابل النصوص بوابلها، رديئها بجيدها، ضد الحرب بـ"مع الحرب"، لكي يحكم عليها دفعة واحدة بأنها من ثقافة العنف، فهو حين يختار قصيدتي "موت طلقة" مثلاً من الديوان نفسه:
"أعرف أن الطلقة رعناء حد الموت، أسخر منها وأمد لساني حين تمر بهزء"، الخ..
يعتبرها – فوراً - من أدب تمجيد الحرب دون أن يكلف نفسه تحليل خطابها المستتر. بل ودون النظر حتى إلى عنوان الديوان الذي اقتطف منه تلك القصيدة، وماذا يعني في الأقل؟ ولم يقلّب حتى، أو يتفحص القصائد الـ 31 الأخرى ليرى ماذا في غابة الأفاعي التي كادت أن تلدغني مراراً.
ففي الديوان ( وليعذرني القاريء أن أوردت منه بعض المقاطع المتفرقة، ربما لم ينتبه إليها عبود أو لم يشأ الاشارة أو الاقتراب منها ولا أدري لماذا وهي واضحة في دلالاتها، وكنت قد وضعت دواويني ونصوصي وكتاباتي بين يديه، حين التقينا في شمال السويد أول وصولي لها عام 1997)
أقول ففي هذا الديوان نفسه "العصافير لا تحب الرصاص" أبدأ بقصيدة عنوانها "طلقة":
"يهبطُ الغصنُ.. ثانيةً/ ثم يصعدُ/
والبلبلُ المتأرجحُ منشغلٌ بالغناءْ/ طلقةٌ...!/ جثةٌ...!/ يقفُ الغصنُ، مرتجفاً/ لحظةً/ ثم يسكنُ..../ تصمتُ ـ في الغابِ ـ / كلُّ البلابلْ".
وأنتهي بقصيدة "حكمة مؤقتة":
"في ضجيجِ الطبولْ
لكَ أنْ.. تنتحي، جانباً
وتؤجّلَ ما.... ستقولْ"
وبين مفتتح الديوان وخاتمته تموج عشرات القصائد..
تعال معي لنقلب ما بينهما من نصوص، ففي قصيدة "هواجس لا تعني أحداً":
"يكفيني - في هذا العالمِ – يكفيني/ بيتٌ من طينِ/ بنوافذ / من بحرٍ وشجيراتٍ وارفةٍ/ لا يقفُ الدائنُ في عتبةِ بابي – آخرةَ الشهرِ – ولا…/ تكفيني كسرةُ خبزٍ بمساحةِ قلبي/ وكتابْ…! فلماذا يحتجُّ الناسُ على حلمي، ويكيدُ لي الأصحابْ/ أنا لا أطمحُ في كرشٍ منفوخٍ/ وعماراتٍ/ لا أطمعُ أنْ أتسلقَ أعناقَ الخلاّنِ… إلى طاولةٍ فخمة/ ورباطٍ للعنقْ/ فلماذا تتسلّقُ عنقي المهزولْ/ يا خلي…!/ وتفكّرُ، من أيّةِ منطقةٍ / يصلحُ للشنق"
وأقول في قصيدة "الثلاثون" مثلاً:
"ثلاثين أطفأتَ… يا صاحبي/ وها أنتَ منكفيءٌ فوقَ طاولةٍ آخرَ البارِ/ بين القصيدة,ِ والحزنِ/ ها أنتَ من دونِ بيتٍ/ تكدّسُ كتبَكَ تحتَ السريرِ/ وتحلمُ في بنطلونٍ جديدٍ/ وفجرٍ جديدٍ، بوسعِ مجاعاتِ عمرِكَ.."
وفي قصيدة: "تداعيات رجل حزين في ليلة 9 آب 1983":
"هل تبحثُ مثلي… في خارطةِ الكلماتِ المنسيّةِ عن وجهكَ/ هذا/ المغبرّ… من التجوالِ… وأتربةِ الغربةِ/ أمْ تبقى تحت رذاذِ الحزنِ… وحيداً - كشجيرةِ صفصافٍ يابسةٍ -/ تتسكعُ بحثاً عن امرأةٍ… تؤويكَ/ بمنتصفِ العمرِ/ تقاسمُكَ الرغبةَ في تهذيبِ العالمِ بالكلماتِ/ أو الموت، وحيدَين،…/ على أرصفةِ الأشعارْ/ أيّ بلادٍ تعرفُ حجمَ حنينكَ في هذا القبوِ المظلمِ/ تعرفُ أنَّ الشرطي...../ في ساحاتِ العالمِ/ يبقى أكثرَ ظلاً من كلِّ الأشجارْ"..
"آهٍ.. يا صافيةَ العينين/ لماذا لا تفتحُ بعضُ المدنِ الحجريةِ.../
غاباتٍ للعشاق/ وتفتحُ – كلَّ صباحٍ – زنزاناتٍ أخرى"
"هل يكفي – ما في العالمِ – من أنهار/ كي أغسلَ أحزانَ يتيم/ هل يكفي ما في هذا العصرِ من القهرِ/ لأرثي موتَ الإنسانِ / بعصرِ حقوق الإنسان"
وفي قصيدة " ليست هي مرثية لي":
"غرّبتني الأسِرّةُ.. أو/ غرّبتنا الليالي معاً…/ أفي كلِّ يومٍ، سريرٌ جديدٌ / ومنفى…/ وجوعْ/ أفي كلِّ يومٍ،.. سأوقدُ نفسَ الشموعْ/ وأطفئها بالدموعْ/ شمعةً../ شمعةً/ .... وأنامْ"
وفي قصيدة "أحزان المغني ع":
"قيثارتي روحي.. / شددتُ بها/ أعصابي المتآكلةْ / لاشيء عندي غير موّالٍ حزينٍ/ .. ضيّعتهُ الجلجلهْ / فلمنْ أغني..!؟/ والستائرُ مُسدلهْ/ والشارعُ الملغومُ بالخطواتِ / نامَ على رصيفِ المقصلةْ"
وفي قصيدة "أحزان عمود الكهرباء":
هاكَ عمري، وفلّهِ.. يا صديقي/ لن ترى فيه غيرَ الشجونِ/ وهذا البياضِ الوقورِ الذي يقفُ – الآنَ – بين المكاتبِ، والحلمِ../ لن ترى – بعد هذا العناءِ الطويلِ –سوى قلمٍ ناحلٍ/ يتآكلُ شيئاً، فشيئاً / كنتُ أبصرهُ – في زحامِ المدينةِ –/ مندفعاً في شرودٍ.. / إلى بابِ إحدى الجرائدِ/ أو حاملاً كيسَ صمونهِ، والكتابَ.. / إلى بيتهِ / ما الذي ترتجيهِ من الركضِ/ ها أنتَ قطّعتَ عمرَكَ / بين الوظيفةِ، والشعرِ/ ها أنت وزّعتَ عمرَكَ../ لا…!/ أنتَ وزّعكَ العصرُ/ بين الدوائرِ، والشغلِ،/ بين القصائدِ، والجوعِ…/ …، بين الصحابِ، النساءِ، المقاهي، المخافرِ، أبنائِكَ الخمسةِ، طاولةِ البارِ، قائمةِ الكهرباءِ، الغسيلِ على شرفاتِ الفنادقِ، منتصفِ الفيلمِ، لغطِ الإذاعاتِ، طعمِ الفلافلِ، باصِ الحكومةِ، سبورةِ الدرسِ، صفّارةِ الشرطيِّ، الجرائدِ، لائحةِ اليانصيبِ، الأغاني العقيمةِ، كتْبِ الحضاراتِ، بردِ المصاطبِ، ليلِ العواءِ الطويلِ، أزيزِ المراوحِ في القيظِ، شاي المقاهي، الذبابِ، المطابعِ، بطءِ البريدِ، زعيقِ المراكبِ في الشارعِ المتدافعِ، كذْبِ المحلاتِ جمعيةِ الأدباءِ، دخانِ المصانعِ، بائعةِ الحبِ تعلكُ ضحكتها...، الوردةِ الاصطناعيةِ، الهاتفِ المتقطّعِ، بابِ البنوكِ، المعارضِ,.../ قلْ لي متى تستريحُ إذنْ..؟/ هي أعصابُكَ – الآنَ – مشدودةٌ/ بين أعمدةِ العصرِ/ مكتظةٌ بعواءِ المشاغلِ واللغطِ.../ مَنْ يمنحُ العصبَ المتآكلَ، بعضَ الهدوءِ الجميلِ/ على مقعدِ البحرِ/ مَنْ سوف يتركُ طيراً طليقاً/ يتأرجحُ منفرداً, / فوق أسلاكِ أعمدةِ الكهرباء/ مَنْ يُبدلُ - الآنَ – / هذا الموظفَ ذا الربطةَ الأرجوانيةَ اللونِ بالحلمِ...!/ بالأرجلِ الحافياتِ على ضفّةِ النهرِ.../ بالدفترِ المدرسيِّ الممزّقِ.../ بالـ……/ حلمٌ أنْ تعودَ العصافيرُ, ثانيةً/ بعد موتِ الحدائقِ في الروحِ/ أنْ تفتحَ المدنُ الكونكريتيةُ القلبِ شبّاكَها للقصائدِ/ أنْ تستقيلَ من الحزنِ, يا صاحبي!/ حلمٌ أنْ تغني كما تشتهي/ وتسيرَ كما تشتهي
وتموتَ كما تشتهي…!"
وفي قصيدة "ورقة ساقطة من الطلاسم":
"كيف يا ربُّ... خرجنا من تبوكْ
ووقفنا – كالمساكين – بأبوابِ الملوكْ
كيف بدّلنا الرماحَ السمهرياتِ بأوراقِ الصكوكْ
إنْ تكن تدري... فأني لستُ أدري...!"
وفي قصيدة "حادثة مبكرة جداً":
"في زمانٍ قديمْ/ بينما كنتُ أبحثُ عن دفترٍ أبيضٍ للكتابةْ/ عثرتُ على جثةٍ للقصيدة/ مرمية في الطريقْ...!"
وفي قصيدة "تمرين لكتابة قصيدة":
"في زحمةِ الحرسِ المدجّجِ بالشتائمِ، في الليالي الكالحاتِ بلا بصيصٍ، في أغانيكَ الحزينةِ خلفَ نافذةِ القطارِ، وفي بقايا الزادِ والسفرِ الموحّدِ نحو حاميةِ المدينةِ، في الرشاوى، في المكاتبِ، في الدفاعِ المستميتِ عن القصيدةِ…
في التحمّلِ، في التجمّلِ، في العراءْ
وأنا وأنتَ على الطريقِ:
ظلاّنِ منكسرانِ في الزمنِ الصفيقِ…
إنْ جارَ بي زمني
اتكأتُ على صديقي…"..
والخ.. والخ.. من هذا الديوان، "العصافير لا تحب الرصاص" ورغم اشادة الكثيرين له من شعراء ونقاد، إلا أنني - وهذا رأيي الشخصي - لا أعتبره متميزاً بفنيته وبجرأته قياساً لـ "سماء في خوذة" و "غيمة الصمغ" و"أغنيات على جسر الكوفة" و"مرايا لشعرها الطويل"، وهي منشورة في الداخل.
ولهذه القصيدة التي ذكرتها أخيراً - أي "تمرين لكتابة قصيدة" - ذكرى وحادثة، منفصلان، لن أنساهما ما حييت فقد أهديت هذه القصيدة لشاعر مبدع ونبيل ومرتبك دائماً هو عبد الرزاق الربيعي، من أحب الأصدقاء الشعراء إلى قلبي وأشفهم، وهذا الصديق كانت السلطة قد سُلمتْ لهم - ذات يوم من سنوات الحرب الكالحة – جثة شقيقه عبد الستار الذي لم يتجاوز الثالثة والعشرين عاماً بتهمة الإنتماء لأحد الأحزاب المعارضة، وكانت آثار التعذيب على جسده واضحة ولم يكن هناك اثر للرصاصة بما يؤكد انه استشهد تحت التعذيب، وقد منعوهم من البكاء عليه أو اقامة شعائر العزاء!!.. ورغم ان التهمة لم تثبت عليه لكن عيون رجال الأمن ظلت تتلصص على كل من يزور البيت وقد قطع الكثيرون علاقتهم به خوفاً.
ظل صديقي النبيل في الليالي الموحشات، يجوب أزقة "الدولعي" في بغداد وهو يعوي بصمت جارح..
أما الحادثة فأنني عندما قدمتُ ديواني ذاك "العصافير لا تحب الرصاص" إلى دار الشؤون الثقافية العامة لطبعه، تمت أحالته إلى خبير الدار الذي قرأه ثم أوصى بمنعه وحين اطلعتُ على تقرير الخبير وجدت لديه ملاحظات كثيرة، أذكر منها أنه شطب هذه العبارة من قصيدتي المهداة لصديقي عبد الرزاق:
"في زحمةِ الحرسِ المدجّجِ بالشتائمِ"
مستبدلاً اياها بعبارة من عنده هي:
"في زحمة الدرب المعفر بالأماني"..
كتبتُ طلب اعتراض إلى مــدير عام الدار د. محسن الموسوي،
فأحال الديوان مرة ثانية إلى خبير آخر هو الشاعر يوسف الصائغ الذي كان يشغل وقتها منصب مدير عام دائرة السينما والمسرح، وكانت علاقته مع الدولة في أوج ازدهارها
وقد أعجب بالديوان وأجازه كله بلا حذف.. مع كتابة كلمة على غلافه الأخير.. وصدر الديوان
بعد شهور، وفي صدفة غرائبية، كنا: الخبير نفسه وهو شاعر خمسيني، وأنا في أمسية مشتركة مع آخرين في كركوك. وبعد عودتنا ليلاً إلى الفندق وكانت غرفتنا مشتركة أيضاً، شربتُ كثيراً لأتغلب على خجلي وألمي وارتباكي وفاجأته بلا مقدمات بأسئلتي السريعة المتلاحقة: أسألك فقط يا استاذ "..." لماذا بدلّتْ عبارتي تلك. أي درب؟ وأي معفر بالأماني؟ ها هو الديوان قد صدر فما الذي حدث؟ هل انقلبت الدنيا؟ لماذا الخوف والمزايدات بالرقابة وشهوة الحذف والقمع؟
نظر لي طويلاً بصمت ثم أجابني بحرقة وعمق وحنان أبوي شفيف: نعم! يابني!، لقد تقصدتُ حذف هذا المقطع ومنع الديوان. أنت لا تعرفهم هؤلاء الـ.... انهم لا يرحمون، لقد وجدتك شاعراً شاباً، في مقتبل العمر، ومندفعاً، لا تعرف شيئاً عنهم.. كنت خائفاً عليك حينما رأيتك تكتب بهذه الحدة!! يا بني! أليس لك عائلة؟ أليس لك أم أب أخوة أخوات؟
وسهرت أغرب ليلة! وأنا غير مصدق ما تلفظتُ به أمامه، وغير مصدق ما سمعته منه.
كنتُ أتصور أنني أمام رقيب أو شرطي، وإذا بي أجد نفسي أمام شاعر وانسان رقيق وموظف مسكين وطيب..
أروي هاتين الحادثتين، لما لهما من وجع ودلالات يطول شرحها ليرى صديقي عبود من خلالهما مشهد ثقافة الداخل ومعاناة الكتابة هناك وصعوبة الحكم على أديب من خلال موقف أو نص.
عندما التقاني الصديق سلام عبود مؤخراً في ستوكهولم بعد سنوات
ودعاني مع الصديقين الشاعرين جاسم ولائي وابراهيم عبد الملك، قلت له: ياسلام عبود، نادِ على هذا الجرسون السويدي الواقف أمامك، واسأله، ما معنى "العصافير لا تحب الرصاص"؟
نعم.. كيف يمكن أن أثق بدارس أو ناقد أو محلل أو حتى جرسون لا يعرف ماذا تعني - على الأقل - عبارة العصافير لا تحب الرصاص..
لكن صديقي الكاتب – وليعذرني - ربما لاستعجاله، أو ضعف أدواته النقدية كروائي وقاص وكاتب، أو لاثبات شيء يعتلج في داخله لا علاقة لي به، أنتهى أو التهى بالسطح غير عابيء أو غير ملتفت لما يمور به عمق البحر أو عمق القصيدة أو عمق الجرح أو أعماق الشاعر..
كيف نرى ونقرأ ونتفحص أي نص، إذن؟
وليسمح لي أن أسترسل قليلاً وأجيب:
أن نكون أكثر صدقاً وحباً وسمواً وتفحصاً وتطابقاً مع أنفسنا ومبادئنا وضمائرنا وإبداعنا، بلا ضغائن ولا حسابات، ولا زوايا نظر محددة أو مجتزئة، وأن لا تكون قراءتنا للنصوص مدبرة أو اعتباطية أو مرتجلة أوساذجة أو ناقصة، لكي نرى الآخر وابداعه ومواقفه على حقيقته، وأن يرانا الآخر هكذا بضعفنا وقوتنا، بجرأتنا وخوفنا.
وأجيب أيضاً: ان نقرأ النصوص على أرض الواقع، بلا اجتزاء وبلا مزايدات..
ليعش السادة المزايدون علينا وعلى جراحاتنا هناك مثلما عشنا، ويعملوا ويكتبوا ويرونا بطولاتهم وكتاباتهم..
وكنت أتمنى أن يكون صديقي عبود باحثاً واقعياً ومنصفاً وساعياً إلى الحقيقة في تحليلاته!! وما بيننا إلا الاحترام والمودة..
ولا ضير أبداً وبعد أن طبع كتابه الضخم واستلم حصته من أرباح النقد الفضائحي المجاني السائد في مثل هذه الأيام، لا ضير أن يستمع إلى وجهات النظر، الكثيرة هنا وهناك سلباً أو ايجاباً شمالاً أو جنوباً بلا تشنج ولا امتعاض. مقدماً لنا دليلاً ملموساً عن ابتعاده عن ثقافة العنف التي مارسها جميع أدباء العراق (عداه هو ونصوصه بالطبع) – كما أثبت في كتابه المذكور – من الجواهري والسياب والبياتي وفؤاد التكرلي وسعدي يوسف وحسب الشيخ جعفر وعيسى حسن الياسري ومحمد خضير وابراهيم أحمد وجنان حلاوي وعبد الخالق الركابي وعدنان الصائغ وحميد المختار.. والخ.. والخ، حتى أصغر أديب تسعيني يجلس الآن في مقهى حسن عجمي ينتظر أن يستلم حصته التموينية من العنف الثقافي..
وعودة إلى أسلوب اللوي وقلب الحقائق أو قصها يشير صديقي عبود –في موضع آخر - إلى أن قصائدي في دواويني التالية كغيمة الصمغ أخذت تنتقد أو تدين الحرب.
وهذا اعتراف جميل لا أدري كيف خرج منه.
لكنه يستدرك بسرعة ليطرح تصوراً عجيباً غريباًً لا يقل برودة دم عما سبق فيرى أن إدانة الحرب في قصائدي جاءت بعد أن بدأت السلطة تمهد للسلام وتنتقد الحرب.
إن أي متابع بسيط يدرك أن السلطة لا تزال حتى هذه اللحظة تلعلع بتمجيد "كونات" قادسية صدام وأم المعارك ويوم النصر العظيم ويوم الزحف الكبير.. والخ.. والخ.
ويستمر الصديق عبود في طروحاته الغرائبية مرة أخرى فعلى سبيل المثال لا الحصر
يصف الصديق القاص فيصل عبد الحسن حاجم، حالنا، حال الجنود في سنوات الحرب حيث الموت بالمجان قائلاً:
".. كان الايرانيون يريدون قتلنا من الخطوط المواجهة لنا، وفرق الاعدام خلفنا، وحزب النظام يهدد في المدن التي نسكنها بالانتقام من أهلنا في حالة الفرار.."
وأمام قسوة مشهد دموي سائد كنا نعيشه يومياً، ربما لم يكن صديقي عبود قد سـمع به وهو يتصدى لهذه المهمة الصعبة والمهمة برأي
مهمة الكتابة عن نصوص الحرب ونصوص الداخل.
نسمع عبود ولأول مرة يسترسل بوجع وبشكل مختلف - وجميلٌ جداً أن يسترسل هكذا - فيقول بصوت مخنوق:
"إن من الجنون مطالبة كاتب عراقي يعيش في الداخل بالكتابة عن فرق الإعدام أو فرق التنكيل بالأهالي، ذلك سخف وتفاهة. لكننا لم نرَ في الوقت نفسه ظلالاً ولو باهتاً لتلك الفرق، لم نعثر على بقع مجهرية من الخوف من تلك الفرق مرتسمة على قلوب وملامح أولئك البؤّس المقادين على مدار عقود من الزمن إلى ساحة الحرب والموت، فحتى الموتى كنا نراهم يبتسمون أو يعودون إلى بيوتهم للتلصص على ذويهم الأحياء الذين زغردوا حينما جيء بجثثهم ممزقة.."
لا يا صديقي عبود أقول لك بثقة واصرار هناك العشرات من النصوص المدمّاة، هناك المئات من صور الحزن والغضب الواضحة في نصوص أغلب الذين ذكرتهم والذين لم تذكرهم وهم كثر، لكنك لاتريد أن تراها، وتصر على انها غير موجودة في أدبنا.. وهذا ما يسعى إلى تأكيده الإعلام الرسمي ليل نهار ومنذ أكثر منذ عشرين عاماً عبر وصفه ليل نهار "للروح المعنوية العالية للجندي والكاتب معاً على خط النار، مروجاً لالتحام الجماهير مع القيادة الحكيمة في معارك التحرير"..
وغير هذا الأدب المنشور الذي استطاع مؤلفوه تسريبه كما بينت ذلك، هناك الكثير من النصوص المخبأة، في انتظار فجر الخلاص..
لقد قرأنا في الداخل، الكثير من هذه النصوص المخبوءة وسأذكر قصة لقاص عراقي معروف أتجنب الاشارة إلى أسمه الآن، لأنه مازال يعيش في الداخل. القصة تصور جنود مفرزة الأعدامات وقد صفوا أمامهم مجموعة من الجنود العراقيين الفارين من الجبهة. أحد هؤلاء الجنود الفارين كان ضخم الجثة يصرخ صراخاً مراً وموجعاً يقطع أنياط القلب وعبثاً حاولت لجنة الاعدام ايقافه واسكاته. كان يتقافز هنا وهناك متشبثاً بالحياة بشكل غريب. هذه القصة بالطبع لم يستطع كاتبها رغم تمويهاته الذكية أن يسربها للنشر. وغداً حينما يقيض له أن يهرب وعائلته من البلد كما فعل الذين قبله وينشرها سيجد صديقنا عبود يقول له ببساطة وبرودة دم مثلاً "إنها من نتاج أدب الخارج وليس الداخل"..
وكان من المضحك المبكي أن أقرأ مثل هذا الكلام عن ديواني "نشيد أوروك" الذي استنزفني عمري هناك حينما بدأت كتابته في اسطبل مهجور للحيوانات عام 1984 وتنقل معي في محطات منفاي بعد خروجي من الوطن عام 1993 حتى وصولي بيروت صيف 1996 وطبعه هناك، ليقدم مشهدا بانورامياً عن الوطن والمنفى معاً.
يقول عنه عبود ببساطة شديدة جداً: "بتقديري الشخصي إن نشيد أوروك هو من نتاج الخارج وليس من نتاج الداخل"..
كيف قدر يا ترى أو تصوّر أو أطلع أو رأى أو حلم أو تكهن بذلك!!؟ أي فتاح فال؟ أو عصفور أخبره بذلك؟
والكثير من الأصدقاء والأدباء يعرف تفاصيل كتابة النشيد أو شاهد في بغداد مسرحية الهذيانات بعرضيها: الأول عام 1989 والثاني عام 1993 اللذين أُعدا عنه، وقُدما في أكاديمية الفنون الجميلة ومسرح الرشيد، وفي حوزتي شريط فيديو عن عرضه الثاني. هذا أولا.
وثانياً:عندما قدمت النشيد للطبع عام 1995 رفضت الرقابة الأردنية الموافقة على طبعه، وعندي كتاب رسمي منهم. وأسأل كيف يمكن لأي كاتب أو حتى كاتب عرائض انجاز عمل شعري بهذا الطول والوثائق والاستشهادات والتضمينات خلال عامين (أي من عام خروجي من العراق 93 إلى عام تقديمه في الأردن 95 أو طبعه في بيروت 96). وقد حُشر الديوان حشراً في طبعة بيروت عام 1996 بـ 232 صفحة. والكتاب لو طُبع بشكل طبيعي لكان يربو على 600 صفحة.
ويضيف عبود في موقع آخر من كتابه: (أما عدنان الصائغ فيؤرخ تأليف كتابه نشيد أوروك" بين عام 1984-1996 ومن بين أماكن كتابته: معسكرات وسجون واصطبلات. ويوضح أنه "رمي لمدة عام ونصف في اصطبل" - مجلة الدستورية ع 14 فبراير 1997 - لكنه يعدل من ذلك في مجلة الوطن العربي فيقول: "بعد أن مُنعتْ كتاباتي في العراق على أثر صدور ديواني تحت سماء غريبة في لندن العام 1994 حينما رأت فيه السلطات العراقية تهكماً وتهجماً على شخصية ديكتاتور بلدي، لم استسلم للتهديدات والملاحقات فكتبتُ هذا النشيد رداً على سياسة القمع والارهاب" - مجلة "الوطن العربي ع 1041في 14/2/1997")
وأضيف على ما قلته سابقاً: لو كلف الصديق عبود نفسه وقرأ جيداً - وبلا استعجال - صفحتي المقابلة نفسها، لوجدني أقول فيها قبل هذا الكلام ببضعة أسطر فقط: "لقد كلفني هذا العمل اثني عشر عاماً من عمري"
لو قرأ ذلك لأدرك بنباهة ولانتبه ببساطة إلى الخطأ المطبعي الذي قلب كلمة "نشرتُ" إلى "كتبتُ".
وليس صعبا معرفة هذا الخطأ من قراءة معنى السطر.
مشكلة عبود انه لا يقرأ أو يقرأ وذهنه سارح يريد فقط مسك أي كلمة أو نقطة أو فارزة حتى لو كانت خطأ مطبعياً ليضيفها إلى رصيده في ثقافة القمع.. والأمثلة كثيرة أكثر من أن تعد وتحصى.
بل حتى أن الكثير من السطور العابرة التي يقولها تعليقاً على جملة أو رأي أو تحليل أو اضافة أو ذكر أسم أديب نجده لا هم لديه إلا حشره في مديرة أمن ثقافة العنف تلك، ممارساً عليها ربما عنفاً أشد.
وأخيراً أقول بألم وعتاب شديدين:
إن ما أثار استغرابي، وقرفي معاً، هو حشر سطر من عنده إلى أحد نصوصي حينما أضاف لها متبرعاً هذه الجملة:
(من القائد.. إلى الفاو)
وليس في نصي المذكور، ولا في نصوصي الأخرى ولا في دواويني وكتبي كلها مثل هذا السطر.
وهذا أمر منافٍ للأمانة الثقافية والانسانية.
ولا أدري لماذا فعل ذلك؟
وهي نقطة محيرة لم أجد لها تفسيراً
ترى لماذا كان صديقي عبود مصراً أن يمضي في تسويد مشهد الإبداع العراقي برمته إلى النهاية.
ولأي هدف أو غرض في نفسه، لا يريد أن يجد أو يرى فيه نافذة واحدة مشرقة..
إن خطل هذه النظرة السوداوية وخطورة مثل هذا الطرح يمكن أن تنعكس على كثيرين – مثقفين وقراء - ربما لم يكونوا قد اطلعوا على نتاج الداخل. وقد ذكرت ذلك الأمر في رد لي تحت عنوان "قراءة ناقصة لمشهد ثقافي كامل" (صحيفة المؤتمر ع 296 في 16-22/3/2002) قلتُ فيه: "ومما يؤسف له أن هذا الاستقراء الناقص للاستاذ عبود قد جر استاذاً، وقلما رشيقاً وشيقاً، كالدكتور الأعرجي إلى إطلاق أحكام كانت أشد مضاضة على أدباء الداخل من كل قنابل الحرب التي سقطت على رؤوسهم. وكان الأجدى به وهو الناقد الحصيف - وقد غاب المشهد عنه كما يقول طيلة تلك الأعوام – أن لا يكتفى بكتاب العنف هذا دون أن يقرأ أو يطلع بنفسه أو يسأل – في الأقل - مؤلفه سلام عبود: أهذا هو كل الأدب العراقي!.."
لقد كان الكاتب سلام عبود والدكتور محمد حسين الأعرجي وغيرهما محقون مع أسماء اساءت وشوهت المشهد الثقافي، لكن من جانب آخر – وهذه نقطة خلافي معهم – هناك الكثير من الأسماء الإبداعية في الداخل كانت عكس هؤلاء تماماً، إذ قدمت - خلال العقدين المنصرمين ولا زالت - أدباً راقياً، شكلاً ومضمونا، بعيداً عن ثقافة العنف..
نعم كان صديقي عبود كثير القسوة والتجني مع نصوص وأسـماء وضعها في خانة العنف والسلطة والدم وهي لبست كذلك أبداً: رشدي العامل محمد خضير محمود جنداري حسن مطلك فيصل عبد الحسن وارد بدر السالم عبد الستار ناصر عبد الخالق الركابي أحمد خلف جاسم الرصيف علي السوداني علي الشلاه حميد المختار ابتسام عبد الله حسب الله يحيى خزعل الماجدي زيدان حمود عائد خصباك كزار حنتوش عبد الرحمن مجيد الربيعي عبد الرزاق المطلبي غازي العبادي فؤاد التكرلي فاتح عبد السلام محسن الخفاجي محمد حياوي محمد مزيد محمد شاكر السبع محمود عبد الوهاب مهدي عيسى الصقر مهدي جبر هادي الربيعي وغيرهم. وعشرات من أدباء الداخل وحتى أدباء الخارج وقد ذاقا من الظلم والعنف ما يفوق الوصف.
هناك الكثير ممن فاتني ذكرهم..
وهناك الكثير الكثير:
أسماء ظالمة وأخرى مظلومة وتفاصيل ملتبسة وتحليلات ساذجة وأمور مختلطة. أترك للباحثين والنقاد والأدباء والقراء والزمن وله أيضاً مناقشتها وتصحيحها بضمير ومسؤولية.
"نشيد أوروك" أطول نص شعري عربي، شكل اضاءة هامة في تاريخ الشعر العربي، الراقي، وكان بديهياً ربما أن يتعرض لكل محاولات الطمس والتعتيم وأن تلاقي بسببه كل هذه العذابات، لكن ما الذي أردته من هذا العمل الملحمي وهل تراك وصلت ؟
- "نشيد أوروك" لم أكتبه أنا وأنما كتبه العراق كله، بآلام شعبه وحضاراته وحروبه وحصاراته وأغانيه وشتاته ونخيله وجباله وأنهاره وأمانيه.. . لقد استغرقني العمل فيه 12 عاماً تناولت فيه تأريخ العراق المسكوت عنه منذ فجر الخليقة وحتى انتفاضة آذار 1991 وما بعدها. وقد وصفته صحيفة "الحياة" اللندنية (4 نوفمبر1996) بأنه "شعر يسترجع الماضي ليؤخ للطغيان والمقاومة". وقد منع الديوان في أكثر من بلد عربي منها بلدي بالطبع، لكن من خلال ما وصلني عرفت أنه عبر الأسلاك تهريباً واستنساخاً.
وما كان هذا التشويش والغبار المثار إلا محاولة بائسة لحجب الأنظار عنه.
يقول الأديب المعروف سعيد تقي الدين في عبارته الشهيرة:
"إذا أردت قتل خصمك لا تطلق عليه الرصاص
بل أرمهِ بشائعة".
هل تراهم وصلوا الى مرامهم؟
أم تراني نجحتُ في رسم صورة بلدي الذبيح وحمل صوت شعبي الحبيس والمقموع والمصادر؟
تأبط منفى" ديوانك المعد للطبع، أهو انعكاس لوحشة المنفى أم هو أيضاً إشارة للغد الذي ننتظر؟
- أقتطف هذا لمقطع:
"العراق الذي يبتعدْ
كلما اتسعتْ في المنافي خطاه
والعراق الذي يتئدْ
كلما انفتحتْ نصفُ نافذةٍ..قلتُ : آه
والعراق الذي يرتعدْ
كلما مرَّ ظلٌ
تخيلتُ فوّهةً تترصدني،
أو متاهْ
والعراق الذي نفتقدْ
نصف تاريخه أغانٍ وكحلٌ..
ونصفٌ طغاهْ"
كلمة أخيرة؟
- لقد وضعتني صورة الارهاب الثقافي هنا وهناك، أمام مفارقة مرعبة لما آل إليه وضعنا السياسي والثقافي والأخلاقي،
وشكراً لهذا الحوار الذي فتح لي النافذة على اتساعها لأبين الكثير من تلك الحقائق، وأفضح الكثير من تلك الممارسات والافتراءات التي انطلت للأسف الشديد على بعضهم - لكي يرى القاريء حجم الفاجعة بأم عينيه..
(لقد سردت كل هذه التفاصيل، متمنياً أن تكون المرة الأخيرة، كي لا يستمر الفاشيون والفاشلون، في اشغالي واشغال الوسط الثقافي عن مهمة الكاتب الأجدى والأسمى والأبهى؛ وتلك هي التي تخيفهم حقاً).